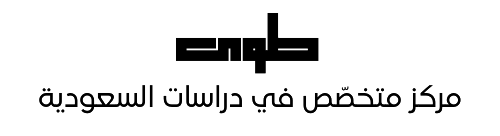مستقبل العلاقات السعودية – الأمريكية في ولاية ترامب الثانية: بين الاستمرارية والتغيير

في 20 يناير 2025، أعيد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. إدارة جديدة تتسلم الحكم بالتزامن مع أحداث مصيرية تعيشها منطقة غرب آسيا، وتحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الإقليم وتوازن القوى الكبرى.
بعيد ساعات من تسلّمه السلطة رسميًا من خلفه جو بايدن، أطلق ترامب سلسلة مواقف أثارت الاهتمام، ولا سيما ما يتعلق بغرب آسيا، والعلاقات الأمريكية السعودية، وملف التطبيع.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى استكشاف ملامح العلاقات السعودية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، مع مقارنتها بفترة ولايته الأولى، وذلك من خلال تحليل أبرز الملفات التي شكلت محور هذه العلاقات، مثل ملف التطبيع مع الاحتلال، وحرب النفط، والملفات الأمنية والدفاعية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية التي أثرت على هذه العلاقات.
كيف ستكون ملامح مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية في عهد ترامب؟ هو السؤال المحوري الذي ستحاول الورقة الحالية الإجابة عنه:
خلال رئاسته الأولى (2017 – 2021)، اتجه ترامب نحو تقليص الانخراط الأمريكي المباشر في قضايا المنطقة، مفضلًا التركيز على التحديات الاقتصادية الداخلية، والصراع على النفوذ مع الصين وروسيا. أما في غرب آسيا، فقد تميزت سياساته بثلاثة محاور رئيسية: الدعم المفتوح واللامحدود للكيان الإسرائيلي، مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والعسكرية مع دول الخليج. ومن أبرز ما نتج عن هذه السياسات:
تجاه الكيان الإسرائيلي: شهدت هذه الفترة إبرام ما سمي باتفاقيات “أبراهام” للتطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، مع تمهيد الطريق لانضمام دول أخرى، مثل السعودية وماليزيا. وعلى الصعيد الفلسطيني، نقلت إدارته السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واعترفت بها عاصمةً للكيان الإسرائيلي، كما شددت الخناق على الفلسطينيين عبر تقليص دعم السلطة ووقف تمويل الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
تجاه إيران: اتخذ ترامب نهجًا تصعيديًا، فانسحب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات صارمة، وصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية. بلغت المواجهة ذروتها باغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، إلى جانب التحريض المستمر ضد النظام.
تجاه دول الخليج: في ظل العداء الخليجي لإيران، استغلت إدارة ترامب هذا التوتر للترويج لمشروع “ناتو الشرق الأوسط”، الذي يهدف إلى مواجهة طهران بائتلاف يضم الكيان الإسرائيلي. إلى جانب ذلك، تبنّى مبدأ “الدفع مقابل الحماية”، حتى بات يُعرف بسياسة “حلب دول الخليج”، و”حلب السعودية”.
قبيل فوزه في 2016، أثارت تصريحات ترامب الهجومية قلق حكّام الخليج، خاصة فيما يتعلق بالنفط وأوبك. لكن بعد وصوله إلى الحكم، انتهج سياسة براغماتية حافظت على التعاون معهم، مع إعادة تشكيل الدور الأمريكي في المنطقة باعتماد استراتيجية تقليل التواجد العسكري المباشر وتوكيل الحلفاء بتنفيذ الأجندات.
لعبت خلفيّته كرجل أعمال دورًا أساسيًا في تعامله مع الخليج، إذ رأى في التحالف معهم صفقةً تجارية مربحة تتماشى مع شعاره “أمريكا أولًا”. وانطلاقًا من هذه العقلية، عمل على تغيير معادلة “النفط مقابل الحماية” إلى سياسة “الدفع لقاء الحماية”، ما عزّز ابتزاز دول الخليج لتحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية.
ملامح العهد الأول
استغل ترامب علاقاته مع السعودية كوسيلة لجني مليارات الدولارات. فيما يلي أبرز ملامح العلاقات السعودية-الأمريكية خلال عهده الأول:
- تمويل حملة ترامب الانتخابية
وصل ترامب إلى سدّة الرئاسة في ذروة تأزم العلاقات بين إيران والسعودية، عقب جريمة إعدام المملكة للشيخ نمر باقر النمر، وما تبعها من إدانات واحتجاجات واسعة، أدت إلى إعلان السعودية قطع العلاقات مع طهران. هذه الخلافات استغلها ترامب لتكون في صميم تقاربه مع الرياض، تحت شعار محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة.
كان من بدايات مجالات التعاون بين ترامب والسعوديين، اللقاء الذي جمع نجل ترامب بمبعوثين عن وليي عهد الإمارات والسعودية في أغسطس 2016، اللذين عرضا المساعدة لدعم حملة والده الانتخابية. ومقابل إضعاف إيران ومحاصرتها اقتصاديًا، فقد دعمت الرياض وأبوظبي حملة ترامب الانتخابية بعشرات الملايين من الدولارات. وهي فضيحة مثّلت صلب تحقيقات المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر حول “التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض وقلب نظام الحكم في إيران“.
- اتفاقيات مشتركة
اختلاط مصالح ترامب بين السياسة والأعمال ساهم في إيجاد أرضية مشتركة لعلاقته الشخصية مع محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية وصاحب رؤية 2030 الاقتصادية. هذا التقارب في الرؤى ساعد على تجاوز العديد من العقبات ونجح في التصدي للأصوات المعارضة.
استغل ترامب منصبه لتوطيد علاقات شخصية مع قادة دول الخليج، واستفاد منها لاحقًا عبر استثمارات في شركاته الخاصة. هذه العلاقات، ظهرت نتائجها خلال ولايته وامتدت إلى ما بعدها، وتمخض عنها مشاريع مشتركة جمعت بين ترامب وأعضاء من فريقه، والسعودية.
يعد جاريد كوشنير، صهر ترامب ومستشاره الخاص في ولايته الأولى، أحد أكبر المستفيدين من هذه العلاقات خلال وجوده ضمن فريق ترامب الاستشاري. التقارب بين ابن سلمان وكوشنير استفاد منه الأخير من خلال تحصيل أموال لشركاته. من بين أبرز هذه التمويلات، ما حصّلته شركة CADRE العقارية من مبلغ يقدّر بحوالي المليون دولار، من مستثمرين سعوديين أخفوا هوياتهم، لتجنب ربط هذه الأموال بالحكومة السعودية مباشرةً. استفاد كوشنر من علاقات شخصية وتجارية مع بعض كبار المسؤولين السعوديين، واستغلها في تأسيس شركته أفينيتي بارتنرز بعد مغادرته البيت الأبيض، والتي يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أبرز المستثمرين فيها، بمبلغ يفوق الـ2.5 مليار دولار. لاحقًا، سيكون لهذه الشركة دور في جذب استثمارات مع شركات سعودية وأفراد مرتبطين بالحكومة السعودية.
وإلى جانب كوشنير، تبرز أسماء أخرى، منها ستيفن شوارزمان، أحد أعضاء فريق ترامب الاستشاري الاقتصادي، الذي نجح في الحصول على استثمار بقيمة 20 مليار دولار لشركة بلاكستون للبنية التحتية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. شوارزمان كان أيضًا من ضمن أعضاء فريق ترامب الذين اجتمعوا بابن سلمان.
ولا يمكن الحديث عن هذه الاستثمارات دون ذكر ستيفن منوتشين، وزير الخزانة السابق في إدارة ترامب والمدير التنفيذي المالي السابق في صحيفة وول ستريت جورنال، والذي التقى كذلك ابن سلمان، ونجح في الحصول على استثمارات بقيمة مليار دولار في شركة ليبرتي إستراتيجيك كابيتال من صندوق الاستثمارات السعودي.
أما حصة الأسد، فكانت لشركات ترامب التي حصلت على عقود خاصة بحكم العلاقات الوثيقة مع ابن سلمان. أبرز هذه الاستثمارات، ما وقعته شركة دار الأركان السعودية مع “منظمة ترامب” لتطوير فلل سكنية، وفندق، وملعب للجولف في سلطنة عمان، وهو مشروع تبلغ قيمته 4 مليارات دولار.
ومن بين ما حصل عليه ترامب خلال ولايته الأولى، شراكة أقامتها منظمته مع سلسلة بطولات LIV غولف المدعومة من صندوق الاستثمارات، والتي بموجبها استضافت ملاعب الجولف التابعة له عدة بطولات للدوري السعودي منذ إطلاقه في عام 2022. التوافق التجاري في مجال “صناعة الرفاهية” كان العامل البارز في هذه الصفقات، وآخرها خطط لتطوير برج ترامب الفاخر في جدة، بالشراكة مع دار الأركان.
وعند الحديث عن هذه العلاقات، لا بد من استحضار حجم الهدايا الفاخرة التي أغدقت على ترامب وتحديدًا خلال زيارته الأولى للمملكة. وهو ما أثار جدلًا استدعى تحقيقًا برلمانيًا أمريكيًا كشفت عن أن ترامب لم يصرح بهذه الهدايا وعددها نحو المئة.
- لوبيات الضغط
ما سبق ذكره، يكشف العقلية التي يتعامل بها ترامب، ومدى خلطه بين عالم السياسة والاقتصاد. عقلية “الصفقة” التي تعامل ترامب بها مع ملفات غرب آسيا، ظهرت نتائجها، إذ رضخت دول النفط، وفي مقدمتها السعودية، وفتحت خزائنها للإدارة الأمريكية. هذا التداخل كانت له نتائج مباشرة على السعودية أيضًا. فكما نجح المال السعودي سابقًا في محو اسم المملكة عن القوائم السوداء، ساهمت الأموال التي دفعها ابن سلمان لترامب في منحه الحصانة عن جرائمه في مجال حقوق الإنسان، وتخليص السعودية من الدعاوى المرفوعة ضدها بتهمة دعم الإرهاب.
تكشف وثيقة أن السعودية، إلى جانب حكومات منها الإمارات وقطر، أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق ترامب بواشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته. من بين هذه النفقات، أكثر من 270 ألف دولار دفعتها السعودية للفندق الذي استضاف عسكريين أمريكيين قدامى ليشهدوا ضد قانون “جاستا”، الذي يسمح بمقاضاة حكومات الدول الحامية أو الممولة للإرهاب في العالم. إلى جانب ذلك، أنفقت المملكة مبالغ كبيرة على جماعات الضغط التي تولت محاولات التأثير على الرأي العام الأمريكي في ملفات مختلفة، من بينها الأزمة الخليجية عام 2017.
- الملفات الداخلية
كان الملف الداخلي في صميم اهتمام الإدارة السعودية، حيث تزامنت فترة ترامب مع ملفات حساسة واجهتها قيادة المملكة، أبرزها أحداث العوامية عام 2017. منحت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر للمضي في هذه الانتهاكات، مكتفيةً بموقف المتفرج، من دون أن تخفي قلقها من خطر تمدد الاحتجاجات الشعبية وتأثير ذلك على الدولة النفطية. أما أبرز الملفات فكانت جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018. استغل ترامب هذا الملف الذي أضر بسمعة ولي العهد السعودي وجعله منبوذًا دوليًا. ورغم نتائج تحقيق وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي أكد أن ابن سلمان هو من أصدر أوامر القتل، فقد منع ترامب مديرة الوكالة جينا هاسبل من تقديم إفادتها أمام مجلس النواب الأمريكي، واكتفت إدارته بفرض عقوبات محدودة على بعض الأفراد المتورطين في الجريمة. الضغوط التي مارسها أعضاء في الكونغرس لفرض عقوبات على السعودية رفضها ترامب، مبررًا ذلك بأنه لن يفسد مئات المليارات من الدولارات من الصفقات مع السعودية بسبب هذا الحادث. هذه الحماية امتدت إلى بحث مسألة منح الحصانة لولي العهد في الدعاوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الأمريكية.
- الملفات الخارجية
أما في الملفات الخارجية المتعلقة بقضايا المنطقة، فلم تختلف طريقة إدارة ترامب لها كثيرًا، إذ اعتمد الابتزاز والتعامل بمنطق صفقات البيع والشراء. فيما يلي نذكر الملفات التي فرضت نفسها على العلاقات السعودية – الأمريكية خلال ولايته الأولى.
1 – حرب النفط:
كانت حرب النفط إحدى أبرز الخلافات التي طغت على العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2020، اندلعت أزمة كان لها تداعيات عالمية على إثر انخفاض الطلب على النفط عقب جائحة كوفيد-19. فشل اجتماع أوبك بلس في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، أشعل حرب نفطية عقب إعلان السعودية زيادة إنتاجها إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميًا ما أدى إلى انهيار أسعار النفط. ألحقت هذه القرارات ضررًا بالمصالح الأمريكية، إذ أثرت على قطاع إنتاج النفط الصخري وهددت العديد من الشركات بالإفلاس. وعلى إثر ذلك، دخل ترامب للدفع نحو اتفاق لخفض الإنتاج، مهددًا السعودية بفرض رسوم على واردات النفط السعودي إذا لم تتراجع الرياض عن زيادة الإنتاج. تسببت حرب النفط في تأزم العلاقات بين الرياض وواشنطن، وبلغت حد الدعوات إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية.
2- صفقات السلاح:
برغم تبجح ترامب بإجبار السعودية على تحمل تكاليف الحماية، وتسويقه لصفقات سلاح مع المملكة، إلا أن العديد من هذه الصفقات لم يكن سوى مذكرات تفاهم أو إعلان نوايا في طور التباحث.
خلال زيارة ترامب الشهيرة للمملكة في مايو 2017، بعدما اختارها كأول وجهة خارجية له، أعلن ترامب أن بلاده عقدت مع المملكة صفقات تتجاوز قيمتها الـ450 مليار دولار، بما في ذلك مبيعات دفاعية إلى السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، واتفاقيات مع كبرى شركات الصناعات العسكرية الأمريكية: لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال دايناميكس. ومع ذلك فإن العديد من هذه الصفقات لم ترى النور أو تبخرت مع نهاية ولايته.
في سبتمبر 2018، في إحدى أشهر تصريحاته حول طبيعة العلاقة القائمة مع السعودية، كشف ترامب، عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالملك سلمان خاطبه فيها قائلا: “أيها الملك، لديك تريليونات الدولارات، ومن دوننا، الله وحده يعلم ماذا سيحدث”. وفي ابتزاز علني، ذكّره بأن “السعودية لن تكون قادرة على الاحتفاظ بطائراتها دون الحماية الأمريكية”.
في فلك هذه التوجهات، قال ترامب في أكتوبر 2019، إن السعودية “تدفع ما عليها” من نفقات إرسال القوات الأمريكية إلى أراضيها. وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن السعودية دفعت نحو خمسمئة مليون دولار لتغطية نفقات القوات الأمريكية الموجودة في المملكة. أما كيف أقنع ترامب السعوديين بدفع هذه النفقات؟ فيقول إن ذلك تم في مفاوضات “استغرقت وقتًا قصيرًا جدًا – ربما، حوالي 35 ثانية”.
تشابك العلاقات والمصالح، انعكس على طبيعة العلاقات بين البلدين. من بين ذلك، تأثير جريمة خاشقجي التي استخدمها ترامب لدفع ابن سلمان إلى الموافقة على العديد من الصفقات. في مايو 2019، أعلنت إدارة ترامب عن نيتها بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن، متجاوزةً بذلك عملية مراجعة الكونغرس التقليدية. وقد شملت حصة السعودية صفقات بيع ذخائر دقيقة التوجيه. أثار القرار جدلاً واسعًا في الكونغرس، إلا أن المساعي ضد هذه الصفقات نقضها ترامب مستخدمًا الفيتو ضد ثلاثة قرارات لوقف صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية.
3- العدوان على اليمن:
وعند الحديث عن العلاقات السعودية – الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى، يبرز ملف العدوان على اليمن كأحد أبرز الملفات بين الطرفين. قدمت الإدارة الأمريكية الدعم الكامل للسعودية في عدوانها وأعطت الضوء الأخضر لتحالفها لارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتسببها بمقتل الآلاف في اليمن، إلا أن ترامب وإدارته واصلا الدعم المفتوح لهذه الحرب مما جعل المملكة أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية في عهد هذه الإدارة.
تصريحات ترامب المتكررة حول الحماية التي تقدمها واشنطن للمملكة، كانت محط اختبار في سبتمبر 2019، عندما تعرضت منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص، اللتين تعدان من أكبر منشآت النفط في العالم، لهجوم من اليمن بالطائرات المسيّرة والصواريخ. كان الهجوم ضربة قاصمة لعصب الاقتصاد السعودي ودرة تاجه، وتسبب في تقليص إنتاج النفط، كما أظهر ضعف الدفاعات السعودية في صد الهجمات رغم المليارات التي دفعت لمنظومات الدفاع الأمريكية. في أعقاب الهجمات، قال ترامب إنه مستعد لدعم السعودية ولكنه أشار إلى أن المملكة يجب أن تتحمل جزءًا من المسؤولية. اكتفت واشنطن بإرسال جنود وبطاريتين لمنظومة صواريخ باتريوت ومنظومة THAAD الحرارية للدفاع الجوي. لاحقًا في منتصف 2021، قامت بسحب الأنظمة الصاروخية الدفاعية والمعدات العسكرية الأخرى بالإضافة إلى الجنود من السعودية، وذلك ضمن حملة إعادة تموضع في غرب آسيا. شكّل هذا الموقف صدمة للسعوديين، وأظهر فشل إمكانية الاعتماد على واشنطن في الحماية. كان لذلك دور بارز في دفع الرياض إلى مراجعة خياراتها فيما يخص تأمين الحماية، والتفكير في تنويع مصادرها الدفاعية وزيادة التعاون العسكري مع دول أخرى.
4- الأزمة السورية:
لكن الابتزاز الأمريكي لم يقف عند هذا الحد. في أبريل 2018، صرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وضعت خطة للخروج من سوريا، ولكن إذا كانت السعودية ترغب في بقاء القوات الأمريكية في المنطقة، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك. في كتابه المثير للجدل، يكشف المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أن ترامب طلب أن تدفع الدول العربية 125% من تكلفة وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق، ثم عاد ورفع النسبة إلى 150%.
ورغم التعثر الاقتصادي في المملكة، واصلت السعودية سياسة “دفع الأموال” وفق أجندات واشنطن. في يوليو 2018، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي ببروكسل تعهد المملكة بتقديم “مساهمة مالية” لدعم “التحالف الدولي” الذي يقاتل تنظيم داعش في سوريا. وفي وقت لاحق من عام 2019، قدمت السعودية 100 مليون دولار كمساهمة مالية “لدعم المناطق التي تحررت من تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا”. هذا الدعم رحبت به واشنطن، ودعت الشركاء والحلفاء إلى “القيام بنصيبهم في هذا الجهد الذي يساعد في جلب قدر أكبر من الاستقرار والأمن إلى المنطقة”، على حد تعبيرها.
5- أزمة حصار قطر:
خلال ولاية ترامب الأولى، شهد البيت الخليجي أزمة استمرت ثلاث سنوات، وكان للدور الأمريكي في الانخراط بها وتأجيجها علامات استفهام.
تربط التحليلات هذا الدور بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، قبل يومين من الأزمة. وتستدل بالتصريحات التي أطلقها ترامب بعد يوم من إعلان القطيعة الخليجية في 5 يونيو، وقوله “من الجيد رؤية أن زيارتي للسعودية و50 دولة تؤتي ثمارها. قالوا إنهم سيتخذون نهجًا صارمًا ضد تمويل الإرهاب وكل الأدلة تشير إلى قطر”. كان واضحًا أن الأمريكيين لم يمانعوا انفجار الأزمة الخليجية، بل على العكس، كانت واشنطن المستفيد الأكبر من خلال تنافس دول الأزمة على كسب ودها سواء عبر الصفقات العسكرية الضخمة أو الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأمريكي. وقد استفادت كذلك من حرب “اللوبيات” التي لجأت إليها كل من قطر ودول الحصار لشن حملات ضغط مكثفة والتأثير على الرأي العام وصناع القرار في الداخل الأمريكي. وكما كانت بداية الأزمة، كذلك كانت نهايتها، مع قمة العلا التي حضرها جاريد كوشنير ليغلق هذا الملف، وإشادة السعودية بمساعي الولايات المتحدة في المصالحة.
6- القضية الفلسطينية:
تصدى ترامب خلال ولايته الأولى لتعزيز مصالح الكيان، وخطى في سبيل ذلك خطوات متقدمة متجاوزًا سياسات أسلافه. اتخذت إدارته قرارات كان لها أثر مباشر على مستقبل القضية الفلسطينية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ووقف تمويل وكالة الأونروا.
هذه القرارات لم تكن خافية على الجانب السعودي، إذ تم ذلك بتنسيق وتواصل معه. وفي هذا السياق، نذكر الضغوط التي مارستها السعودية على الفلسطينيين لتأييد “خطة سلام أمريكية”، سيعلن عنها لاحقًا ترامب تحت اسم “صفقة القرن”. فرغم موقفها الرسمي المندد بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، عملت السعودية خلف الكواليس ضمن استراتيجية أمريكية شملت محادثات عقدها محمد بن سلمان مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تضمنت إغراءات مالية للسلطة مقابل التخلي عن القدس وحق العودة، والتركيز على إقامة دولة في قطاع غزة، وإغلاق ملف القدس واللاجئين، مقابل تدفق الأموال على الفلسطينيين. التعاون السعودي – الأمريكي أشار إليه مسؤولون في الكيان، مؤكدين أن كلًا من السعودية ومصر أعطيتا الضوء الأخضر لقرارات ترامب فيما يخص القضية الفلسطينية.
7- التطبيع مع الكيان الإسرائيلي:
يعد التطبيع أحد الملفات التي ظلت عالقة بين الطرفين خلال ولاية ترامب الأولى. مساعي ترامب لضم السعودية إلى قطار التطبيع لم تكلل بالنجاح، إلا أنه استطاع وضع نواة لمشروع صفقة القرن بالتعاون مع المملكة. وقد قالها ترامب صراحة إن الولايات المتحدة ستحافظ على علاقاتها مع السعودية من أجل الحفاظ على مصالحها وضمان مصالح الكيان الإسرائيلي أيضًا.
وإن تأخر التطبيع العلني، إلا أن التطبيع الخفي كان يشهد تطورًا مستمرًا. كان مشروع نيوم أحد أبرز المشاريع التي روجت لها إدارة ترامب باعتباره جسرًا اقتصاديًا بين السعودية والكيان. جرت لقاءات سرية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين تحت رعاية أمريكية لمناقشة سبل هذا التعاون، وصولًا إلى الاجتماع الذي جمع محمد بن سلمان ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيوم.
كذلك دفعت إدارة ترامب نحو مشاريع اقتصادية تربط بين السعودية والكيان، من بينها شبكة السكك الحديدية بين الخليج والكيان عبر الأردن، إضافة إلى مشروع كابل الألياف الضوئية الذي يمتد من تل أبيب إلى دول خليجية، ليكون جزءًا من مسار تجاري استراتيجي يربط الهند بأوروبا مرورًا بالأراضي المحتلة. أما أبرز الإنجازات، فكان فتح السعودية مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.
لم يقتصر التطبيع على الجوانب الاقتصادية، بل امتد إلى مجال التعاون الأمني، حيث شجعت الولايات المتحدة الرياض على الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك التفاوض على شراء أنظمة دفاع متقدمة مثل القبة الحديدية. وقد استخدمت السعودية برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على معارضيها مستفيدة من تفوّق الكيان في هذا المجال.
ملامح العهد الثاني
- تعيينات تثير الجدل:
في ذروة التصعيد في المنطقة، انتخب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية. مدفوعًا بالتطورات في غرب آسيا، أجرى ترامب تعيينات جديدة في حكومته، أثارت الجدل لجهة الشخصيات التي اختارها وموقفها من الأحداث الحاصلة.
على أن تعيينات ترامب عكست في جوهرها اهتمامه بمواصلة تعزيز التعاون مع الرياض، وبالأخص في ملف التطبيع. وفي هذا السياق، كان قرار تعيين رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مسعد بولس مستشارًا أول للشؤون العربية والشرق الأوسط، ليتولى تعزيز التقارب مع الدول العربية، بينما أسندت إلى ستيفن ويتكوف مهمة دفع اتفاقيات التطبيع قدمًا. غير أن تعيينات ترامب جلبت شخصيات متباينة في الأجندات، فقد اختير مايك هاكابي سفيرًا لواشنطن في تل أبيب، رغم مواقفه المؤيدة لضم الضفة الغربية، وهو ما سيكون له انعكاساته على مفاوضات التطبيع.
كما ارتبطت التعيينات بالمصالح الاقتصادية التي يوليها ترامب أهمية، إذ أعادت إلى الواجهة مستشارين ومسؤولين ماليين سبق لهم العمل على مشاريع مع السعودية. فإلى جانب كوشنير الذي تلقى صندوقه Partners استثمارات بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السعودي منذ مغادرته البيت الأبيض، تم تعيين كل من دينا باول ماكورميك وكين مويلس اللذين شاركا في تحضير الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو. وكذلك ستيفن منوشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في إدارة ترامب وتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع السعودية مكنته من جذب استثمارات ضخمة إلى شركته بعد مغادرته المنصب. ومن اللافت أن الشخصيات المختارة من قبل ترامب لها باع طويل في دعم كيان الاحتلال ومشاريع التطبيع معه. من بين الأسماء، بريت ماكغورك، وهو مستشار سابق لشؤون غرب آسيا في إدارة بايدن. ماكغورك الذي يعمل حاليًا كشريك استثماري في شركة لوكس كابيتال المتخصصة في الاستثمار بالتقنيات الناشئة، من أبرز المؤيدين لاتفاقية التطبيع مع الكيان. وكذلك شريكه المؤسس صاحب العقيدة الصهيونية جوش وولف. وقد انتشرت صور للقاء الاثنين بابن سلمان، بعد يوم من لقاء جمعهما بطحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.
- الدفع مقابل الحماية:
في سياق التحركات الدبلوماسية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه زيارة السعودية خلال الشهرين المقبلين، دون تحديد موعد دقيق للزيارة. وليست هذه المرة الأولى التي يلمّح فيها ترامب إلى إمكانية زيارة المملكة، إذ سبق أن أشار إلى احتمال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك، مؤكدًا أن اللقاء قد يتم “في وقت ليس ببعيد”. يأتي ذلك في سياق مساعيه الحثيثة لتعزيز موقع بلاده في غرب آسيا معتمدًا على وكلائه، خاصة في ملفات التطبيع والصفقات الاقتصادية والعسكرية.
ما بين ولايته الأولى والثانية، لم يختلف نهج ترامب في مقاربة العلاقات مع دول الخليج، وتحديدًا السعودية. فالمال هو الذي يتحدث هنا، إذ يجد ساكن البيت الأبيض أن لغة رجال الأعمال هي الطريقة الأنجع. وفي يومه الأول في البيت الأبيض، وبينما كان ترامب جالسًا في المكتب البيضاوي يوقع على 100 أمر تنفيذي، كانت السعودية حاضرة في أسئلة الصحافيين الذين أبدوا اهتمامًا في طرح ملف العلاقات مع المملكة لكونه من بين الملفات الخارجية التي حظيت بضجة إعلامية خلال ولايته الأولى. وعندما سُئل عن رحلته الشهيرة إلى السعودية كأول وجهة خارجية له وإمكانية اختيارها مجددًا، أجاب ترامب بأن ذلك تمّ لأن الحكومة السعودية وافقت “على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا، مضيفًا أنه “سيذهب إلى هناك مرة أخرى إذا وافقت المملكة على شراء المزيد”.
جاء الرد السعودي على هذه التصريحات في اتصال هاتفي بين ترامب وابن سلمان، إذ أعلن الأخير عن “رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، مرشّحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية”. لكن العرض السعودي لم يرضِ ترامب، رغم أن المبلغ بما يحمله، يعادل ثلثي إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. إذ صرح بعد يوم واحد من الاتصال قائلا إنه سيطلب من السعوديين أن يرفعوا مبلغ الـ600 مليار دولار الذي وعدوا به ليصبح تريليون دولار مقابل زيارته للمملكة. جاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، في تصريحات جاءت أشبه بمزاد علني.
وفي 6 مارس 2025، صرح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بأنه طلب من السعودية استثمار تريليون دولار في شركات بلاده على مدى 4 سنوات، وأن المملكة وافقت على هذا العرض. وبناءً عليه، أعلن أنه سيزور السعودية هذا الربيع. مشيرًا إلى أن علاقته بالسعوديين ممتازة، و”أنهم سينفقون الكثير من الأموال على الشركات الأميركية”.
هذه التصريحات، عكست مفهوم أطر العلاقات بين السعودي والأمريكي، فالاقتصاد هو المتحكم الأول، وله كلمة الفصل. ولعل هذا ما كان يتحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة تأكيده، عندما عدد الفوائد التي ستجنيها المملكة من التطبيع، سواء في مجالات الاستثمارات أم التكنولوجيا الفائقة أم الأمن.
يحرص ابن سلمان على توسيع هامش الشراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ترامب الحالية، إلى جانب مواصلة الاعتماد عليها في شراء الأسلحة، إذ تشمل محفظة الأعمال السعودية توسيع نطاق الاستثمارات إلى مجالي الرياضة والتكنولوجيا. وهذا ما ينعكس في قوله لترامب إنه يؤمن بقدرة الأخير “على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق” وهو تسعى المملكة للاستفادة منه.
فكيف يتم ترجمة هذه التصريحات؟ الجواب في مشاريع الاستثمار وفرصها المتاحة. على صعيد الاستثمار السعودي في الشركات الأمريكية، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة أكثر من 750 مليار دولار، مع إعلان المملكة استعدادها لزيادة هذه الاستثمارات من القطاعين العام والخاص بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وقد صرح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للاستثمارات السعودية. وهو ما أكده كوش تشوكسي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بقوله إن السعودية أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للشركات الأمريكية.
هذا وتظهر السعودية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع أمريكا، خاصة في المجالات التكنولوجية والحساسة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الشأن، تسعى السعودية لتعزيز علاقاتها مع شخصيات فاعلة في هذا القطاع، منهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع ترامب الذي أوكل إليه الإشراف على هيئة الكفاءة الحكومية في إدارته. أما من الجانب السعودي، فيتولى صندوق الاستثمارات هذه الجهود بشكل واضح، حيث ظهر رئيسه ياسر الرميان، في صورة مع ترامب وماسك بعد أيام من الانتخابات الأمريكية.
وفي إطار استثماراتٍ غير معلنة، دعم صندوق الاستثمارات شركة xAI التابعة لماسك، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يمتلك الصندوق حصصًا في شركات أخرى مرتبطة بماسك، مثل شركة المملكة القابضة، التي تدعم بشكل كبير مشاريعه، بما في ذلك منصة إكس.
وفي سياق متواز، تكتسب الصفقات الخاصة بين ترامب والسعودية أهميتها. من بين أحدث هذه الاستثمارات، إطلاق مؤسسة ترامب مشروع بناء برج في العاصمة السعودية بقيمة 530 مليون دولار، في إطار توسعها في القطاع العقاري بالمنطقة. ووفقًا لإريك، نجل ترامب، فإن المؤسسة تخطط لبناء “برج ترامب” في الرياض، إلى جانب مشروع مماثل في مدينة جدة الساحلية.
وكذلك وافقت دار جلوبال، الذراع العالمية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، على عدد من الصفقات مع مؤسسة ترامب تشمل خططًا لبناء برجين يحملان اسم ترامب في جدة ودبي إلى جانب مشروع عُمان. وذكر زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال، أن المشروع المقرر تنفيذه في الرياض هو مجمع للغولف يحمل اسم ترامب، ومشابه للذي أطلق في عمان عام 2022.
مؤخرًا، في قمة “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي نظمها صندوق الاستثمارات، وأقيمت في ميامي في فبراير 2025، سلط ترامب الضوء على دور السعودية “في دفع المبادرات الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي”، معتبرًا أن التعاون السعودي الأمريكي يساهم في “استعادة العصر الذهبي” لأمريكا بحسب تعبيره، ويعزز فرص تحقيق الثروة عبر مشاريع ضخمة. من وراء هذه التصريحات، كان موقف ترامب يعكس سعيه المستمر لتعزيز دوره كرجل أعمال يركز على تحقيق المكاسب المالية، وهو توجه يتماشى مع رغبة السعودية في تجنب أي عراقيل لرؤيتها الاقتصادية.
- ملف النفط:
يتوقع أن يكون لهذا الملف حصة الأسد، لما له من تداعيات على الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، جدد ترامب تصريحاته بعد تعيينه رئيسًا لولاية ثانية، مطالبًا دول أوبك + بخفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج. هذا المطلب الذي تسبب في توتر في العلاقات الأمريكية – السعودية سابقًا، يتوقع أن يكون ملف ضغطٍ جديد ستمارسه إدارة ترامب على المملكة. وفي هذا الشأن، قال ترامب إنه سيطلب من السعودية وأوبك خفض أسعار النفط، معتبرًا أن عدم القيام بذلك قبل الانتخابات لم يكن دليل مودة، زاعمًا أنه “لو كان السعر أكثر انخفاضًا، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فورًا”، باعتبار أن ذلك سيحرم موسكو من إيرادات التصدير. وبالتالي فإنه بعد أعوام من سريان اتفاقية خفض الإنتاج النفطي، في مسعى للحفاظ على توازن سوق النفط العالمي، من المتوقع أن يضغط ترامب على السعودية ودول أخرى لخفض الإنتاج. إلا أن أوبك تقول إن لديها خططًا لزيادة الإنتاج في أبريل 2025 بعد أن أرجأت الزيادة بسبب ضعف الطلب، فهل سيتم الرضوخ للطلب أم أن الرفض سيتسبب في انشقاقات داخل أوبك؟
مما لا شك فيه أن قطاع الطاقة سيأخذ نصيبه من محور المباحثات مع دول الخليج. فإلى جانب سياسات الإنتاج والتسعير، تحمل رؤية ترامب وفريقه الجديد موقفًا متذبذبًا تجاه تغير المناخ، إذ يرون أن الوقود الأحفوري سيظل جزءًا رئيسًا من مزيج الطاقة في الأمد البعيد. ورغم أن هذا يتعارض مع الترويج الخليجي للتوجه نحو الطاقة المتجددة، إلا أن بعض الباحثين في مراكز سياسة الطاقة العالمية يرون أن توجهات ترامب قد تكون محل ترحيب لدى كبار منتجي النفط الخليجيين، نظرًا لما توفره من دعم لاستمرار الطلب وارتفاع العائدات.
- ترامب والسعودية، حسابات متغيرة:
مثّلت هجمات بقيق وخريص اليمنية عام 2019، علامة فارقة في مفهوم الحماية لدى السعودية، إذ شكّلت بداية التحول في سياساتها الخارجية بعيدًا عن “تصعيد الأزمات” إلى “تصفيرها”، معتمدة مقاربة متوازنة مع جميع الأطراف. التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة لعبت دورها في هذا التغيير، وتبلور مفهوم سياسة “عدم الانحياز” لدى السعوديين، وهي رؤية جديدة تتطلع لتحقيق توازن في العلاقات الدولية والبقاء على مسافة واحدة عوضًا عن الانخراط في الصراعات. بناءً على هذا التوجه، شهدنا تحوّل المملكة إلى ما يشبه “قاعة المؤتمرات” لاستضافة مؤتمرات دولية، وقد برز دورها في التوسط في ملفات عدة، أبرزها الأزمة الروسية – الأوكرانية. جاء هذا الدور ضمن نهج تخطوه السعودية يهدف إلى أن تكون لاعبًا ليس فقط إقليميًا، بل دوليًا أيضًا. وقد سخّرت لهذا الهدف ما تتميز به، وهو سلطة المال.
يعود ترامب إلى السلطة وفي جعبته ملفات آنية يعمل عليها، مسارعته لإنهاء الحرب على لبنان وغزة، سعيه لوقف الحرب الأوكرانية – الروسية، وإطلاقه سهامًا نارية تجاه دول عدة من بينها المكسيك وكندا وإيران. يريد الرئيس الجديد أن يغلق هذه الملفات ليتفرغ لما يراه الملف الأهم، وهو الصين.
أما بالنسبة للسعودية، فإن الحسابات لم تعد نفسها التي كانت خلال ولايته الأولى. فلم تعد الرياض تكتفي بدور الحليف الخاضع، بل باتت تحاول رسم ملامح نهج استراتيجي أكثر استقلالية، مدفوعة بتراجع الثقة بالولايات المتحدة وتغيّر أولوياتها الاقتصادية. فمع انحسار النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، أعادت السعودية تشكيل تحالفاتها، موثّقة علاقاتها مع روسيا لضمان استقرار أسعار النفط، ومعززة شراكتها مع الصين، كمشترٍ رئيسٍ للنفط، ومصدّر للتكنولوجيا المتقدمة. ورغم ذلك، فإن القيادة السعودية تدرك أن هامش المناورة ضيّق، وأن أمنها لا يزال مرهونًا بحماية واشنطن، وهو ما يدفعها إلى تقديم تنازلات لها في ملفات الدفاع والتكنولوجيا النووية.
يعود ترامب إلى البيت الأبيض ويريد من السعودية أن تحجّم علاقاتها بالصين وروسيا، وهو ما ترى السعودية نفسها مستعدة لفعله في مقابل الحصول على اتفاقية دفاعية وأسلحة متطورة والتكنولوجيا النووية، أي ما يعرف ببنود صفقة التطبيع مع الكيان. لكن مخاوف الرياض تتعلق أيضًا بملف العلاقات مع إيران، والمصالحة التي أبرمتها مع طهران برعاية بكين في فترة غياب ترامب عن السلطة. خلال ولايته الأولى، كان ابن سلمان من أبرز المؤيدين لترامب، متحمسًا لنهجه الصارم تجاه إيران، ولكن مع تضاؤل ثقة الرياض في التزام واشنطن بحماية حلفائها، بدأت السعودية في إعادة ضبط استراتيجيتها، متجهة نحو التهدئة مع طهران. وعليه، لا تريد الرياض عودة التوتر مع إيران، إذ تعلم جيدًا أن علاقات حسنة مع إيران تعني أمنًا أكبر لها في الداخل والمحيط الإقليمي. فالجار اليمني بات لاعبًا على المستوى الدولي بقدرات بات تؤمن الرياض أنها عاجزة عن كسرها. وقد اختبرت المملكة حسنات المصالحة مع إيران خلال حرب طوفان الأقصى، إذ نجحت في التحصّن من فتيل حرب تمتد إلى دول الخليج. لكن السعوديون يدركون أن ترامب لا يقبل الرفض، وأن العودة إلى منطق “معي أو ضدي” قد تضعهم أمام خيار خطير لا يحتمل المساومة. فما هامش المناورة الذي ستكون واشنطن مستعدة للقبول به؟ ولقاء أي ثمن؟ وهل ستنجح الرياض في فرض نفسها كلاعب مستقل لا يُختزل كأداة في لعبة الكبار؟
لا شك في أن الرسالة تعيها واشنطن جيدًا، ولهذا قبلت إعطاء الرياض “صورة” اللاعب الدولي، عندما قبلت أن تكون المباحثات مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية في الرياض.
لكن الأجوبة الحقيقية عن هذه الأسئلة تظهر في تطورات الشرق الأوسط، من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا. إذ يواصل ترامب سياسته في تخفيض الوجود الأمريكي المباشر في ساحات الشرق الأوسط لصالح وكلائه. وهنا للسعودية دور بارز. في الملف اللبناني، وبعد سنوات من تراجع الدور السعودي في الساحة اللبنانية، شهدنا استدارة نحو لبنان مجددًا، ووصلت الأمور إلى حد التدخل في مفاصل اختيار رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة. يأتي هذا عقب اتفاق وقف لإطلاق النار تم “بوساطة” أمريكية، لتتسلم الرياض تنفيذ الأجندة الأمريكية: وضع لبنان تحت الوصاية، واستكمال ما فشلت الحرب العسكرية في إتمامه وهو القضاء على المقاومة، والدفع بالبلاد نحو التطبيع. أما المقابل، فوعود بالمال السعودي تحت مسميات إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
وفي سوريا، وبعدما نجح الانقلاب التركي بدعم أمريكي، تسلمت دول الخليج وتحديدًا السعودية زمام المبادرة. فشهدنا زيارات مكوكية بين القيادة السورية الجديدة والسعودية، والوعود التي أطلقت لدعم الحكم الجديد.
وتبقى القضية الفلسطينية الملف الأصعب، نظرًا لحساسية هذا الملف، وارتباطه بمصالح الرياض مباشرة، من بوابة صفقة التطبيع مع الاحتلال.
- ترامب والتطبيع السعودي:
لا تزال التصريحات تراوح مكانها فيما يخص صفقة التطبيع، وقد فرضت التطورات في الساحة الفلسطينية نفسها على الصفقة، فنجحت في عرقلتها بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من خواتيمها. تصريحات أمريكية تؤكد السعي لإتمام الصفقة، خصوصًا في ولاية ترامب، وتحمّل إدارة بايدن مسؤولية تأخير إنجازها، مقابل تصعيد سعودي بعد طوفان الأقصى، يضع القضية الفلسطينية في صدارة شروط الصفقة. وما بين الموقفين، تعنت إسرائيلي في التنازل عن أي “إنجاز” يُمنح للفلسطينيين.
على أن دونالد ترامب لا يزال مقتنعًا بأن التطبيع قادم لا محالة عاجلًا أم آجلًا، وبأن واشنطن لا تحتاج الضغط على السعودية للقبول به، إذ سينتهي بها الأمر في نهاية المطاف إلى ركب المطبعين، هذه القناعة عبّر عنها ترامب بقوله: “أعتقد أن المملكة العربية السعودية سينتهي بها الحال إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، قريبًا، وليس بعد فترة طويلة جدًا”. تصبّ هذه المواقف في إطار توجهات الإدارة الأمريكية، وقد عبّر عنها مسؤولون أمريكيون من بينهم مايك والتز، مستشار الأمن القومي، بالتأكيد على أن تحقيق اتفاق التطبيع “أولوية قصوى” لدى الإدارة المقبلة.
وتتقاطع هذه التصريحات كذلك مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، الذي قال خلال تهنئته لترامب، إن العمل سيتواصل لإدخال “عصر جديد من السلام والازدهار لمنطقتنا”. لكن المفارقة تكمن في رفع السعودية لسقف شروطها للقبول بالتطبيع، من دون نفي إمكانية حدوثه، من خلال تأكيدها على لسان ولي عهدها بأن “المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
إذًا تتقاطع مصالح الأطراف الثلاثة في إبرام التطبيع، لكن الخلاف على التفاصيل. قبل طوفان الأقصى الذي أطاح بصفقة التطبيع، كانت المحادثات قد وصلت إلى خواتيمها من دون الكشف عن تفاصيلها، مع تواصل المفاوضات بشأن المطالب السعودية التي كانت مرفوضة ليس فقط إسرائيليًا، بل وأمريكيًا كذلك، وبنودها:
1- اتفاق تحالف مع الرياض يتضمن التزامًا بالدفاع عن السعودية يشبه ما تنص عليه “المادة 5” من معاهدة حلف الناتو.
2- تحصيل صفقات أسلحة نوعية.
3- اتفاقية تعاون في المجال النووي تشرّع عملية التخصيب المحلي في السعودية.
وبعد الطوفان وانفجار غضب الشارع العالمي لهول المجازر الإسرائيلية، وتأثر الشارع السعودي الذي يرفض بأغلبيته التطبيع مع الكيان، بات إبرام الاتفاق مستحيلًا من دون تحقيق شروط متعلقة بالقضية الفلسطينية. وضمن هذه التحولات، تخلت السعودية عن مساعيها لإبرام معاهدة دفاعية في مقابل اتفاق محدود للتعاون العسكري، مشترطة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما رفضته تل أبيب.
ما سبق من تصريحات، اصطدم بالمقاربة الأمريكية – الإسرائيلية التي حاولت إحراج الرياض في هذا الملف، بعدما أطلقت الأخيرة مواقف اعتبرت “تصعيدية” من خلال التأكيد ألا تطبيع قبل إقامة دولة فلسطينية. وقد أعادت قيادة المملكة تجديد هذا الشرط في أكثر من محفل، من بينها موقف محمد بن سلمان خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، والذي دعا إلى مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حاثًا مزيدًا من الدول للاعتراف بدولة فلسطين. وأتبعه لاحقًا بتصريح مشابه خلال خطاب له أمام مجلس الشورى السعودي في 18 سبتمبر 2024، قائلًا إن “المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.
على أن هذه المواقف ليست نابعة عن قناعة من ابن سلمان اللاهث خلف التطبيع لتحصيل آثاره الاقتصادية، إنما يجد الرجل نفسه مجبرًا على رفع السقف بفعل غليان الغضب الشعبي، وهو ما لم يترك خيارات أمامه سوى الترويج لتمسك المملكة بالقضية الفلسطينية.
في 28 يناير 2025، أرسل دونالد ترامب مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ليكون أول مسؤول أمريكي رفيع يزور المملكة في عهد الإدارة الجديدة. زيارة مليئة بالرسائل والدلالات، أبرزها اهتمام ترامب بصفقة التطبيع. ويتكوف الذي ورث هذا المنصب عن كوشنير الذي سبق وشغله في عهد الإدارة الأولى، عيّن بعد أسبوع واحد فقط من انتخاب ترامب، رغم كونه مبتدئاً في عالم الدبلوماسية. لكن العلاقات الشخصية التي تجمعه بترامب جعلته من فريقه المقرب، فضلًا عن موقفه المدافع عن مشروع تهجير الفلسطينيين. وقد تناولت المباحثات مفاوضات صفقة التطبيع، وجاءت بعد أيام من تعبير ويتكوف عن تفاؤله بأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة يمكن أن يمثل “خطوة أولى” نحو تعزيز التطبيع مع “إسرائيل”، وهي عملية يزعم أن جميع دول المنطقة قد تنخرط بها، كونها تمثل بداية نهاية الحروب، مما يجعل المنطقة بأكملها قابلة للاستثمار”، بحسب تعبيره، وفي هذه الجزئية من كلامه ما يهم ابن سلمان تحديدًا.
اليوم تغيب مفاوضات التطبيع عن أروقة التداول، برغم أن التسريبات أشارت إلى أن التطبيع قد يكون ثمنًا لوقف العدوان على غزة، وبذلك تقدّمه المملكة “إنجازًا” للفلسطينيين. لكن هذه المفاوضات تبخرت حاليًا، وسط تكهنات حول مصير الصفقة وإمكانية إبرامها في المستقبل القريب.
ترامب الذي لم يوفر مناسبة إلا وتطرق فيها إلى مشروع “تطهير” غزة ونقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن منذ توليه منصبه، تحدث قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عن تقدم في المحادثات حول الشرق الأوسط مع “إسرائيل” ودول أخرى. تصريحاته جاءت بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن في 4 فبراير 2025، والتي قال خلالها إن “السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية مقابل اتفاق سلام مع إسرائيل”. في اليوم التالي، ردت الخارجية السعودية في بيان جددت خلاله رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
فما الذي دار بين ترامب ونتنياهو خلال اللقاء؟ يجيب عن ذلك نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز، قائلًا إنه ناقش مع ترامب حين التقاه في واشنطن مسألة منع طهران من الحصول على السلاح النووي، موضحًا أنه “عندما نتأكد من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، وعندما ندمر حماس فإن هذه الأمور ستمهد الطريق لاتفاق مع السعوديين ومع الآخرين”. تصعيد يقابل بالتصعيد إذًا، ورسائل متبادلة عنوانها سعوديًا “أريد ما أبرر به التطبيع” وردها أمريكيًا – إسرائيليًا أن مشروع التهجير ماضٍ ولا إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
ولعل أبلغ من يعبّر عن حجم المأزق الذي وقعت به السعودية سفيرها الأسبق في واشنطن تركي الفيصل، الذي اعتبر أن ما خرج به ترامب “غير قابل للاستيعاب”، وأن التطبيع بعد خطة ترامب قد لا يحدث “إطلاقًا”. على أن المفارقة تكمن في أن رئيس الاستخبارات العامة السعودية كان نفسه من كتب رسالة إلى ترامب يقول فيها: “أعتقد أن الله أنقذ حياتك للعمل مع أصدقائك في المملكة العربية السعودية والأصدقاء الآخرين الذين لديك في المنطقة، لمتابعة ما بدأته من قبل: إحلال السلام، بالأحرف الكبيرة، في الشرق الأوسط”.
- مصير القضية الفلسطينية:
أعادت معركة طوفان الأقصى القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأفشلت مشروع التطبيع السعودي مجبرة قيادة المملكة على إقحام بند القضية الفلسطينية بقوة إلى بنود شروطها للقبول بالصفقة. وضعت الحرب، السعوديةَ أمام واقع صعب مع خيارات معدومة تحتّم عليها الانحناء في وجه العاصفة ريثما تنجلي. ولهذا فقد برز في المطالب السعودية “شرط إقامة دولة فلسطينية”، وهي “نغمة قديمة” لطالما عزفتها المملكة لتروج أنها حاملة قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها فلسطين.
لكن الجانب الأمريكي – الإسرائيلي، يفهم حرج المملكة ويستغلّه، ولهذا فقد رفع الجانبان منسوب تصريحاتهما التي لم تخل من تهكم على الوضع الذي باتت فيه السعودية.
فخلال لقائه مع نتنياهو في 4 فبراير 2025، صرح ترامب بمقترح أثار جدلًا واسعًا، إذ اقترح أن تتولى الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة وتحويله إلى وجهة سياحية سماها “ريفيرا الشرق الأوسط” على غرار منطقة الريفيرا الفرنسية السياحية المزدهرة. وهو طرح يشمل إخلاء القطاع من سكانه وإعادة توطينهم في أماكن أخرى، بحجة أن ذلك سيوفر لهم “بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا”. بعدها بأيام، في 9 فبراير، كرر ترامب كلامه عن “امتلاك قطاع غزة”، قائلاً إنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء منها لدول أخرى بالشرق الأوسط لبنائها”. تصريحات ترامب الأقرب إلى رؤية خيالية منها إلى طرح واقعي من رئيس دولة، قالها على متن طائرته الخاصة بينما كان متوجهًا لحضور مباراة كرة قدم أمريكية. وعن هذه الرؤية أضاف أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيحرص أن لا يقتل الفلسطينيون. أما عن مصير هؤلاء فلفت إلى أن دولًا بالشرق الأوسط ستستقبلهم بعد أن تتحدث إليه تلك الدول، قبل أن يعلن عن لقاءات ستجمعه مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري.
وإن كانت مقترحات ترامب بهذه الغرابة، فإن مقترحات نتنياهو ليست أقل غرابة منها. إذ رد الأخير على الموقف السعودي بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل الحديث عن التطبيع، باقتراح أن يستضيف السعوديون الفلسطينيين وينشؤوا لهم دولة على أرضهم. هذا الطرح لم يأت من فراغ، بل هو توجه يتبناه قادة الاحتلال، ومنهم الوزير إيلي كوهين الذي غرد في السرب نفسه قائلًا إنه “إذا أرادت إحدى الدول العربية تخصيص أراضٍ داخل حدودها لإقامة دولة فلسطينية، فلن نعترض على ذلك”. أما الموقف الأكثر وضوحًا، فكان تصريحه بأنه إذا كان عليه الاختيار بين إقامة دولة فلسطينية والسلام مع السعودية، فسيتخلى عن السلام مع الأخيرة.
وإن كان الرد السعودي على التصريحات السابقة بتكرار “لازمة” التمسك بالقضية، فإن البيان الذي ردّت فيه السعودية على تصريحات نتنياهو كان فارقًا في حدّة اللهجة والتصعيد الذي جاء فيه، إذ أكدت وزارة الخارجية أن تصريحات نتنياهو تهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال في غزة، بما في ذلك التطهير العرقي. وشددت على أن الشعب الفلسطيني مرتبط بأرضه تاريخيًا وقانونيًا، وليس دخيلاً يمكن طرده متى شاء الاحتلال. وأضافت أن هذه العقلية المتطرفة تعرقل السلام عبر رفض التعايش وممارسة الظلم لعقود، وأن حق الفلسطينيين في أرضهم ثابت، أما السلام فلن يتحقق إلا عبر حل الدولتين ومنطق التعايش السلمي.
البروفيسور عوزي رابي، الباحث البارز في مركز دايان بجامعة تل أبيب، كان أفضل من عبّر عن الفهم الإسرائيلي للمأزق السعودي، إذ رأى أن السعودية تُعتبر حامية الأماكن المقدسة للإسلام، وهي الدولة العربية الأكثر تأثيرًا حاليًا، كما أنها تعمل بتنسيق وثيق مع إدارة ترامب، وقد وجدت نفسها مضطرة للرد على هذه العلاقة، خاصة بعد أن وضعها ترامب في موقف يستدعي الخروج إلى العلن. واعتبر أن الخطاب العربي يتضمن دائمًا المطالبة بإقامة دولة فلسطينية، لكن المعنى الضمني لهذا الطرح هو “السعي للحصول على قنبلة نووية وغطاء أمني أمريكي”، وهذان الأمران متناقضان تمامًا.
لكن الاعتراف بدولة للفلسطينيين، ترى فيه “إسرائيل” تهديدًا وجوديًا للكيان. وقد وصف نتنياهو هذا الطرح بالقول إنه “يمثل مكافأة للإرهاب ويخدم إيران وليس الفلسطينيين فقط، وسيشكل ضربة كبرى لإسرائيل وحلفائها”. هي أكثر من مواقف عابرة إذًا، وأقرب إلى نهج جديد تتبناه حكومة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان، وتأتي ضمن سياق أوسع يتبنى رؤية أمريكية – إسرائيلية لإعادة تشكيل المنطقة ضمن ما يسمى “مشروع الشرق الأوسط الجديد” والذي لا تقف حدوده عند غزة فقط. في هذا السياق، لا تأتي تحركات الكيان بمعزل عن رؤية أوسع تشمل الضفة الغربية والجولان وحتى بعض المواقع الاستراتيجية في لبنان، حيث يظهر بوضوح أن ما وراء اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، مشروع يسعى لفرض واقع جديد يعزز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الجيوسياسية على المنطقة.
ضمن هذه المشهدية، يبرز المشروع التوسعي طويل الأمد الذي بدأ العمل عليه منذ سنوات بهدف إعادة هندسة ديموغرافيا المنطقة. وفي هذا الإطار، تتناغم خطة ترامب لتولي بلاده إدارة قطاع غزة مع هذا المشروع، ويتوافق مع مقترحات سابقة تشمل توطين الفلسطينيين في البلدان التي تستضيفهم.
في المقابل، عبرت المملكة عن رفضها القاطع لهذه الطروحات، ما خلق جبهة عربية داعمة لموقفها. وترافق ذلك مع تحركات دبلوماسية لمصر والأردن عكست إدراك العواصم العربية لخطورة المسار الذي سيفرض عليها، وقدرته على تهديد أمن هذه الدول وعروش حكامها. ولهذا هرع وزير الخارجية المصرية إلى واشنطن في محاولة لإقناعها بالتراجع عن أي مخطط يهدف إلى ترحيل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وانضم إليه لاحقًا ملك الأردن عبد الله الثاني.
على ضوء ذلك، يصبح الطرح السعودي عن حل الدولتين طرحًا سرياليًا، وهو ما تدركه قيادة المملكة، لكنها تتمسك به لأنها تعتقد بأنها لا تمتلك بديلًا في ظل عدم قدرتها على الخروج من عباءة الحماية الأمريكية، وكذلك الأنظمة العربية الأخرى. هذا الواقع يدركه الحليف الأمريكي – الإسرائيلي الذي لا يعوّل على قدرة هذه الأنظمة في تعطيل مخططاته. وإن كانت الحاجة إلى الحماية هي ما تتحكم بالتوجهات السعودية، فإن قيادتي مصر والأردن تعلمان أن سبب بقائهما في الحكم هي المساعدات التي تقدمها واشنطن. في هذا السياق، جاء قرار الأخيرة بتخفيض المساعدات العسكرية لمصر على خلفية معارضتها خطة ترامب في غزة.
أمام مشروع تهجير الفلسطينيين، جاء الموقف العربي كعادته هزيلًا، واقتصر على عقد قمم من دون أن تحمل في جوهرها تغييرًا جذريًا في قواعد الاشتباك السياسية أو العسكرية. أو على أقل تقدير، اتخاذ خطوات عملية بتهديد قطع العلاقات مع الكيان وممارسة ضغوط اقتصادية ممكن أن تشكل رادعًا ما لحكومة الاحتلال، أو مواجهة الحصار بإدخال المساعدات الغذائية والطبية، أو مجرد موقف دبلوماسي يسجل فارقًا حقيقيًا بدلًا من البيانات المكررة.
- الموقف العربي من خطة ترامب:
عقب إعلان ترامب عن خطته لتهجير سكان قطاع غزة، وإلقاء الكرة في ملعب الدول العربية لتحمل تبعات خطته، عقدت الدول المعنية مباشرة بهذا الملف اجتماعات لدراسة إمكانية المناورة والاحتواء للمشروع الذي من شأنه أن يلحق الضرر بكل دولة بحسب موقعها ودورها المناط بها. في 21 فبراير، استضافت الرياض قمة مصغرة ضمت ولي عهد السعودية وملك الأردن وأمير قطر وأمير الكويت والرئيسين الإماراتي والمصري، وولي عهد البحرين. بعدها بأيام أرسلت مصر وفدًا غير رسمي إلى واشنطن لتعرض “الخطة المصرية” مقابلة خطة ترامب. وفي 4 مارس، احتضنت القاهرة قمة عربية طارئة غاب عنها ابن زايد وابن سلمان، في رسالة عكست تباين موقفي المحمدين من الخطة المصرية. في المقابل حضر أمير قطر ليدعم هذه الخطة، انطلاقًا من تمسك الدوحة بما تبقى لها من نفوذ في هذا الملف.
هذه الخطة التي تعمل مصر ودول داعمة لها لتصديرها كحبل إنقاذ للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي، لا تنبع من حرص على القضية، وإنما من خوف الحكام على عروشهم ونفوذهم.
الخطة المصرية تتضمن إدارة مصرية لقطاع غزة بدلاً من سلطة فلسطينية مستقلة، على أن تكون هذه السلطة تابعة لمصر. تهدف الخطة إلى تفكيك المقاومة الفلسطينية مقابل توفير إعادة الإعمار بتمويل خليجي. وبالرغم من أن هذا الحل سيحظى بتأييد عربي، باعتباره يشكل مخرجًا من المشروع الأمريكي الهادف إلى تغيير الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة، إلا أنه يعني القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية بحيث تقدم هذه الدول أمنها على حساب تصفية القضية. وتقوم الخطة على إعمار غزة مع بقاء سكانها، وذلك وفق ما يلي:
- تقسيم غزة إلى ثلاث مناطق إنسانية تنشئ فيها مخيمات كبيرة للعيش.
- فرض إدارة مصرية عسكرية وأمنية للقطاع بدعم وتمويل خليجي.
- وجود سلطة مدنية تابعة إداريًا لمصر بدلاً من السلطة الفلسطينية.
- تفكيك المقاومة الفلسطينية تدريجيًا مقابل توفير إعادة الإعمار.
- إنشاء منطقة عازلة وحاجز على حدود غزة مع مصر لعرقلة حفر الأنفاق.
- إعادة الإعمار وفق معايير هندسية إماراتية تمنع مستقبلاً أي إمكانية لعودة المقاومة.
شهدت عواصم هذه الدول اجتماعات مكثفة لم تشهدها حتى خلال الحرب على غزة. وقد جرى تسويق الخطة المصرية أمام المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي وصل الدوحة في 11 مارس، وعقد اجتماعات مع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الموقف العربي من الملف الفلسطيني، لا يرتبط فقط بمحاذير إغضاب الأمريكي لحاجة كل دولة إليه، كما ذكرنا سابقًا، ولا يقف كذلك عند عجز أنظمة هذه الدول عن اتخاذ أي موقف بوجه الاحتلال، بل يرتبط أيضًا بتباين رؤى كل دولة فيما يخص نظرتها لهذا الملف، وهو ما من شأنه أن يعرقل تنفيذ الخطة المصرية أو أي خطة تطرح في أروقة الاجتماعات العربية، وبالتالي يفسح المجال للأمريكي في فرض خياراته وشروطه بالتهديد حينًا (كما هو الحال مع مصر بوقف المساعدات العسكرية) أو الترغيب حينًا آخر (كما هو الحال مع السعودية، إذ قُدّمت وعود باستثمارات في نيوم مقابل تمرير خطة ترامب).
يلخص الجدول التالي رؤية الدول الخليجية الفاعلة في هذه المفاوضات:
| الإمارات | السعودية | قطر |
| تقترح إدارة غزة تحت إشراف دولي بمشاركة عربية. | تؤيد استقبال لاجئين غزيين في مصر والأردن وفقًا لمساحة كل منهما وإمكاناتهما الاقتصادية. | تدعم الخطة المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين. |
| تؤيد نزع سلاح حركة حماس بالكامل. | تؤيد نزع سلاح حركة حماس. | ترفض نزع سلاح حركة حماس بالكامل. |
| ترفض أي دور سياسي لحماس في غزة. | تدعم دورًا سياسيًا لحماس بعد الحرب. | تؤيد بقاء حماس عسكريًا وسياسيًا في غزة. |
| تدعم حكم السلطة الفلسطينية للقطاع. | تشجع محادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية لتشكيل لجنة مستقلة تدير غزة. | تعارض الموقفين السعودي والإماراتي بشأن نزع السلاح. |
| تشترط نزع السلاح للمشاركة في إعادة الإعمار. | تربط دعم إعادة الإعمار بنزع السلاح. | تدعم خطة مصرية تمنح حماس دورًا سياسيًا مع نزع جزئي لسلاحها. |
| أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات. | دعمت نشر قوات دولية في غزة. | لا تدعم دخول قوات دولية إلى غزة دعمًا كاملًا أو أي تدخل عسكري دولي مباشر. |
الخاتمة:
تكشف هذه الورقة عن تحولات في العلاقات السعودية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، سواء في ولايته الأولى أو الثانية، حيث تباينت المصالح بين الطرفين بين الاستمرارية في بعض الملفات والتغيير في أخرى. فقد ارتكزت العلاقة خلال الولاية الأولى على المصالح الاقتصادية والعسكرية، وكان شعار “الدفع مقابل الحماية” هو المحور الأساسي للسياسة الأمريكية تجاه المملكة. تميزت هذه الفترة بالتركيز على دعم الكيان الإسرائيلي، مواجهة النفوذ الإيراني، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، خاصة في مجالي مبيعات الأسلحة والاستثمارات.
مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وجدت المملكة نفسها أمام تحديات جديدة فرضتها التطورات الإقليمية والدولية، أبرزها إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعد “طوفان الأقصى”، وتأثير ذلك على مفاوضات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. في المقابل، سعت السعودية إلى تنويع تحالفاتها الدولية، فوثقت علاقتها مع روسيا لضمان استقرار أسعار النفط، وعمّقت شراكتها مع الصين في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى الحماية الأمريكية لا تزال عاملًا رئيسًا يدفع الرياض إلى تقديم تنازلات في مجالات الدفاع والتكنولوجيا النووية.
- السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة بين الطرفين:
ملف التطبيع السعودي: يتوقع أن تستمر المفاوضات تحت ضغط أمريكي، مع محاولة السعودية فرض شروط تتعلق بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. ومع عودة العدوان من جديد على غزة، فإن سيناريو تأجيل الصفقة إلى أجل غير مسمى هو الأقرب للواقع، بانتظار تغير الظروف السياسية التي قد تجعل التطبيع أكثر قبولًا داخليًا وخارجيًا.
ملف القضية الفلسطينية: في ظل موقف عربي متخاذل ومشتت وتباين المصالح على حساب القضية الفلسطينية، فإن مشاريع ترامب التهجيرية، والإبادة الإسرائيلية المتواصلة، ستفتح الطريق أمام تحركات أمريكية وإسرائيلية لفرض إجراءات تتجاهل حقوق الفلسطينيين. ومع فشل التعويل على المسار السياسي، ومحاولة فرض واقع على الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، يبقى الرهان الوحيد على المقاومة لفرض شروطها في الميدان.
ملف النفط: انطلاقًا من تمسكها بتوجه ضبط أسواق النفط وفق مصالحها الاقتصادية، ستحاول السعودية تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على علاقتها بواشنطن دون تقديم تنازلات كبيرة في ملف النفط، مستفيدة من تحالفاتها مع روسيا والصين، مما قد يؤدي إلى توترات سياسية محدودة.
ملف الدفاع والتكنولوجيا النووية: رغم أهمية الدعم الأمريكي، تسعى السعودية إلى تطوير استراتيجية دفاعية أكثر استقلالية، خاصة بعد التغيرات في السياسة الأمريكية التي لم تعد تمنح الأولوية للحلفاء التقليديين. وقد اتجهت الرياض بالفعل نحو تعزيز علاقاتها العسكرية مع دول مثل فرنسا (شراء أنظمة دفاعية)، وروسيا (اتفاقيات تسليح)، والصين (تعاون في مجال الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا العسكرية). هذا التعاون قد يمنح الرياض هامش مناورة أوسع، دون الحاجة للامتثال الكامل للشروط الأمريكية.
الخلاصة:
يتضح أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة خلال عهد ترامب كانت قائمة على المصالح المتبادلة، لكنها شهدت تحولات مع التطورات المتسارعة غرب آسيا. ففي الوقت الذي ركزت فيه الولاية الأولى على المصالح الاقتصادية والعسكرية، جاءت الولاية الثانية في سياق جيوسياسي مختلف فرض تحديات جديدة على الطرف السعودي. ورغم سعي المملكة إلى تحقيق استقلالية أكبر في سياساتها، لا تزال واشنطن تلعب دورًا رئيسًا في فرض شروطها على الرياض في الملفات الأمنية والاستراتيجية. في ظل هذه المتغيرات، يبقى السؤال المطروح: هل تختار السعودية المضي في سياسة تصفير الأزمات والانفتاح على مختلف الأطراف؟ أم أن الإدارة الأمريكية – وما توليه لمصلحة الكيان في المنطقة، ستفرض تغييرًا في هذه السياسات؟