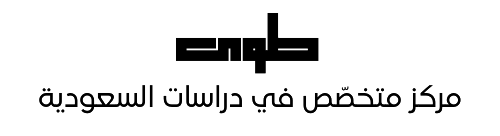أمريكا والسعودية : ودبلوماسية حقوق الانسان

لطالما شغلت قضية حقوق الانسان مساحة وازنة في الدبلوماسية الأميركية، وغالبًا ما يجري توظيفها على نحو استغلالي ضد خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وايران وكوبا وروسيا، بينما الحال يختلف تمامًا مع الدول الحليفة مثل الكيان الاسرائيلي والسعودية والامارات والبحرين. وهذا التعامل الانتقائي في ملف حقوق الانسان يؤكّد ليس فقط لا مبدئية السياسة الأميركية، بل يثبت حقيقة أن استغلال هذه القضية الإنسانية في صفقات سياسية مبتذلة وفي عمليات ابتزاز رخيصة بات سمة ثابتة في السياسة الأميركية والغربية عمومًا، الأمر الذي يجعل حقوق الانسان مادة تجاذب ومساومة بين أطراف قد يكونوا متورّطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان..
ليس الأمر مقتصرًا على إدارة أميركية دون سواها، على الرغم من أنها قد تكون على نحو فج ووقح في إدارة ترمب في سياق تجاهل على نحو قلّ نظير له أي إشارة إلى حقوق الإنسان في خطابها الدبلوماسي. في تجارب الادارات السابقة ثمة ما يلفت الانتباه إلى أن انتهاكات حقوق الانسان يجري إما تجاهلها أو توظيفها بطريقة سيئة. يحتفظ إرشيف الأمن القومي الأميركي تفاصيل عن اتصالات وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر (تولى 1973 ـ 1977) في عهدي الرئيس ريتشارد نيكسون (1969 ـ 1974) والرئيس جيرالد فورد (1974 ـ 1977)، ويظهر معارضته دبلوماسية حقوق الإنسان. وفي وثيقة كشف النقاب عنها في 1 أكتوبر 2004 تذكر أن كيسنجر انتقد كبار مساعديه لجهودهم عام 1976 لكبح انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الديكتاتوريون العسكريون في تشيلي والأرجنتين، وفقًا لنسخ جديدة من مكالمات السيد كيسنجر الهاتفية (“التيلكون”).
وقال كيسنجر لمساعده لشؤون أمريكا اللاتينية، ويليام د. روجرز، عبر الهاتف، بعد أن أعلن دبلوماسي أمريكي دعمه العلني لتقرير منظمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حول انتهاكات نظام بينوشيه في يونيو/حزيران 1976: “هذه ليست مؤسسةً تُهين التشيليين. إنها فضيحةٌ مُريعة”. بعد أن علم في وقتٍ لاحق من ذلك الشهر أن مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية قد أصدروا بيانًا إلى المجلس العسكري الجديد في الأرجنتين لقلقهم من تزايد عدد الاغتيالات والاختفاءات السياسية، اتصل كيسنجر بمساعدٍ آخر وطلب معرفة “كيف يتوافق ذلك مع سياستي”. يُسجل البيان الهاتفي المؤرخ في 30 يونيو 1976 أن كيسنجر قال: “أريد أن أعرف من فعل هذا وأفكر في نقله”. أي بعبارة أخرى، أن كيسنجر يريد التخلّص من أي عضو في فريقه يظهر اهتمامًا بحقوق الانسان في تشيلي أو غيرها.
وتُظهر الاتصالات الهاتفية التي رُفعت عنها السرية بشأن أمريكا اللاتينية معارضة كيسنجر لاستخدام الدبلوماسية الأمريكية للتنديد بالقمع في أمريكا اللاتينية. استعدادًا لاجتماع خاص مع الرئيس التشيلي الجنرال أوغستو بينوشيه في يونيو 1976، قال كيسنجر لروجرز: “أود التحدث معه، لكنني لست على نفس المستوى معكم في مسألة حقوق الإنسان. أنا ببساطة لست متحمسًا للإطاحة بهؤلاء الأشخاص” يقصد بينوشيه وأضرابه. عندما احتج روجرز على اختلاف مسألتي من يحكم تشيلي من جهة وما فعله بشأن حقوق الإنسان من جهة ثانية، وفقًا لنص 3 يونيو، رد كيسنجر: “أعلم ذلك، لكنني أعتقد أننا نُقوّضهما بشكل ممنهج”.
وفي محادثة هاتفية قصيرة، مع مساعد شلودمان لشؤون أمريكا اللاتينية، بتاريخ 30 يونيو سنة 1976، وبّخ هنري كيسنجر مساعده بعد علمه أنّ مكتب أمريكا اللاتينية التابع لوزارة الخارجية قد أصدر مذكرةً إلى المجلس العسكري الأرجنتيني بسبب تصعيد عمليات فرق الموت، وحالات الاختفاء، وتقارير التعذيب عقب انقلاب مارس 1976. وكان يسأل كيسنجر عن الشخص الذي قام بإعداد المذكرة كونها تتناقض مع سياسته وأنّه قرر إعفائه من منصبه أو نقله إلى مكان آخر. وكان كيسنجر يعارض اسقاط ديكتاتور تشيلي وقال بالحرف “أنا لست متحمّسًا للإطاحة بهؤلاء الرجال”. وفي التفاصيل: بينما كان كيسنجر يستعد لرحلته لإلقاء خطاب في مؤتمر منظمة الدول الأمريكية في سانتياغو، تشيلي، تحدث إلى مساعده ويليام روجرز حول ما إذا كان سيلتقي بالجنرال أوغستو بينوشيه على انفراد، أو سيحضر معه مُدوّنًا للملاحظات. خلال المحادثة، أوضح كيسنجر معارضته للجهود المبذولة للضغط على بينوشيه لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وشبّه هذه الدبلوماسية بالجهود المبذولة لإضعاف النظام العسكري والإطاحة به. قال كيسنجر لروجرز: “لستُ على نفس المستوى معكم في هذا الشأن. أنا ببساطة لستُ متحمسًا للإطاحة بهؤلاء الرجال”. خلال لقائه مع بينوشيه في ٨ يونيو في سانتياغو، قال كيسنجر للديكتاتور التشيلي: “في الولايات المتحدة، كما تعلم، نحن متعاطفون مع ما تحاولون فعله هنا. أعتقد أن الحكومة السابقة كانت تتجه نحو الشيوعية. نتمنى لحكومتكم كل التوفيق”. نُشر نص الاجتماع، الذي رفعت عنه السرية، كاملاً في كتاب “ملف بينوشيه: ملف رفعت عنه السرية حول الفظائع والمساءلة”. وبينما انتقد روبرن رايت، عضو وفد وزارة الخارجية إلى مؤتمر منظمة الدول الأمريكية انتقد بينوشيه لرفضه تقرير منظمة الدول الأميركي بشأن انتهاكات حقوق الانسان المستمرة في تشيلي، فإن كيسنجر قال لبينوشيه وبصورة سرية: “نريد مساعدتك لا أن نضعفك”، وشعر كيسنجر بالغضب بسب انتقاد مسؤول امريكي لسجل حقوق لانسان في تشيلي، وقال: “هذه ليست مؤسسةً ستُذلّ التشيليين. إنها فضيحةٌ مُريعة”. واقترح كيسنجر إقالة وايت.
تلك سياسة ثابتة لدى الادارات الأميركية المتعاقبة وليس مجرد موقف معزول أو حالة عابرةز وحين نطبق ذلك على إدارة ترمب في الولايتين الأولى والثانية، نلحظ غيابًا تامًا لمفردة حقوق الإنسان في الخطاب الدبلوماسي الأميركي، ولم يكن ذلك مجرد سهو أو غفلة غير مقصودة، بل هو انعكاس عملاني لقائمة الأولويات الثابتة في السياسة الأميركية. ولنتخيّل، كيف لإدارة رئيسها، أي دونالد ترمب، يتوعّد الطلاّب الأجانب في بلاده بالترحيل في حال عارضوا سياسة الولايات المتحدة فيما يخص الكيان الاسرائيلي والعدوان على قطاع غزة، وقد أصدر وزير خارجيته ماركو روبيو قرارات إلغاء لأكثر من 300 تأشيرة طالب على خلفية التعبير عن رأي مخالف للسياسة الخارجية الأميركية، كيف لهذه الإدارة أن تنتصر لحرية الرأي في بلد آخر، وتعاقب حلفائها على انتهاكات لحقوق الانسان، بل قال روبيو في مؤتمر صحافي في 27 مارس 2025 ما نصّه: “نحن نفعل ذلك كل يوم..في كل مرة أرى فيها هؤلاء المجانين أقوم بإلغاء تأشيراتهم” في إشارة إلى الطلاب الأجانب، وغالبيتهم من دول غرب آسيا، وعربية وإسلامية على وجه الخصوص.
في تطبيق السياسة الأميركية الترمبية على المملكة السعودية، هناك مخاوف جدّية بشأن التقليل من شأن قضية حقوق الإنسان في ولاية ترامب الثانية. في الشكل، سوف يستمر وضع حقوق الإنسان في المملكة السعودية خلال ولاية ترامب الثانية في مواجهة تحديات كبيرة، وخاصة بسبب التحالف الأمريكي السعودي الذي تحركه بشكل كبير الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية. ونظرًا لنهج ترامب القائم على “فن الصفقة” في السياسة الخارجية، فمن الراجح، بحسب المعطيات المتوافرة، سوف يستمر “التقليل” من شأن وضع حقوق الإنسان في المملكة السعودية من أجل المصالح الجيوسياسية والاقتصادية. وفي التداعيات:
ـ المشهد الحالي : قبل تحليل ما قد يصدر عن إدارة ترامب من مواقف إزاء حقوق الانسان في السعودية، من المهم ملاحظة الحالة الحالية لحقوق الإنسان في المملكة:
– القمع السياسي: تواصل السلطات السعودية فرض سيطرة صارمة على التعبير السياسي، حيث يواجه المعارضون والناشطون والشخصيات المعارضة عقوبات قاسية في كثير من الأحيان. وتظل أحكام السجن بحق منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، شائعة.
وعلى الرغم من الافراج المحدود عن عدد من سجناء الرأي في الشهور الأخيرة، قدّروا بالعشرات وفق حساب “معتقلي الرأي”، فإن الغالبية العظمى من سجناء الرأي لا تزال خلف القضبان، من دون أفق واضح لمصير هؤلاء. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش في 7 إبريل 2025 “إن السلطات السعودية أفرجت عن عشرات الأشخاص ممن يقضون فترات سجن طويلة لممارسة حقوقهم سلميا، لكنّها تواصل السَّجن والاحتجاز التعسفي بحق الكثيرين.” وبحسب معلومات المنظمة فإن السلطات السعودية قامت في الفترة ما بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، بالإفراج عن 44 سجينًا على الأقل، وفقا لأقاربهم ومنظمات حقوقية. منهم الناشط الحقوقي محمد القحطاني (59 عاما)؛ وطالبة الدكتوراه في “جامعة ليدز” سلمى الشهاب؛ وأسعد الغامدي، وهو شقيق ناشط حقوقي معروف يعيش في المنفى. ومع الاشادة بهذه الخطوة إلا أنها غير كافية وهي ليست بديلًا عن إنهاء السياسات القمعية في البلاد، وثانيًا أن المعتقلين منذ سبتمبر 2017 في حملة الاعتقالات التي طالت التيار الصحوي يصل عددهم حاليًا إلى 2616 سجينًا دون حساب معتقلي الرأي في المنطقة الشرقية وغالبيتهم العظمى من الشيعة، ودون حساب غير الاسلاميين من الكتاب والصحافيين والمثقفيين والإصلاحيين وهم بالعشرات ولا رجال الأعمال والأمراء، وقد قدّرت بعض المنظمات الحقوقية إجمالي عدد معتقلي الرأي في السجون السعودية بعدة آلاف، وبعض هؤلاء لا يزال معتقلًا من زمان الملك فهد (تولى 1982 ـ 2005)، ولا سيما سجناء تفجير الخبر الذين باتوا يعرفون بالسجناء المنسييين.
لا تنتهي مأساة سجناء الرأي بالافراج عنهم، بل تبدأ مأساة جديدة، حيث يخضع السجناء المفرج عنهم لقيود أخرى مثل المنع من السفر، وعدم مزاولة عمل للتكسب، وحرمان من الخدمات المدنية الحكومية، وارتداء جهاز مراقبة على الكاحل. أما المعتقلون داخل السجون فنصيبهم من الانتهاكات الممنهجة جسديًا ونفسيًا ثابت ويزداد بحسب نوع التحقيقات التي يخضعوا لها، ونوع المحققين المناوبين أيضًا.
وبحسب تقييم هيومان رايتس ووتش: “لا يوجد ما يشير إلى تحول جذري في سياسة السلطات السعودية. ما يزال الكثيرون مسجونين بسبب ممارسة حقوقهم سلميًا”.
وتوقّفت المنظمة عند الدعوة الملغومة التي قدّمها عبد العزيز الهويريني، رئيس “رئاسة أمن الدولة”، وهي جهاز أمني ارتكب انتهاكات حقوقية متكررة، للمعارضين للعودة إلى الديار دون عواقب، بموجب عرض عفو صادر عن ولي العهد محمد بن سلمان.
وقد صرّح الهويريني في 2 مارس 2025 لقناة أخبار سعودية بأن “المملكة ترحب بعودة من يسمون أنفسهم معارضين في الخارج”. إلا أن الهويريني وجه الدعوة إلى من “استُغّلوا من قبل المغرضين…أو غُرّر بهم”، بدلًا من الإشارة إلى تحوّل في سياسة الحكومة نحو التسامح مع حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، والمعتقد”. وفي ذلك إشارة بحسب المنظمة إلى العقيدة السياسية السعودية لاتزال على حالها، وإنها لا تزال تعارض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يظهر من تجريم الهويريني، ولا يزال كثيرون مسجونين في السعودية بتهم لا تُعتبر جرائم معترف بها في القانون الدولي. بينهم أشخاص مثل الطبيب النفسي المتهم زورا بالإرهاب صبري شلبي، ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، مثل وليد أبو الخير وأقارب معارضين سياسيين، كمحمد الغامدي.
ولا تزال السلطات السعودية تستهدف من يُنظر إليهم على أنهم منتقدو الحكومة أو يُعتقد أنهم على صلة بمنتقديها واعتقالهم تعسفًا. وتواصل هيومن رايتس ووتش توثيق الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما فيها الاحتجاز الطويل دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من التمثيل القانوني، والاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أساسًا وحيدًا للإدانة، وغيرها من الانتهاكات المنهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.
لفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن السعودية تفتقر إلى قانون عقوبات رسمي، وإن قانون العقوبات القادم يجب أن يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبحسب المنظمة: “تستخدم السلطات السعودية أحكامًا فضفاضة وغامضة من قانون مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة واضطهاد الأقليات الدينية. ينتهك القانون الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، إذ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لاعتقال الأشخاص واحتجازهم دون إشراف قضائي”.
وشدّدت الباحثة في المنظمة جوي شيا: “ينبغي ألا ينخدع حلفاء السعودية والمجتمع الدولي بقرارات الإفراج الأخيرة. ينبغي للسلطات السعودية الالتزام الصادق بالإصلاح بمعالجة الانتهاكات المنهجية في النظام الجزائي في البلاد، وإطلاق سراح كل من سُجن لمجرد ممارسة حقوقه”.
– حرية التعبير: هناك قيود شديدة على حرية التعبير وحرية الصحافة. والصحافة المستقلة محدودة بشدة، حيث يعاني الصحفيون من عواقب وخيمة للتعبير عن المعارضة. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أكّدت أنه منذ عام 2017 وتولي ولي العهد محمد بن سلمان الحكم الفعلي في السعودية تزايد عدد الصحفيين والمدونين القابعين خلف القضبان في سجون السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف. وذكرت المنظمة بأن السعودية من أكثر الدول اعتقالًا للصحافيين، وجاءت في المرتبة الخامسة بعد الصين وبورما وفيتنام وبيلاوس بواقع 31 صحافيًا معتقلًا، بعد أن كانت تحتل المرتبة التاسعة في العام 2021 بواقع 14 صحافيًا. أما في عام 2025 وبحسب احصائيات منظمة مراسلون بلا حدود فإن إجمالي الصحافيين المعتقلين في السجون السعودية فبلغ 19 صحافيًا.
ـ حقوق المرأة: في حين أحرزت حقوق المرأة بعض التقدم في عهد محمد بن سلمان بما في ذلك رفع حظر قيادة السيارة، والسماح بمزيد من المشاركة في الحياة العامة، إلا أن العديد من قضايا المرأة لا تزال دون حل، بما في ذلك القيود المفروضة على تولي مناصب عمومية وقوانين الوصاية والزواج.
ـ عقوبة الإعدام: تتمتع المملكة السعودية بأحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث حُكم على الأفراد بالإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك تهمة الارهاب التي يجري استغلالها على نحو مشوّه بهدف تصفية الخصوم السياسيين. وبحسب المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان: بحسب الأرقام الرسمية، ومنذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015 وحتى نهاية 2024، نفذت السعودية 1585 حكم قتل، 345 منها، أي 22% نفذت في 2024، بمعدل عملية قتل كل 25 ساعة.
وكانت صحيفة (El Confidencial) الأسبانية قد نشرت في 7 أبريل 2025 مقالة بعنوان: “الخوف والصمت في مكة: عقوبة الإعدام في السعودية أسوأ مما تظنون”[1]. جاء في المقال: يتقدم محمد بن سلمان بخطى سريعة نحو مبادرة رؤيته 2030، التي تهدف إلى إبراز صورة حديثة، وإرضاء شركائه الغربيين بموسيقى الروك الهادئة، وتحويل البلاد إلى مشهد مبهر. خيال منفصل عن الواقع ينزف في براثن القمع والهدر. إن المملكة السعودية اليوم لا تسعى إلى جذب المستثمرين فحسب، بل تحاول بكل الوسائل تحويل الانتباه عن سياساتها القمعية في مجال حقوق الإنسان. ولكن على الرغم من مدى إبهارها، فإن عددًا قليلًا من المهرجانات لا يستطيع إخفاء الخوف والظلم اللذين يشكلان السمات الحقيقية للمملكة: نحن نتحدث عن اعتقال المثقفين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب منشورات بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجرائم الحرب في اليمن ، والتعذيب والإساءة في السجون، وحتى الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. “نحن السعوديون نعيش في خوف من أفعالنا”، يعترف (KF)، أحد أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي. نحن أيضًا نخشى ما يعتقده الآخرون عنا. يكفي اتهامٌ كاذب، أو محاولةٌ للتخلص منّا، أو اعتبارنا تهديدًا للسلطة، وقد ينتهي بنا المطاف في السجن أو يُحكم علينا بالإعدام. يعيش الكثير منا في صمت؛ لا نتكلم، لا ننظر، لا نشكو، والأهم من ذلك كله، لا نسبب مشاكل. عشنا هكذا منذ صغرنا: خائفين من الآخرين، حتى من أقاربنا أو جيراننا. الخوف جزءٌ من الثقافة السعودية.
وتحت عنوان “الخوف: جزء حيوي من الآلة السياسية” لفتت الصحيفة إلى ارتفاع عدد النساء الأجانب اللاتي تمّ إعدامهن في السعودية، ونقلت عن الناشطة الحقوقية لينا الهذلول: “إن حقيقة أن 70% من النساء اللواتي تم إعدامهن في عهد ولي العهد بن سلمان كن أجنبيات، وأن أياً من الأجانب الذين تم إعدامهم لم يأتِ من “دول قوية “، دليل على نمط من التمييز العنصري والاقتصادي”.
وتذكر الصحيفة: منذ توليه السلطة الفعلية في المملكة، سعى محمد بن سلمان إلى إظهار صورة أكثر انفتاحًا، وتمثل إصلاحاته طُعمًا لجذب المستثمرين الدوليين، ولكنّه يدرك أن الضغوط المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان تشكل عائقاً أمام سجله. وليس من غير المعتاد أن نسمعه في المقابلات يتحدث عن خطط لمراجعة سياساته الأكثر إثارة للجدل؛ وفي الواقع، في عام 2022، جدّد ولي العهد التزامه بخفض أحكام الإعدام، وهو الوعد الذي قطعه لأول مرة في عام 2018. ومع ذلك، استمر معدل الإعدام في الارتفاع، ليغلق عام 2024 بأعلى عدد من عمليات الإعدام في تاريخ البلاد الحديث.
وهناك اتهام آخر يواجهه ولي العهد (مع تسهيل الإفلات من العقاب) وهو استحالة التحقق من ما إذا كانت المحاكمات التي يخضع لها المدانون عادلة ومنصفة. ويمتد غياب الشفافية في النظام القضائي من لحظة الإعتقال حتى بعد الإعدام. ولذلك فإن البراءة أو الذنب لا تعتمد على العمليات القانونية المشروعة، بل على الأسباب التعسفية للحكومة الاستبدادية. كما لا يمكننا الشكوى خوفًا من العواقب، ونحن محكومون بالحزن في صمت. كما تندد منظمة القسط بالغموض الذي يحيط بهذه العملية. وتقول الهذلول: “إن رفض إعادة الجثث إلى العائلات والافتقار إلى التقارير العامة عن عمليات الإعدام يضمن عدم وجود دليل واضح على تصرفات الدولة. إن عقوبة الإعدام لا تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب؛ إنها في الأساس أداة للسيطرة والقمع الاجتماعي والسياسي. يعيش المجتمع في خوف دائم من التعبير عن أي رأي يمكن اعتباره إشكاليًا. ويخشى العديد من الشباب مشاركة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن حرية التعبير معدومة تقريبًا.
وتقول آية س، موطنة سعودية تعيش في المنفى في برلين: “لا يمكنك أن تمتلك أيديولوجيتك الخاصة أو أن تتخذ موقفًا..نحن نعيش في المملكة السعودية حيث إذا كان لديك المال، يمكنك شرب الكحول، وحضور الحفلات المفرطة، والغناء بأعلى صوتك في جوقات يعتبرها الكثيرون تجديفًا. ولكن لا يمكنك أن تمتلك أيديولوجيتك الخاصة أو أن تتخذ موقفًا، على سبيل المثال، ضد احتجاز القاصرين أو التعذيب في السجون”. نحن نتحدث عن خوف يعرفه منتقدو النظام جيدًا. واضطر العديد من السياسيين والمحامين والناشطين والمبدعين إلى الفرار من البلاد خوفًا على حياتهم. تُستخدم عقوبة الإعدام كأداة قمع لبثّ الخوف وإسكات المعارضة. وهذا يُظهر أن وعود النظام بالحد من عقوبة الإعدام رمزية إلى حد كبير، وتهدف إلى استرضاء المنتقدين الدوليين دون إحداث تغيير حقيقي، كما تقول لينا الهذلول. ويواصل المجتمع الدولي التصفيق لانفتاح المملكة السعودية، متجاهلاً الواقع القاسي المختبئ وراء واجهتها. ويظهر الغرب الجبن عندما يتعلق الأمر بالتشكيك في الوصايا الدينية المسيئة للدول القوية، ويتصرّف بطريقة غير مسؤولة عندما يتناول نفس القضايا في الدول الضعيفة اقتصاديًا. وتظل المملكة السعودية تتمتع بالإفلات من العقاب، على الرغم من الشكاوى العديدة من منظمات حقوق الإنسان، حيث تستخدم عقوبة الإعدام كمبرر ديني وتترك أي إمكانية للإصلاح تحت رحمة الشريعة الإسلامية التي يتم تفسيرها بشكل انتقائي. وهكذا، في حين يكتفي الغرب بالوعود البسيطة بتحويل النظام الجزائي، فإن المملكة السعودية تحافظ على سلطتها سليمة.
ويتساءل ناشطون حقوقيون من المملكة السعودية في المنفى: “إذا كان بإمكان السياح زيارة البلاد والرقص فيها، فلماذا لا يُسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالتواجد هناك؟ إذا كانت السعودية قادرة على استضافة فعاليات الأمم المتحدة مثل منتدى حوكمة الإنترنت، فلماذا لا تسمح لمراقبين مستقلين من الأمم المتحدة، مثل المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتواجد هناك؟ تسأل لينا الهذلول. ويختتم فهد قائلاً: “ربما لأن السعودية لم تعد بيتاً لله وأرضًا للأنبياء، وأصبحت مكة للفجور والجرائم ضد الإنسانية والمال والإفلات من العقاب”. كل هذا مصحوبًا بموسيقى البوب وومضات الأضواء الملونة. وفي النهاية فإن القانون وحقوق الإنسان مجرد منتج آخر؛ وقليلون هم من يستطيعون تحمّل تكلفتها.
ـ معاملة الأقليات: غالبًا ما يتم التركيز على الطائفة الشيعية، كأقلية تعاني من الحرمان والتهميش والتمييز منذ نشأة المملكة السعودية في 1932. فهناك تمييز منهجي، تمارسه السلطات السعودية منذ عقود، وعلى الرغم من التبدّل الرمزي في عهد سلمان والتحوّل نحو سياسة الانفتاح اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن تقارير منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية لا تزال ترصد حالات عن العنف الطائفي والقيود المفروضة على الحرية الدينية.
وبحسب تقرير صادر عن “منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” في 11 فبراير 2025 أن الطائفة الشيعية في السعودية تواجه “تمييزًا منهجيًا وقيودًا صارمة على حريتها الدينية، وأن سياسة التهميش ضد الشيعة تمتد “إلى مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الممارسات الدينية، والتعليم، والتوظيف، والنظام القضائي. ويتم استبعاد أفراد المجتمع الشيعي من بعض الوظائف في القطاع العام، كما يعانون من الإهمال الاقتصادي من قبل المؤسسات الحكومية السعودية”، كما يخضع بناء المساجد الشيعية لضوابط صارمة حيث يتطلب تراخيص رسمية، ولا يُسمح ببنائها إلا في المنطقة الشرقية حيث تتركز الكثافة السكانية للشيعة. ويذكر التقرير أن السلطات السعودية هدمت “العديد من المنشآت الدينية الشيعية وفرضت قيودًا على المناسبات الدينية الجماعية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، أمرت الحكومة بهدم مسجد في العوامية، وهي بلدة ذات أغلبية شيعية”. وأيضًا، “تتعرض المناهج التعليمية الوطنية في السعودية لانتقادات واسعة بسبب تبنيها خطابًا معاديًا للشيعة. فلا توجد معاهد دينية شيعية، كما يُحظر نشر أو توزيع أي مواد دينية شيعية داخل حدود المملكة. يواجه الطلاب الشيعة تمييزًا داخل النظام التعليمي، بينما يُستبعد المعلمون الشيعة من تدريس المواد الدينية أو تقلّد المناصب القيادية في المدارس”. ويعد التمييز في التوظيف ضد الشيعة ظاهرة منتشرة، خصوصًا في القطاع الحكومي وقطاع الأمن. إذ يواجه الشيعة صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف حكومية أو الترقية فيها، كما أنهم لا يحظون بتمثيل عادل في المناصب العليا داخل المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة. يؤدّي هذا الإقصاء الممنهج إلى تقليل الفرص الاقتصادية وتعميق استمرار الفجوات الاجتماعية”.
وعلى مستوى النظام القضائي القائم على التفسيرات السنيّة للشريعة الإسلامية، فيُظهر تحيزًا واضحًا ضد الشيعة. حيث غالبًا ما تصدر في حق المتهمين الشيعة أحكام قاسية وغير متناسبة، كما أن شهاداتهم قد تُهمّش أو تُرفض في المحاكم”. ويضيف التقرير: “في الحالات القصوى، يتحول التمييز الاجتماعي ضد الشيعة إلى هجمات عنيفة. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2015 و2016، استهدفت عدة هجمات مساجد ومناسبات دينية شيعية في المنطقة الشرقية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين”.
وعلى الرغم من إطلاق مبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحديث البلاد وتحسين صورتها العالمية، لا يزال التمييز الممنهج ضد الطائفة الشيعية قائمًا. وبحسب تعليق منظمة هيومان رايتس ووتش في 20 سبتمبر 2018 بأن “الاصلاحات السعودية لا تتضمن التسامح مع الشيعة”.
نهج ترامب إزاء حقوق الإنسان: منظور صفقوي .
خلال الولاية الأولى لترامب، كان هناك نمط واضح من “التقليل” من أهمية قضايا حقوق الإنسان لمصلحة الحفاظ على علاقات قوية مع “حلفاء رئيسيين” مثل المملكة السعودية. غالبًا ما أعطى نهج ترامب “أمريكا أولاً” الأولوية للمخاوف الاقتصادية والأمنية على الدفاع عن حقوق الإنسان. ولذلك فإن إدارته:
ـ قللت من أهمية مقتل خاشقجي: لقد تمت إدانة “قتل جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية في إسطنبول على نطاق واسع دوليًا. ومع ذلك، قلّل ترامب من أهمية الحادث، وركز على الحفاظ على العلاقات مع محمد بن سلمان، المتورّط الأول في الجريمة ومن أصدر الأوامر لفريق الاغتيالات (المعروف باسم فرقة النمور)، وكذلك على الروابط الاقتصادية (مثل مبيعات الأسلحة) بدلاً من اتخاذ إجراءات كبيرة ضد المسؤولين السعوديين المتورطين.
– واصلت مبيعات الأسلحة: على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن دور المملكة السعودية في العدوان على اليمن، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، استمرت إدارة ترامب في الموافقة على “صفقات أسلحة” كبرى مع المملكة، والتي يجمع المراقبون والناقدون أن هذه الصفقات مكّنت التحالف الذي تقوده السعودية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن.
ـ حقوق الإنسان في ولاية ترامب الثانية:
نظرًا لأولويات السياسة الخارجية لترامب و “الروابط الاقتصادية والأمنية العميقة” بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية، سوف تظل مخاوف حقوق الإنسان “هامشية” لخدمة المصالح الاستراتيجية الأوسع، ولكن هناك بعض الديناميكيات الرئيسية التي يجب مراعاتها:
أ. تجاهل القضايا العالقة :
ـ إرث خاشقجي: من المرجح أن تتقصّد إدارة ترمب طمس كل معالم “جريمة قتل خاشقجي” بعد ان كانت “نقطة اشتعال رمزية” في العلاقة إبان إدارة بايدن. إن إدارة ترامب لن تكتفي بتجنب تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، أو حتى التركيز على “الشراكات الاقتصادية”، كما يظهر من العرض السعودي باستثمار ما يربو عن نصف تريليون دولار ورد ترمب برفع المبلغ الى تريليون دولار، بل ثمة مؤشرات على أن فترة ترمب سوف تشهد إعادة تعويم لابن سلمان الذي لم يزر العاصمة الاميركية طوال فترة إدارة بايدن، ويتطلع إلى أن تحط أقدامه الولايات المتحدة. وسوف تركّز إدارة ترمب على المخاوف الأمنية الإقليمية المشتركة، في ظل تحوّلات متسارعة تشهدها المنطقة والعالم. في الخلاصة: سوف تصبح قضية خاشقجي من الماضي في إدارة ترمب، مع التركيز على الحفاظ على التحالف السعودي الأمريكي ومحاول استغلال الوقائع المتحوّلة لتعزيز الشراكة السعودية الاميركية.
ـ الحرب على اليمن: من المرجح أن يظل تورط المملكة السعودية في العدوان على اليمن والذي أدى إلى “كارثة إنسانية” – قضية نقاش في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، ولا سيما بعد انخراط إدارة ترامب في حرب مباشرة ضد اليمن عبر حملات عسكرية جوية واعتراض الصواريخ والمسيّرات التي تنطلق من اليمن باتجاه الكيان الاسرائيلي، وبعض هذه الاعتراضات تتم من داخل الأجواء السعودية. وفي ظل أحاديث متكررة عن احتمال استئناف الحرب الشاملة على اليمن، فإن ترمب سوف يواصل تقديم الدعم العسكري للعمليات السعودية في اليمن، على الرغم من المخاوف بشأن “الخسائر المدنية” و”الحصار” الذي أدى إلى تفاقم الأزمة. وسوف تستمر “مبيعات الأسلحة” الأميركية إلى المملكة السعودية أيضًا، من دون اكتراث للضغوط الدولية. وتفيد مصادر يمنية بأن السعودية والامارات تحشدان قوات كبيرة استعدادًا لحرب برية واسعة النطاق، وإن احباط هذه الحرب يتوقف على فشل الحملة الجوية الاميركية التي لم تحقق حتى الآن أهدافها وخصوصًا اسناد اليمن لقطاع غزة بوقف الملاحة في البحرين الأحمر والعربي خصوصًا السفن التجارية المتوجهة الى فلسطين المحتلة.
ب. التدقيق المتزايد من المجتمع الدولي:
بينما يواصل ترمب ترجيح أولوية “العلاقة الشخصية مع محمد بن سلمان”، فمن الطبيعي أن يشهد “سجل حقوق الإنسان” في المملكة السعودية تدهورًا وتاليًا سوف يكون في مواجهة التدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، والحلفاء الغربيين، وفصائل معينة في الكونجرس. لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية تحظى بنفوذ واسع على هذه الأطراف الذي يجعل الضغوطات على السعودية بتأثير منخفض أو من دون تأثير أصلًا.
ومع بقاء ظروف حقوق الإنسان راكدة أو متدهورة، وخاصة في مجالات مثل حرية التعبير والحرية الدينية، فمن المرجح أن ينمو “الضغط” من المجتمع المدني والهيئات الدولية، وخاصة من الجماعات التي تدعو إلى “المساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان في السعودية ولا سيما قضية الاعدامات المتزايدة.
ج. ردود فعل محلية محتملة في الولايات المتحدة:
على الرغم من أن تركيز ترامب على “الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية”، إلا أن “الضغوط السياسية المحلية” قد تتصاعد، وخاصة من قبل منظمات أهلية مناصرة والديقمراطية وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. المخاوف الحزبية بشأن سلوك المملكة السعودية – وخاصة فيما يتعلق بالقمع الداخلي، وحقوق المرأة، والأقليات. ومع أن هذه النشاطات قد لا تؤدي إلى عقوبات، وقيود تشريعية على مبيعات الأسلحة، أو حتى دعوات للمساءلة، ولكن قد يضطر ترامب إلى التعامل مع “التوترات الداخلية” مع محاولة الحفاظ على علاقة وثيقة مع المملكة السعودية. ونتذكر هنا الدعاوى القضائية المرفوعة ضد محمد بن سلمان في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها الدعوى المقدّمة من قبل سعد الجبري، أحد مسؤولي الأمن في وزارة الداخلية سابقًا. إن ما يمنع محمد بن سلمان من زيارة الولايات المتحدة هو الملاحقات القضائية وإن السلطات الواسعة التي بحوزة الرئيس الأميركي ترمب لا تكفي لوقف تلك الملاحقات.
د. سردية “الإصلاح” في السعودية:
كان محمد بن سلمان يروّج لسردية “الإصلاح” في المملكة السعودية من خلال خطته “رؤية 2030″، والتي تتضمن هدف تحديث الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن النفط، فضلاً عن الإصلاحات الاجتماعية مثل “زيادة مشاركة المرأة” في القوى العاملة. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات “محدودة” ولا تمتد إلى “قضايا أكثر جوهرية” مثل “الحريات السياسية”.
في ولاية ترامب الثانية، سوف يبالغ محمد بن سلمان في استغلال “أجندة الإصلاح” لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم السعودية باعتبارها “قوة تحديثية” في المنطقة مع تهميش انتقاد “القمع السياسي” أو “انعدام الحريات المدنية”.
4 ـ السياسة الخارجية وحقوق الإنسان :
– مع تنويع المملكة السعودية لعلاقاتها الخارجية بشكل متزايد وسعيها إلى التعامل مع الصين وروسيا والقوى الناشئة الأخرى، تجد نفسها أقل اعتمادًا على الانتقادات الغربية لسجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد أدّى هذا إلى “تهميش الضغوط” على السعودية لإجراء تحسينات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة إذا استمر ترامب في “تفضيل التحالفات الصفقوية” على “حقوق الانسان وهمومها”.
ومع ذلك، قد تكون هناك ضغوط دولية محدودة من الحكومات الغربية، وخاصة إذا أدّت تصرفات السعودية الإقليمية (مثل ارتكاب جرائم ضد جماعات بعينها على خلفية إثنية أو طائفية أو إساءة معاملة المعارضين والناشطين بصورة لافتة) إلى مزيد من التدقيق أو العزلة الدبلوماسية من قبل القوى الأخرى.
على أية حال، فإن وصول ترمب الى البيت الأبيض مرة أخرى، منح ابن سلمان فرصة التحرر من ضغوطات الحلفاء الأوربيين، والتركيز على المصالح الاقتصادية والتجارية، وتخفيض الاهتمام بملف حقوق الانسان، وهذا ما يجري حاليًا في العلاقة بين السعودية وأوروبا.
5 ـ انعكاس “أمريكا أولاً” على حقوق الإنسان :
في ولاية ترامب الثانية، من المرجح أن يؤكّد إطار “أمريكا أولاً” الأوسع على الشراكات الاستراتيجية والفوائد الاقتصادية. وفي النتائج، سوف تتراجع مسألة حقوق الإنسان إلى المرتبة الثانية وربما أدنى من ذلك بعد الاستقرار الجيوسياسي والمصالح الاقتصادية، مما يعني أن السعودية لن تواجه الكثير من الضغوط لتحسين ظروف حقوق الإنسان لديها. ومن المرجح أن تستمر حكومة الولايات المتحدة في إعطاء الأولوية للعلاقات العسكرية والاقتصادية مع السعودية على الدفع نحو إصلاحات ديمقراطية كبيرة أو تحسينات في مجال حقوق الإنسان.
وعليه، في فترة ولاية ترامب الثانية، من غير المرجح أن يتحسن وضع حقوق الإنسان في السعودية بشكل لافت. على العكس، سوف تؤدي الأولويات الاستراتيجية لترامب – التي تركز على الأمن الإقليمي، ومواجهة إيران، والشراكات الاقتصادية – إلى تجاهل قضايا حقوق الإنسان أو التقليل من أهميتها. وفي حين قد يكون هناك بعض الرفض الدولي والمحلي من قبل المنتقدين، فإن نهج ترامب القائم على المعاملات في السياسة الخارجية من المرجح أن يفضل الحفاظ على علاقات قوية مع السعودية، وخاصة من خلال المبيعات العسكرية والتعاون الاقتصادي.
من المرجح أن تظل مخاوف حقوق الإنسان، والقمع السياسي، على الهامش، مع تخفيف الإدانة الغربية غالبًا بالرغبة في الحفاظ على مصالح مشتركة مع السعودية ومواصلة التحالف الأمريكي السعودي.
السؤال: هل سوف يستغل السعوديون ميل ترامب إلى المعاملات التجارية لتصعيد إجراءاته ضد نشطاء حقوق الإنسان والمقاتلين من أجل الحرية؟
الجواب: ليس مستبعدًا، ومن الممكن أن تستغل السعودية نهج ترامب في السياسة الخارجية الصفقوية لتصعيد إجراءاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان والمقاتلين من أجل الحرية، وقد أظهرت بالفعل ميلًا لإعطاء الأولوية للمكاسب الجيوسياسية والاقتصادية على مخاوف حقوق الإنسان، وخاصة في فترة ولاية ترامب الأولى. وحيث تفيد المؤشرات على استمرار ولاية ترامب الثانية بنفس الديناميكية، فإن السعودية سوف تتشجع على اتخاذ “إجراءات أكثر عدوانية” على المستوى المحلي والإقليمي، نظرًا لأن “الاستجابة الأمريكية” لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد ترامب كانت “خافتة” نسبيًا.
من جهته، سوف يركز محمد بن سلمان بشدة على تعزيز “سلطته” و”شرعيته”، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. بالنسبة إليه، فإن قمع المعارضة والقضاء عليها أمر بالغ الأهمية لضمان بقاء “حكمه بلا منازع”. فقد يسهل غياب الضغوط الخارجية القوية (مثل تلك من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي) على محمد بن سلمان تصعيد أفعاله “الاستبدادية”، خاصة إذا شعر أنه لا يواجه “عواقب وخيمة” لسلوكه.
إن الاستخدام المتزايد من جانب السعودية لوسائل الإعلام الحكومية وسيطرتها على السرد العام قد يساعد في قمع المعارضة، كما أن تسامح ترامب مع الاستبداد قد يجعل هذه العملية أكثر سلاسة.
[1] https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-04-06/arabia-saudi-y-su-principal-tabu_4067882/