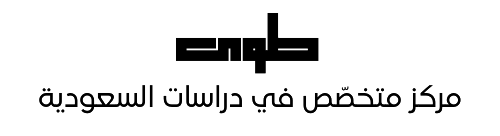مودة اسكندر

المقدمة :
تُجمع دول مجلس التعاون الخليجي على موقف موحد من القضية الفلسطينية، يقوم على دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وحقهم في تقرير مصيرهم. وقد شكّل هذا الدعم عنوانًا للمواقف الرسمية التاريخية لهذه الدول، التي يعاد التأكيد عليها في كل اجتماع أو مؤتمر أو موقف رسمي يتطرق إلى القضية.
إلا أن الأفعال لا تتوافق دائمًا مع الأقوال، بل تتعارض معها أحيانًا. وهذا ما يتجلى بوضوح في حقيقة مواقف عدد من الدول الخليجية من القضية الفلسطينية، حيث تتحول القضية إلى مجرد استثمار سياسي، أو ورقة ضغط تفاوضية، أو سلعة تباع وتشترى لتحصيل نفوذ أو مكاسب معينة.
وقد شكل العدوان على غزة فرصة لكشف حقيقة الشعارات العربية بشأن فلسطين وقضيتها، فكان امتحانًا لحكومات هذه الدول وشعوبها. امتحان أظهر أن كل ما قيل ويقال لا يتعدى كونه مادة للاستهلاك الإعلامي لا أكثر. أما حقيقة المواقف، فتتكشف عبر الأفعال، أو بمعنى أدق، في الحالة الفلسطينية، عبر “اللا أفعال”، حيث يصبح الصمت تواطؤًا في جرائم الإبادة. فكيف إذا كان الصمت مصحوبًا بتآمر ودعم وتمويل للقاتل؟!
في هذه الورقة، نسعى إلى البحث في خفايا مواقف السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر من القضية الفلسطينية، ومن الجريمة المستمرة بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.
تنطلق الورقة من فكرة التباين بين ما يعلن وما يمارس فعليًا من قبل هذه الدول، إذ رغم ما تدعيه من دعم للفلسطينيين، إلا أن مواقفها لا تظهر أي تحرك جدي لنصرة الفلسطينيين أو للدفع باتجاه إنهاء العدوان عليهم.
وتبرز أهمية هذه الورقة في كشف خفايا مصالح هذه الدول مما يجري، وحجم التآمر القائم بينها وبين الكيان الإسرائيلي، سواء من خلال مواقف علنية كاتفاقيات التطبيع، أو عبر قنوات خفية تحت مسميات مختلفة.
أولًا: دول الخليج بين القضية الفلسطينية والموقف من الكيان الإسرائيلي :
1. دول الخليج والموقف من “إسرائيل”
قبل الحديث عن الدور الذي لعبته دول الخليج في دعم العدوان على غزة، لا بد من قراءة سريعة في طبيعة العلاقات التي تجمع هذه الدول بالكيان الإسرائيلي، وموقفها من القضية الفلسطينية.
في العلن، تؤكد جميع دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لقيام دولة فلسطينية، ولحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. لكن إلى أي مدى تنسجم هذه المواقف الرسمية مع حقيقة مواقف هذه الدول؟
• يمكن تقسيم دول الخليج إلى ثلاثة اتجاهات فيما يتعلق بالموقف من الكيان:
• دول التطبيع العلني: وهما الإمارات والبحرين، اللتان تقيمان علاقات رسمية مع الكيان.
• دول التطبيع الناعم: وهما السعودية وقطر، اللتان ترفضان حتى الآن التطبيع العلني مع الكيان، لكنهما تقيمان علاقات غير رسمية معه في مجالات متعددة (اقتصادية، عسكرية، أمنية، ثقافية، فنية… إلخ)، وتبديان استعدادًا للدخول في مفاوضات للتطبيع وفق شروط معينة.
• دول ترفض التطبيع: وهما الكويت وعُمان، اللتان ترفضان إقامة علاقات رسمية مع الكيان، وذلك يعود إلى الدور الذي تلعبه هاتان الدولتان بوصفهما تلتزمان الحياد بشكل عام، ويمكن تأطير دورهما في المنطقة بدور الوسيط. ومع ذلك، لا يُستبعد وجود خيوط من التطبيع السري بين الجانبين.
في هذا السياق، يمكن القول إن العلاقات المباشرة بين الكيان وبعض دول مجلس التعاون الخليجي تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن. فعلى سبيل المثال، كانت عُمان ومعها قطر سبّاقتين إلى إقامة علاقات مع الكيان عام 1996، عندما افتتحتا مكتب تمثيل تجاري في عاصمتيهما، وذلك بخلاف البحرين والإمارات، اللتين كانت “اتفاقيات إبراهيم” في عام 2020 أولى أشكال التطبيع الرسمي العلني لهما مع الكيان.
2. مؤشر التطبيع وحساباته
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة التطبيع بين عدد من الدول الخليجية والكيان الإسرائيلي، سواءً في السر أو في العلن، والذي اتخذ أشكالًا متعددة تشمل جوانب سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية، مما يعكس تحولات جذرية في أولويات الأنظمة الخليجية، بعيدًا عن الشعارات التي لطالما رفعت عن “نصرة للقضية الفلسطينية”.
في تقرير يصنّف الدول العربية وفق “مؤشر مركّب” لقياس مستوى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023، يرصد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق حضورًا خليجيًا لافتًا على خارطة التطبيع، حيث تتصدّر الإمارات القائمة بوصفها الدولة الأكثر انخراطًا في العلاقات مع الكيان، بعدد كبير من حالات التطبيع في مختلف المجالات، منها 56 حالة تطبيع اقتصادي وتجاري، و24 حالة سياسية، و18 دبلوماسية، إضافة إلى نشاطات واسعة في ميادين التعليم والبحث العلمي والثقافة والرياضة.
وتحلّ البحرين في المرتبة الثانية، مع تزايد لافت في التطبيع الأمني والعسكري (10 حالات)، فضلًا عن 22 حالة تطبيع اقتصادي و14 دبلوماسية، ما يشير إلى توجّه استراتيجي نحو تعزيز الشراكة مع الكيان في الملفات الحساسة.
أما السعودية، وعلى الرغم من عدم توقيعها اتفاق تطبيع رسمي، إلا أنها تتصدر قائمة الدول غير المعلنة في حجم التطبيع غير الرسمي، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والأمن، وتظهر مؤشرات متقدمة على مستوى العلاقات الخفية، تؤكدها تسريبات متكررة بشأن التنسيق الاستخباراتي والتعاون السيبراني مع الاحتلال. أما قطر، وإن لم تدرج ضمن الدول المطبعة علنًا، إلا أن دورها الوظيفي، في ترتيب ملفات التفاوض أو التمويل، لا ينفصل عن سياق التفاهمات الميدانية مع الكيان.
تشير مؤشرات التطبيع، إذًا، إلى تشكّل خارطة جديدة للعلاقات الخليجية – الإسرائيلية، تتراوح بين المعلن والخفي، لتكشف عن تحولات عميقة في تموضع بعض الأنظمة الخليجية ضمن مسارات جديدة قوامها التلاقي مع الأجندات الصهيوأمريكية في المنطقة. تتبّع هذه المؤشرات، يوضّح مسار التحولات الإقليمية الجارية، ويكشف حقيقة ما خلف الخطاب السياسي المعلن مقارنة مع الممارسات الفعلية على أرض الواقع. ففي الوقت الذي تستمر فيه التصريحات الرسمية بالتأكيد على دعم “الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”، تتوسّع الأنشطة التطبيعية، وتبرم الاتفاقيات، وتفعّل الزيارات واللقاءات السرية منها والعلنية، في محاولة لترسيخ صورة الكيان كفاعل “طبيعي” في المنطقة.
وقد تمظهر هذا الانخراط بوضوح بعد عملية “طوفان الأقصى”، إذ لم تقدّم دول الخليج مراجعة لسياساتها التطبيعية، بل بدا لافتًا الإصرار على الفصل بين حرب الإبادة المستمرة في غزة ومسارات التطبيع المتواصلة. لم يتغير شيء في أجندات العلاقات، بل استمرت اللقاءات والتنسيقات في ملفات الاقتصاد والأمن، بل وحتى مباحثات التطبيع القائمة، في رسالة من هذه الدول أن التطبيع خيار استراتيجي ولو على حساب الدّم الفلسطيني.
يعزز هذا الطرح ما جاء في تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” التابع لجامعة تل أبيب، إذ يشير إلى أن غالبية دول الخليج – باستثناء قطر – تتقاطع مع الكيان في رغبتها بإنهاء سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة، وتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، إلى جانب إضعاف جماعة الإخوان المسلمين. وتستند هذه الرؤية إلى خشية أن تُترجم إنجازات حركة حماس أو حزب الله اللبناني إلى مكاسب تعيد الاعتبار لخطاب المقاومة، لتشكّل خطرًا على استقرار أنظمة ترى في التقارب مع الكيان حماية لمصالحها، وضمانة لموقعها ضمن التوازنات الإقليمية المتغيرة.
لا يعد موضوع التطبيع ملفًا طارئًا إذًا، فهو لطالما طرح ما وراء الكواليس، إلا أن الحديث عنه دخل مرحلة علنية بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها لإعادة تشكيل منطقة غرب آسيا من جديد، ضمن ما تسميه بـ”مشروع الشرق الأوسط الجديد”. وفي هذا الإطار، لم يعد التطبيع العلني مع الكيان الإسرائيلي مجرد خطوة رمزية، بل أصبح ورقة اعتماد ضمن معادلة الولاء الاستراتيجي، تسعى من خلالها دول الخليج إلى تثبيت حضورها كشركاء موثوقين في مشروع “إعادة ترتيب المنطقة” وفق الرؤية الأميركية.
3. تموضع دول الخليج من الكيان
وعليه يمكن الحديث عن أعمدة بنيوية شكلت مرحلة التلاقي في الأجندات بين دول الخليج من جهة، وكل من واشنطن وتل أبيب من جهة ثانية:
العلاقة مع الولايات المتحدة: تنظر دول الخليج إلى ملف التطبيع مع الاحتلال بوصفه مدخلًا استراتيجيًا لإعادة تموضعها ضمن أولويات واشنطن، لا سيما في ظل التغيرات العميقة في ميزان المصالح الأمريكية بالمنطقة. فمع تراجع الاعتماد على نفط الخليج وانهيار معادلة “النفط مقابل الحماية”، باتت هذه الدول تبحث عن وسائل جديدة لضمان استمرارية الشراكة الأمنية والسياسية مع الولايات المتحدة، من خلال التقرّب من مراكز النفوذ في الدولة العميقة وتقديم نفسها كحليف موثوق في ترتيبات مشروع “الشرق الأوسط الجديد”.
الحاجة إلى التكنولوجيا الأمنية: تنبع هذه الحاجة من بُعدين مترابطين، خارجي وداخلي. فعلى المستوى الخارجي، تسعى دول الخليج إلى امتلاك تقنيات متقدمة تعزّز قدرتها على مواجهة ما تصفه بـ”التهديدات الإقليمية”. أما داخليًا، فتتمثل الحاجة في تطوير أدوات المراقبة والسيطرة لتعزيز القبضة الأمنية وقمع أي حراك داخلي محتمل. وفي كلا الجانبين، تُعدّ إسرائيل شريكًا مثاليًا نظرًا لتفوقها في مجالات الأمن السيبراني، وتقنيات المراقبة، والذكاء الاصطناعي العسكري.
العدو الخارجي: منذ نشأتها، اعتمدت دول الخليج على فكرة “العدو الخارجي” كوسيلة لتعزيز شرعية أنظمتها والحفاظ على استقرار حكمها، حيث شكّلت التهديدات الخارجية ذريعة دائمة لتبرير القبضة الأمنية والتحالفات الخارجية. ومع تلاقي المصالح الخليجية والإسرائيلية في السنوات الأخيرة، باتت إيران، ومعها دول ما يعرف بمحور المقاومة، تصنّف كـ”الخطر الأبرز على الاستقرار الإقليمي”. ووفق هذا التصور، أصبحت مواجهة النفوذ الإيراني، أو على الأقل احتواؤه والحد من تمدده، أولوية استراتيجية مشتركة، تبرر التنسيق الأمني والسياسي في مثلث العلاقات الأمريكية، السعودية، و”الإسرائيلية”.
يمثّل ما سبق النواة الأساسية للتحالف الذي تشكل بصورته الجديدة بدءًا من عام 2020 في عهد إدارة ترامب، مع توقيع اتفاقيات التطبيع، وما تلاها من مساعٍ لتوسيع “نادي المطبعين” ليشمل دولًا جديدة، أبرزها السعودية. ومع ذلك، تأخرت بعض الدول في الانضمام إلى هذا المسار، ويرجع ذلك إلى اختلاف الحسابات الداخلية لكل دولة. ومن هنا، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الحسابات ترتبط بشكل وثيق بتركيبة الحكم والتحولات الداخلية والخارجية التي تمر بها كل دولة على حدة.
• الإمارات: رائدة مسار التطبيع
جاء قرار الإمارات بتطبيع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي نتاج دراسة تعكس التحولات الأخيرة في بنية وشكل الحكم داخل الدولة. فقد بدأ التحضير لهذا القرار منذ عام 2008، بالتعاون الوثيق مع الفريق المقرب من إدارة ترامب، وبمساندة لوبيات الضغط المرتبطة بالكيان. ويُفسر هذا السياق تبرير الإمارات للتطبيع في أغسطس 2020، الذي ربطته بتعهّد الكيان بتجميد خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية والأغوار، وتعليق بناء المستوطنات لفترة محددة، وهو ما لم يتحقق فعليًا، ولم يكن تكترث له الإمارات أصًلا. بهذا المعنى، شكّل الاتفاق غطاءً خارجيًا يبرر التوجهات الجديدة لحكام الإمارات.
• السعودية: حسابات معقدة
لا يعدّ قرار التطبيع لدى حكام السعودية سهلاً أو بسيطاً، فهي صاحبة المبادرة العربية عام 2002، ودولة الحرمين الشريفين، وتتمتع بمكانة إسلامية رفيعة، ما يجعل التطبيع قرارًا لا يمكن اتخاذه من دون دراسة متأنية للتداعيات. كما أن الحساسيات الداخلية تلعب دورًا كبيرًا، حيث لا ترغب السعودية في المضي قدمًا بالتطبيع من دون مقابل واضح. لذلك، تشترط الرياض إبرام صفقة متعددة الأبعاد تشمل ثلاثة عناصر رئيسية: صفقات أسلحة نووية، تكنولوجيا نووية، وتحالف دفاعي مع واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، تضيف السعودية بندًا رابعًا متغيرًا بحسب التطورات، ومرتبطًا بتحقيق أي “إنجاز” للقضية الفلسطينية، بهدف تسويق التطبيع للرأي العام المحلي والإسلامي وتبريره.
• البحرين: تطبيع بالإكراه
لم تكن البحرين من الدول الساعية فعليًا إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. فعلى الرغم من وجود تعاون أمني غير معلن بين الطرفين منذ سنوات، حرصت القيادة البحرينية على التحرك بحذر في العلن، تجنّبًا للاصطدام مع المزاج الشعبي الرافض للتطبيع. لكن الدور المطلوب من البحرين في هذا السياق سلبها هامش القرار المستقل، إذ أوكلت إليها مهمة أداء دور القناة الخلفية للتواصل السعودي – “الإسرائيلي”، بانتظار لحظة مواتية لإشهار العلاقات.
وبالفعل، عقب إعلان الإمارات عن اتفاق التطبيع في 13 أغسطس 2020، وجدت البحرين نفسها أمام ضغوط مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى جانب الإلحاح الأمريكي بقيادة إدارة ترامب. غير أن موجة الرفض الشعبي الواسعة داخل البحرين وضعت السلطات في موقف حرج، ما دفعها إلى التراجع عن توقيع معاهدة سلام شاملة، مكتفية في 18 أكتوبر 2020 بتوقيع “إعلان مبادئ” لإقامة علاقات دبلوماسية، دون الذهاب إلى اتفاق شامل على غرار النموذج الإماراتي.
• قطر: المطبع الخفي
لم تخف الدوحة يومًا انفتاحها على إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي، إذ افتتحت مكتبًا تجاريًا له في عام 1996، وحافظت منذ ذلك الحين على خطوط تواصل مفتوحة بدرجات متفاوتة. هذا الانفتاح كان جزءً من استراتيجية خارجية ترتكز على توظيف الدبلوماسية النشطة والوساطات المتعددة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي. فمن خلال دورها الوسيط بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ومن خلال حفاظها على قناة “حوار سياسي” مع تل أبيب، تمكنت قطر من تقديم نفسها كطرف “محاور” مقبول لدى مختلف الأطراف. ورغم أن هذا الدور يبرر غالبًا بالاعتبارات الإنسانية والسياسية، إلا أنه يصب في نهاية المطاف ضمن هيكل يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
• عُمان: موقف حذر
تتسم مقاربة سلطنة عُمان تجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بالتذبذب والحذر، في ظل محاولة دائمة للموازنة بين البراغماتية السياسية والثوابت المعلنة. فقد شكل استقبال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسقط عام 2018، في عهد السلطان الراحل قابوس، مؤشّرًا على “انفتاح نسبي” من جانب السلطنة على الانخراط في قنوات تواصل غير معلنة مع تل أبيب. إلا أن هذا الانفتاح لم يتحول إلى خطوات تطبيعية رسمية، خاصة في ظل تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة، الذي أظهر تحفظاً أكبر في هذا الملف. ورغم ترحيب السلطنة الحذر بإعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان عام 2020، واعتبارها أن مثل هذه الخطوات قد تساهم في الدفع نحو “سلام عادل ودائم”، إلا أن الموقف العماني ظل مشروطًا بقيام دولة فلسطينية مستقلة كمدخل لأي تطبيع محتمل. بل إن السلطنة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، حين صوّت مجلس الشورى العُماني في عام 2022 لصالح مشروع قانون يُغلّظ العقوبات على أي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون مع الكيان، بما في ذلك تجريم إقامة علاقات سياسية أو تجارية معه. هذا القرار فاجأ تل أبيب، خاصة أنه جاء في وقت كانت تسعى فيه للحصول على موافقة عمانية لعبور الطيران المدني فوق أجواء الدولة الخليجية، ما عكس حالة التردد من ملف التطبيع.
• الكويت: ثبات الموقف
رغم موجة التطبيع، ظلّت الكويت ثابتة في موقفها، محافظة على موقف مبدئي رافض لإقامة أي علاقة مع الكيان الإسرائيلي قبل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقد جدّدت القيادة الكويتية تأكيد هذا الموقف في أكثر من مناسبة، سواء عبر بيانات رسمية، أو من خلال مواقف البرلمان الذي شكل جدار صدّ أمام أي محاولات للتقارب مع الكيان. وقد لعب المجتمع الكويتي ونقاباته كذلك دورًا أساسيًا في ترسيخ الموقف المناصر للقضية، ومقاومة التطبيع بجميع أشكاله، بما في ذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية ورفض المشاركة في فعاليات دولية يشارك فيها ممثلون عن الكيان. ورغم الضغوط الأمريكية المتواصلة، والإغراءات الأمنية والاقتصادية، واصلت الكويت تمسّكها بالثوابت الفلسطينية، لتبقى الاستثناء الخليجي البارز الرافض للانخراط في تيار التطبيع.
ما ورد أعلاه ضروري لفهم السياق الذي تشكّلت في إطاره مواقف دول الخليج من العدوان الإسرائيلي على غزة، كما يساعد في تفسير الهامش الذي تحركت ضمنه كل دولة، وفقًا لحساباتها الخاصة وتعقيداتها الداخلية والخارجية.
لا شك أن عملية “طوفان الأقصى” مثّلت صفعة قوية لدول التطبيع، واللاهثة منها خلف هذا المسار. فقد شكلت الامتحان الأوضح لمدى قدرتها على التوفيق بين مصالحها مع الكيان الإسرائيلي، وما تدّعيه من مواقف داعمة للقضية الفلسطينية. حتى أكثر الدول جهراً بعلاقاتها مع تل أبيب، وجدت نفسها في حالة من الإرباك أمام هول المجازر التي ارتكبها الاحتلال، وأمام ضغط شعبي وإعلامي غير مسبوق.
4. فجوة في الخطاب الخليجي
بعد “الطوفان”، بات من الصعب الزعم بوجود رؤية خليجية موحّدة أو استراتيجية متماسكة تجاه العدوان الإسرائيلي. وإذا كانت مواقف دول التطبيع قد ظهرت أكثر انسجامًا مع رواية الاحتلال، فإن بقية الدول لم تذهب بعيدًا في اتجاه مغاير، إذ بقيت مواقفها محصورة في نطاق الخطاب السياسي والإدانة اللفظية، دون أن تترجم إلى خطوات فعلية على الأرض تدين الاحتلال ومجازر المتنقلة من فلسطين إلى لبنان. كانت مواقف دول الخليج عمومًا متضاربة ومتقلّبة، تعكس حالة من الحرج والارتباك السياسي التي أصابت حكام هذه الدول، وتفضح حالة الغياب الكامل عن جبهة الإسناد للمقاومة، بل إن بعض هذه الدول، ساهمت في محاصرة هذه جبهة المقاومة وتشويه صورتها.
كشفت الحرب على غزة عن غياب أي رؤية جامعة لدول الخليج تجاه أمن المنطقة وتعريف “العدو”، وانعدام “التحرك على قلب رجل واحد” في قضية تعتبر نظريًا “قضية الأمة المركزية”. كما بيّنت أن فلسطين، رغم تكرار ذكرها في قمم البيانات والبيانات الختامية، ليست موضع إجماع فعلي، ولا تمثل بوصلة سياسية موحدة، بل مجرّد ورقة للاستهلاك الدبلوماسي.
منذ اندلاع الحرب، عُقدت أربع قمم عربية شاركت فيها دول الخليج، اثنتان منها على مستوى القمة العربية الإسلامية (الرياض – نوفمبر 2023، والقاهرة – فبراير 2024)، إلى جانب قمتين عربيتين عاديتين. لم تخرج أي منها عن حدود العبارات المكرّرة حول “رفض العدوان” و”الدعوة إلى وقف إطلاق النار”، دون أن تترجم إلى أي خطوات عملية، سواء على صعيد قطع العلاقات مع الاحتلال، أو استدعاء السفراء، أو وقف التبادل التجاري، أو حتى تجميد التعاون الأمني والتقني المتصاعد مع الكيان.
أما الدول غير المطبّعة، فلم توظف ما تمتلكه من أوراق ضغط في المحافل الدولية، ولا حتى في خطوات رمزية يمكن أن تكسر صمت العجز. لم تلوّح باستخدام ملفات الطاقة أو العلاقات التجارية، ولم تتحرك دبلوماسيًا بما يكفي لرفع الحصار أو دعم المقاومة سياسيًا ومعنويًا، ما كشف عن أن غزة خارج حسابات وأولويات هذه الدول.
ورغم الترويج المتواصل منذ بداية العدوان للمساعدات الإنسانية، لم تحدد مسارات فاعلة لوصولها، ولم تمارس ضغوط جادة لتمريرها إلى داخل القطاع المحاصر. ظلت صور الشحنات المكدّسة على الحدود أداة للتسويق الإعلامي، لا أثر لها في تغيير الواقع الإنساني الكارثي، الذي يتفاقم يومًا بعد يوم.
5. مواقف متباينة من القضية
وهكذا، كان الموقف العربي عمومًا، والخليجي تحديدًا، مخزيًا وضعيفًا، يعكس حجم الفجوة بين الخطاب والممارسة، وبين ما يقال في العلن وما يدار في الغرف الخلفية. فبينما كانت غزة تحاصر وتباد، كان بعض العرب يقدّم أوراق اعتمادهم الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب: مرحلة تطبيع بلا أقنعة.
• السعودية والإمارات والبحرين: مسارين برؤية واحدة
بالرغم مما يبدو من تباين شكلي في المواقف بين السعودية والإمارات تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن مراجعة معمّقة للمواقف الرسمية، والمسارات الدبلوماسية، والمضامين الإعلامية، تكشف عن تقاطعات استراتيجية واضحة، تنظر إلى هذه الحرب لا بوصفها مأساة إنسانية، بل كفرصة ثمينة لإضعاف محور المقاومة، وإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة على نحو يخدم تحالفاتها مع الغرب، وأولوياتها الإقليمية.
منذ اللحظة الأولى للعدوان، تبنّت الإمارات خطابًا منحازًا بوضوح لرواية الاحتلال، حيث سارعت إلى إدانة عملية “طوفان الأقصى”، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير”، في وقت كانت فيه المجازر الإسرائيلية قد بدأت فعليًا في غزة. لم تكتف أبوظبي بالإبقاء على علاقاتها مع الاحتلال، بل أكدت على لسان مسؤوليها أن التطبيع “خيار استراتيجي طويل الأمد”، وأن الحرب لن تغيّر في جوهر هذه العلاقة شيئًا، بل على العكس، شهدت الشهور الأولى للعدوان توسيعًا في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي بين الجانبين.
وقد سارت البحرين على نفس النهج، إذ أدانت هجوم حماس وتبنّت خطابًا عدائيًا تجاه حركات المقاومة التي خاضت معركة الإسناد دعمًا لغزة، محافظة على علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. بل تجاوزت ذلك إلى قمع الأصوات الداخلية، فحظرت التظاهرات المؤيدة لفلسطين والمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال، وراقبت المحتوى الإلكتروني، وشنت حملات اعتقالات ومحاكمات أسفرت عن صدور أحكام بالسجن بتهم دعم القضية الفلسطينية، مما يعكس عمق الانقسام بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه ملف التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.
في المقابل، تبنّت السعودية خطابًا أكثر حذرًا. أوقفت مفاوضات التطبيع في مرحلة أولى، قبل أن تعاود استئنافها بصيغة أكثر تحفظًا. وقد أكدت في أكثر من تصريح رسمي على تمسكها بـ”حل الدولتين” شرطًا للتطبيع، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، من دون أن تترجم هذه المواقف إلى ضغط فعلي. وهكذا فإن الرياض فضّلت التريّث السياسي، على أمل تحصيل أثمان استراتيجية لاحقة في ملفي النووي والتحالفات الدفاعية.
ورغم هذا التباين في الأسلوب، فإن كلاً من الرياض وأبوظبي امتنعتا عن ممارسة أي ضغط سياسي أو اقتصادي فعّال لوقف المجازر في غزة. واكتفتا بتحركات دبلوماسية خجولة، وزيارات محسوبة لعواصم إقليمية كطهران، هدفها ضبط إيقاع التصعيد، ومنع اتساع رقعة المواجهة إلى أراضيهما.
أما إعلاميًا، فقد جاء الأداء انعكاسًا دقيقًا لهذه الرؤية الرسمية. ركّزت الرواية الإعلامية على شيطنة فصائل المقاومة، وتوجيه اللوم إلى حماس باعتبارها “المسؤولة عن تعقيد المشهد”، و”المغامرة بأرواح المدنيين”، فيما تجاهلت الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال. بدا واضحًا أن الهدف من هذه الرواية هو تبرير الخذلان العربي، وتجميل موقف أنظمة التطبيع، عبر تسويق سردية “دعم السلام” ورفض “التصعيد”، وتقديم مواجهة المحتل على أنها انتحار سياسي، يصب في صالح “مشروع إيراني توسّعي” في المنطقة. وقد انخرطت وسائل الإعلام الخليجية في الترويج لمخطط التهجير، باعتباره “درءًا للأذى”، لا جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان.
• قطر: انحياز ضمني
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، برزت قطر كلاعب دبلوماسي نشط، مقدّمة نفسها كوسيط محايد يسعى لوقف الحرب. غير أن تحليلًا معمقًا لدورها الإعلامي والسياسي يكشف عن تناقضات واضحة بين الخطاب المعلن والسلوك الفعلي.
تفاخر الدوحة بوساطتها بين حماس وإسرائيل، مؤكدة على لسان مسؤوليها أنها “وسيط نزيه مشهود له دوليًا”، لكن هذه الوساطة لم تُترجم إلى ضغوط حقيقية على الاحتلال لوقف المجازر الإسرائيلية، بل بدت في كثير من الأحيان متماهية مع الأجندة الأمريكية ومن خلفها الصهيونية، حيث استخدمت الهدن كأداة لإدارة التصعيد لا لإنهائه.
استخدمت قطر امبراطوريتها الإعلامية – قناة الجزيرة – لتوجيه رواية الحرب. استفردت بالتغطية والمشاهد الدماء والتهجير والدمار، وحتى برواية الضحايا، فكانت تنقل من قلب الحدث، ولكنها تجيّر الاحداث وفق سرديتها. وقد ظهرت المفارقة في نسختها الإنكليزية، التي ظهرت بموقف المحايد الرمادي، ما كشف عن ازدواجية المعايير وتوظيف الإعلام لخدمة أجندات سياسية، وهو ما برعت به قطر أيام ما يعرف بالربيع العربي.
• الكويت وعُمان: صمت مخيّب
رغم أن الكويت تُعد من الدول الخليجية التي تُظهر دعمًا رسميًا للقضية الفلسطينية عبر البيانات والتصريحات، إلا أن هذا الدعم ظل محدودًا في نطاق الخطاب السياسي، دون أن يتحول إلى خطوات عملية فعلية تُحدث فرقًا حقيقيًا على الأرض. هذا الموقف يشبه إلى حد كبير الموقف العماني، حيث اقتصرت الإدانات الرسمية على بيانات شكلية لم تتجاوز حدود التعبير الإعلامي، مع غياب أي تحرك ملموس يدعم الشعب الفلسطيني أو يضغط على الاحتلال بشكل فعال.
ثانيًا: كيف دعمت دول الخليج العدوان على غزة؟
تحوّلت علاقات دول الخليج مع الكيان الإسرائيلي إلى واقع سياسي وأمني واقتصادي متشابك، يتعزز يومًا بعد آخر، في وقت يتواصل فيه العدوان والحصار على غزة. هذا الواقع يفضح التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، والممارسات الفعلية التي تنخرط فيها هذه الدول عبر توثيق التعاون مع الاحتلال.
في السطور التالية، نستعرض ملامح هذه العلاقات بين إسرائيل وكل دولة خليجية على حدة، مع تسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي أسهمت في دعم العدوان، سواء من خلال التنسيق الأمني والتمويل، أو عبر توفير الغطاء السياسي واللوجستي.
1- السعودية
رغم عدم وجود علاقات علنية بين السعودية والكيان الإسرائيلي حتى الآن، فإن التعاون السري بين الجانبين يمتد عبر مجالات متعددة، وتعود جذوره إلى سنوات مضت. هذا التعاون شهد تصاعدًا ملحوظًا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، والساعي الحثيث لإتمام صفقة التطبيع.
وبرغم العدوان المستمر على غزة، لم تتوقف قنوات التعاون بين الطرفين، بل تواصلت في مجالات لها تأثير مباشر وغير مباشر في دعم آلة القتل التي تفتك بسكان القطاع المحاصر. ورغم أن هذا الدعم يجري في الخفاء، فإن تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كشفت مرارًا وتكرارًا عن أهمية الدور الذي تلعبه بعض الدول الخليجية في تعزيز أمن الكيان في المنطقة. فمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال: “إذا نظرت إلى إسرائيل، ستكون في ورطة كبيرة بدون السعودية”، إلى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو الذي صرح أكثر من مرة بأن دولًا عربية تقدّم دعماً خفيًا لكيانه، وأن قادة هذه الدول “يدركون تمامًا أن إسرائيل ليست عدوهم، بل أكبر حليف لهم” و”يتمنون رؤيتنا نهزم حماس”، تتقاطع هذه التصريحات في سياقٍ يكشف أن ما يُدار خلف الكواليس أعظم مما يعلن.
• الدعم التكنولوجي
يُعدّ قطاع الأمن السيبراني والتقنيات الاستخباراتية أحد أبرز الأمثلة وأكثرها دلالة على حجم التعاون المتنامي بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو تعاون وُضعت أسسه مع صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم. ففي تقرير نشرته بلومبيرغ يعود إلى عام 2007، العام الذي تولى فيه ابن سلمان ولاية العهد بعد إطاحة ابن عمه محمد بن نايف، تتكشف ملامح نشأة هذا التعاون وتوسّعه في الخفاء.
أحد الأسماء البارزة في هذا السياق هو شموئيل بار، الذي عمل في المخابرات الإسرائيلية لأكثر من 30 عامًا قبل أن يؤسس شركة “إنتوفيو”، المتخصصة في التنقيب داخل ما يُعرف بالإنترنت الخفي. تعد إنتوفيو النسخة الإسرائيلية لشركة “بالانتير” الأمريكية، وهي شركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوادي السيليكون وتعتبر من رواد الأمن السيبراني العالمي. تواصل مع بار مسؤولون سعوديون أبدوا اهتمامًا بخدمات شركته، وقد بدأ التعاون تحت شماعة “مكافحة الإرهاب” من خلال برنامج يحمل اسم “إنتوسكان” عبر شركة أجنبية وسيطة، بهدف إخفاء التبعة للكيان.
يمثل هذا التعاون جزءًا من توجه خليجي أوسع نحو الاستعانة بالخبرات الإسرائيلية في المجالات الأمنية والاستخباراتية. فقد دخلت عدة شركات إسرائيلية أسواق الخليج، وتمكّنت بعضها من توقيع عقود رسمية مع حكومات المنطقة. من بين هذه الشركات NSO Group، التي طوّرت برنامج “بيغاسوس” الشهير، المستخدم في التجسس على المعارضين والنشطاء.
ومن أبرز شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية التي تعمل داخل السعودية، بشكل غير معلن غالبًا، عبر وسطاء أو شركات أجنبية:
o شركة CyberArk: متخصصة في حماية الهويات الرقمية وتعمل في السعودية ضمن نشاطها الإقليمي.
o شركة Check Point : شركة أمن سيبراني معروفة، تنشط في السعودية لكنها تحقق منها إيرادات محدودة.
o شركة Cybereason: تأسست في تل أبيب ثم نقلت مقرها إلى سان دييغو، وتقدم خدمات لحماية أجهزة نقاط النهاية، وتعمل في السعودية منذ سنوات بدعم من مستثمرها الرئيسي SoftBank.
o شركة Continuity Software : متخصصة في حلول استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث السيبرانية، نقلت مركز عملياتها إلى الكيان، وتعمل في السعودية من خلال موزعين كبار مثل Dell، مستهدفة البنوك والمؤسسات.
إلى جانب شركات أخرى لم يكشف عن اسمها تعمل في السعودية بهدوء، منها شركة مقرها نيوجيرسي وتضم طاقمًا إسرائيليًا، وتدير عملياتها الخليجية من الرياض عبر مدير سابق في “سباير”، وأخرى متخصصة في تدريب الكوادر السعودية على الأمن السيبراني، وقد تأسست في الأراضي المحتلة ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وعيّنت مؤخرًا مدير مبيعات في الرياض.
لكن العلاقة لم تقف عند حدود الأمن السيبراني، بل اتّسعت لتشمل البنية التحتية الحيوية في دول الخليج. فمع سعي السعودية لتطبيق رؤية 2030، وجد الكيان الإسرائيلي موطئ قدمٍ ثابت له داخل المملكة، من خلال شراكات متزايدة مع القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال، استعانت الإمارات بمهندسين إسرائيليين في تنفيذ مشاريع استراتيجية، في حين اعتمدت السعودية على شركات إسرائيلية لإيجاد حلول لأزمة الازدحام في مكة خلال موسم الحج. وامتدت ذلك إلى مجالات أخرى تشمل تحلية المياه، والتقنيات الاستخباراتية، والأمن السيبراني، وكل ذلك تحت الطاولة، عبر شركات وسيطة أو أجنبية.
ما تقدّم من نظرة سريعة إلى قطاع الأمن والتكنولوجيا، لا يعكس فقط عمق العلاقة، بل يُظهر أن هذا التعاون كان في ازدياد مضطرد قبل العدوان على غزة. وآخره في أغسطس 2023، وما كشف عن شراكة بين شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” الإسرائيلية، ومجموعة “أجلان آند بروس هولدينغ” السعودية، لنشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل المملكة. وبرغم العدوان، لم يتوقف التعاون. وكالة بلومبيرغ كشفت عن افتتاح شركة “فلو”، التي أسسها الملياردير الإسرائيلي آدم نيومان، مجمعًا سكنيًا يضم 238 شقة في الرياض، في سبتمبر 2025. وكذلك أسس إسحاق “يتس” أبلباوم، الشريك المؤسس في شركة “ميزما فينتشرز” التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة، مكتبًا عائليًا في الرياض للاستثمار في الشركات السعودية. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة “غلوبس”، فبعد أشهر قليلة من 7 أكتوبر، أعلن توم لوندز، رئيس المبيعات السابق لشركة سايبر آرك في الشرق الأوسط، عن خطط الشركة للتوسع في السعودية.
وبرغم استمرار النشاط المشترك، فقد اشتكت هذه الشركات من فتور في حجم النشاط المشترك بعد 7 أكتوبر. وبحسب غلوبس، فإن الشركات الإسرائيلية العاملة في المملكة شهدت انتكاسة، ورغم ذلك، لا تزال العلاقات التجارية قائمة، وإن كانت على نار هادئة. وتقول غلوبس، “لم تعد إسرائيل جزءًا من التوجه السائد في مجال الأعمال التجارية.. النشاط الإسرائيلي الحالي هو نوع من الجمود للنشاط الذي بدأ قبل عدة سنوات، ولا يمكن القول ان التعاون توقف أو تراجع، بل لم يشهد أي نمو جديد”.
وبعيدًا عن هذا الشكل من أشكال الدعم، يستثمر صندوق الاستثمارات السعودي، وهو الصندوق السيادي الخاضع لسيطرة ولي العهد محمد بن سلمان، أموالًا في شركة ميتا. في عام 2022، استثمر الصندوق أكثر من 7 مليارات دولار في أسهم أمازون وبلاك روك وجي بي مورجان وألفا بت، الشركة الأم لجوجل. وضخ أموالاً أخرى ليزيد استثماراته في شركات ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، وباي بال، وإلكترونيك آرتس. وفي عام 2024، رفع الصندوق السيادي ملكيته في ميتا بلاتفورم، ومايكروسوفت، وإنفيديا. لكن ما الرابط بين هذه الشركات ودعم العدوان؟ الجواب في الحرب الإعلامية التي واكبت العدوان.
تقرير لموقع DropSiteNews كشف عن تعاون وثيق بين شركة “ميتا” وحكومة العدو الإسرائيلية لقمع المحتوى المؤيد لفلسطين على منصّتي فيسبوك وإنستغرام. ووفقًا للبيانات، استجابت “ميتا” لنحو 94% من طلبات الكيان بحذف منشورات منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن إزالة أكثر من 90 ألف منشور، صُنّف 95% منها ضمن فئات “الإرهاب أو التحريض”، واستهدفت في معظمها مستخدمين من الدول العربية. وتأتي هذه التسريبات بعد تحقيق لموقع The Grayzone كشف أن أكثر من 100 موظف حالي في “ميتا” هم جنود أو عملاء استخبارات إسرائيليون سابقون، كثير منهم خدموا في وحدة التجسس الإلكترونية 8200. من أبرزهم شيرا أندرسون، مديرة سياسات الذكاء الاصطناعي في مكتب ميتا بواشنطن، والتي سبق أن عملت في قسم المعلومات الاستراتيجية لجيش الاحتلال.
• تعاون عسكري
هذه العلاقات، تشمل أيضًا المجال العسكري. إذ أبدت السعودية اهتمامًا بشراء صواريخ مضادة للمدرعات من شركة “رافائيل” الإسرائيلية، الرائدة في تصنيع الأسلحة المتقدمة، وعلى رأسها صواريخ “سبايك”. وتُدار هذه الصفقات عبر قنوات غير مباشرة، أبرزها شركة “يوروسبايك” الأوروبية، التي تعمل كوسيط لتسويق منتجات “رافائيل”، أو عبر شركات تابعة أنشأتها الأخيرة، بهدف تصدير السلاح إلى أسواق مثل السعودية دون كشف الهوية الإسرائيلية بشكل مباشر. أما “القبة الحديدية”، المنظومة الدفاعية الإسرائيلية التي طالما تغنت بها تل أبيب، فقد أصبحت مطروحة على طاولة المفاوضات مع عدة دول خليجية – بينها السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان – في صفقة مشتركة مع شركة “رايثيون” الأمريكية.
وفي صفقة لافتة، اشترت شركة “جلوبال ديفنس سيستم” السعودية منظومة صواريخ “تاو” من إنتاج شركة “كلاوسمان”، الفرع الأمريكي لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، وذلك بموجب موافقة وزارة الحرب الإسرائيلية التي تفرض رقابة صارمة على صادرات شركاتها. ولا تتوقف الصفقات عند هذا الحد. فبحسب تقارير متقاطعة، اهتمت السعودية بشراء طائرات إسرائيلية مسيّرة عبر مسارات ملتوية تبدأ من جنوب إفريقيا، حيث يتم تفكيك هذه الطائرات قبل نقلها إلى المملكة لإعادة تجميعها محليًا.
وفي تطور لافت يعزز استمرار هذا التعاون برغم العدوان ومجازر الإبادة، كشفت وزارة الدفاع السعودية في يناير 2025 عن نظام جديد لمكافحة الطائرات المسيّرة، يُعتقد أن مكوناته تشمل تقنيات إسرائيلية. فقد أظهرت الصور رادارات متعددة المهام بنصف كروي (MHR)، يُعتقد أنها من تطوير شركة “رادا” الإسرائيلية – والتي اندمجت لاحقًا مع “ليوناردو دي آر إس”، وتُستخدم في أنظمة ReDrone من إنتاج “إلبيت سيستمز”. تعرف هذه المنظومات بقدرتها على كشف وتحديد الطائرات المسيرة الصغيرة عبر مزيج من الرادارات وأجهزة الاستشعار البصرية واستخبارات الإشارات، بالإضافة إلى أنظمة تشويش لإرباك الاتصالات والملاحة. وقد تم رصد هذا النظام تحديدًا في مقر المجموعة الثالثة للدفاع الجوي الملكي السعودي في تبوك، قرب قاعدة الملك فيصل الجوية. وتُظهر صور الأقمار الصناعية أنه نُشر هناك بين شهري مارس وأبريل من عام 2023.
رغم حساسية هذه الملفات، لا تزال المفاوضات بشأن التعاون العسكري بين السعودية والكيان تدار بسرية تامة. ومع ذلك، تشير المعطيات إلى أن هذا التعاون مستمر ويتوسع بهدوء، خاصة وأن العديد من صفقات تتم تحت واجهة شركات أمريكية. وفي هذا المجال، عدّت صفقة السلاح الأضخم في تاريخ التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة عقب زيارة دونالد ترامب الأخيرة فرصة لانتعاش شركات السلاح الإسرائيلية. الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 142 مليار دولار، تشمل تزويد الرياض بمنظومات تسليح متطورة من إنتاج أكثر من عشر شركات دفاعية أمريكية كبرى، من بينها لوكهيد مارتن، بوينغ، ونورثروب غرومان، وهذا يعني أنه بشكل أو بآخر ستستفيد مصانع السلاح الإسرائيلية من هذه الصفقة، وستحصل على حصة كبيرة من الأرباح.
صحيفة “ذا ماركر” العبرية أشارت في هذا السياق، إلى أن هذا التعاون يشكل أخبارًا جيدة للكيان، حيث “تتابع مؤسسات الدفاع ومصانع السلاح الإسرائيلية تفاصيل الاتفاق بين واشنطن والرياض باهتمام بالغ، لما له من تأثير على موقعها في سلاسل التوريد، إما كمتعاقدين مع الشركات الأمريكية الكبرى أو كمنافسين لها”. كما أن شركات إسرائيلية مثل “رافائيل”، التي تطور منظومة “القبة الحديدية”، تزوّد بالفعل شركات أمريكية كبرى مثل “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان” بمكونات وأنظمة قتالية. ومن هنا، فإن تفعيل الصفقة مع السعودية سينعش أعمال هذه الشركات باعتبارها مورّدًا ضمنيًّا. والمفارقة أن هذه الشركات – وفي مقدمتها رافائيل، إلبيت سيستمز، ورايثيون، هي نفسها التي تزوّد آلة الحرب الإسرائيلية بالسلاح والتقنيات التي تستخدم في الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر2023. وبهذا، تتحول تلك الصفقات من مجرد تعاون تجاري إلى مساهمة غير مباشرة في تمويل العدوان وتعزيز أدوات القتل والإبادة.
• التطبيع عبر الطاقة
ويمتد التعاون بين الكيان والسعودية ليشمل حركة الإمدادات الحيوية التي تساعد على استمرار العدوان، مما يربط البعد الاقتصادي بالبعد العسكري. في 3 إبريل 2025، وبالتزامن مع زيارة ترامب إلى السعودية لمناقشة ضخ تريليون دولار في مشاريع أميركية، أعلن وزير الطاقة في حكومة الكيان إيلي كوهين في واشنطن عن خطة لمد أنبوب نفط من ميناء عسقلان عبر إيلات إلى السعودية.
ومشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا” (IMEC) هو مبادرة تهدف إلى إنشاء شبكة نقل وتجارية تربط موانئ الهند بالاتحاد الأوروبي مرورًا بدول الخليج والشرق الأوسط، لتكون بديلاً لقناة السويس. وتشارك كل من السعودية، الإمارات، الأردن، وكيان الاحتلال بالمشروع الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول عبر إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل خطوط أنابيب للطاقة وطرق شحن حديثة، بهدف تسهيل حركة البضائع والطاقة بين آسيا وأوروبا.
يتضمن المشروع ممرين رئيسيين: الممر الشرقي الذي يربط الهند بالخليج، والممر الشمالي الممتد من الخليج إلى أوروبا عبر الأردن والأراضي المحتلة. في هذا الإطار، تُدرس إمكانية إنشاء أنبوب نفط بطول 700 كيلومتر من السعودية إلى إيلات، لينقل النفط عبر خط إيلات – عسقلان إلى البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا. يعزز هذا المشروع الدعم اللوجستي والاقتصادي للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، عبر تسهيل إمدادات الطاقة والسلاح من خلال ممرات حيوية، ما يجعله جزءًا فاعلًا في البنية التحتية التي تمكّن الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة.
• دعم الاستيطان
في وقتٍ لا يزال الدم الفلسطيني يسفك، تتكشف مزيد من الحقائق حول انخراط دول عربية في مجازر الإبادة المستمرة. تحقيق استقصائي لموقع Middle East Eye البريطاني كشف في مارس 2025، عن تورط السعودية والإمارات وقطر في تمويل شركات إسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بأنشطة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وذلك من خلال استثمارات ضخمة ضُخت في شركة “أفينيتي بارتنرز” التي يرأسها جاريد كوشنر، صهر ترامب. هذه الشركة، التي أُنشئت عام 2021، باتت تلعب دورًا محوريًا في تمويل اقتصاد الكيان، حيث استثمرت مؤخرًا في شركة “فينيكس المالية” الإسرائيلية، عبر شراء حصة تقدر بنحو 10% من أسهمها.
الخطير في الأمر أن شركة فينيكس مدرجة ضمن قاعدة بيانات الأمم المتحدة التي توثق الشركات المتورطة في دعم الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتمتلك حصصًا مباشرة في 11 شركة إسرائيلية تعمل في عمق المستوطنات، وتتنوع هذه الشركات بين بنوك وشركات اتصالات وبناء وطاقة وحتى أسلحة ومواصلات ومتاجر. من بين هذه الأسماء نجد بنوكًا كبرى مثل بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك ديسكاونت، التي تموّل مشاريع توسعة المستوطنات، إلى جانب شركات اتصالات مثل “سيلكوم” و”بارتنر” التي قامت بتركيب أبراج هواتف محمولة في المستوطنات، بالإضافة إلى شركات بناء مثل “إليكترا” و”شابير” التي شاركت في تنفيذ مشاريع إنشائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الدول الخليجية الثلاث كانت حاضرة في تمويل هذا المسار عبر استثمارات سيادية ضخمة. السعودية قدمت عبر صندوق الاستثمارات العامة تمويلًا بلغ ملياري دولار لشركة “أفينيتي بارتنرز”، وهو ما جعلها من أكبر الداعمين لها. هذا الاستثمار تم توجيهه إلى شراء حصة مباشرة في فينيكس، مما يجعل المال السعودي متورطًا فعليًا في تمويل الشركات العاملة داخل المستوطنات. الإمارات من جانبها لم تكن بعيدة عن هذا المسار، فقد شاركت عبر أدواتها الاستثمارية الرسمية في تمويل شركة كوشنر، وذلك ضمن استراتيجية ما بعد اتفاق التطبيع لتعزيز نفوذها الاقتصادي. أما قطر، ورغم مواقفها العلنية التي تظهر دعمًا للفلسطينيين، فقد أشار التحقيق إلى أنها من بين الدول التي ساهمت في تمويل أفينيتي بارتنرز، ما يعني انخراطها بشكل غير مباشر في دعم مشاريع استيطانية.
بهذا الشكل، تسهم السعودية والإمارات وقطر في دعم مشاريع التهويد وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال استثماراتها في شركات تعمل على توسيع المستوطنات ودعم الاحتلال، مما يجعلها شريكًا في استمرار العدوان، رغم المواقف العلنية التي تدعي فيها دعم حقوق الفلسطينيين.
• تمويل السلطة
في ذروة الانهيار المالي الذي تعانيه السلطة الفلسطينية، وتحت وطأة حصار اقتصادي تفرضه حكومة الكيان بأدوات “المقاصة”، أعلنت السعودية في يونيو 2025، عن تقديم دفعة مالية جديدة بقيمة 30 مليون دولار، سلمت لوزير المالية عمر البيطار عبر القائم بالأعمال في السفارة السعودية بعمان، محمد مؤنس، الذي قال إن التمويل يأتي ضمن “حرص المملكة على تمكين السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية”، مشيرًا إلى أن السعودية قدمت نحو 5.3 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، تحت عناوين “مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية”.
لكن المساهمة الأخيرة لا يمكن قراءتها خارج سياق سياسي واقتصادي مركب، فالسلطة منذ نوفمبر 2021، عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، ومع استمرار العدوان وتداعياته، باتت هذه الأزمة المالية المتواصلة من العوامل التي تهدد استقرار الضفة الغربية ومكانة السلطة نفسها، وهو ما لا مصلحة إسرائيلية فيه.
وبالتالي هذا التوازي بين التمويل والدفع باتجاه التطبيع يشير إلى ما هو أبعد من المساعدة المالية، ليكشف عن منطق “الدعم مقابل التقييد”، حيث يُستخدم المال كأداة لإعادة هندسة السلوك السياسي الفلسطيني ضمن منظومة إقليمية تطوي القضية الفلسطينية في إطار تفاهمات دولية أوسع.
• مجالات أخرى
بالإضافة إلى دور السعودية في دعم الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تكشف الصحافة العبرية عن أبعاد أوسع للتداخل الاقتصادي بين السعودية والكيان الإسرائيلي، تتجاوز المجال العسكري لتصل إلى قطاعات الترفيه والثقافة. فقد أشارت صحيفة “كالكليست” العبرية في ديسمبر 2024 إلى وجود لقاءات بين ابن سلمان ورجل الأعمال الإسرائيلي-الأمريكي حاييم سابان، أحد أبرز داعمي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الذي يمتلك حصصًا كبيرة في شركات إعلامية أمريكية وإسرائيلية. يأتي هذا التعاون في إطار “رؤية السعودية 2030″، ما يعكس محاولة السعودية دمج رأس المال الإسرائيلي في مشاريع تنموية متعددة الأبعاد، رغم استمرار العدوان على غزة.
على صعيد آخر، يظهر التغلغل الإسرائيلي في الخليج من خلال تصريحات رجل الأعمال الإسرائيلي إيريل مارغاليت، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الإمارات والبحرين، حيث أعلن في مؤتمر تقني بنيويورك في سبتمبر 2024 عن وجود مكاتب لشركاته داخل السعودية. هذا الكشف يرفع الستار عن طبيعة التعاون الاقتصادي بين الرياض وتل أبيب، ويبرز حجم الارتباطات التقنية والاستثمارية التي تتيح اختراقًا واسعًا في السوق السعودية.
• الدعم الإعلامي
منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، برز الدور الإعلامي السعودي كأحد الأدوات الفاعلة في تهيئة الرأي العام المحلي والعربي لتبنّي سردية تتماهى بشكل لافت مع الرواية الإسرائيلية. الإعلام السعودي، سواء عبر القنوات الرسمية مثل قناة “العربية” وصحيفة “الشرق الأوسط”، أو عبر الذراع الإلكترونية الممثلة في الحسابات الموجهة والذباب الإلكتروني، انخرط في حملة تغطية مركّزة وممنهجة، غلب عليها طابع التشويه والتبرير والتحريض.
أولى ملامح هذا الدور كانت في توحيد الرسالة الإعلامية على مختلف المنصات، حيث تمّ تبنّي مصطلحات ومضامين تعيد تأطير المشهد لصالح الاحتلال. تم استبعاد مفردات مثل “الشهيد” و”العدوان” واستُبدلت بأخرى محايدة أو متماهية مع الخطاب الاسرائيلي، مثل “رهائن” و”الرد الإسرائيلي”، مع تحميل حركة حماس وحدها مسؤولية التصعيد، في تجاهل تام لسياق الاحتلال المتواصل منذ عقود، وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين.
توازى هذا مع جهود مكثّفة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، حيث صوّرت على أنها أداة بيد إيران، وأنها لا تعبّر عن تطلعات الشعب الفلسطيني. وجرى التعامل مع “طوفان الأقصى” باعتباره مغامرة عسكرية غير مسؤولة جرّت الويلات على غزة، دون التطرق لسنوات الحصار والمجازر الإسرائيلية. في المقابل، تم الترويج لخيار “السلام” والتطبيع وحل الدولتين، كطريق “عقلاني” بعيد عن “فوضى السلاح”.
لم يكن الخطاب الإعلامي وحده، بل كان للذراع الإلكترونية دور فعّال في هذه المعركة، إذ لعب الذباب الإلكتروني السعودي دورًا متقدمًا في تثبيت الخطاب الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أطلقت حسابات وهمية وآلاف التغريدات التي تهاجم المقاومة والفلسطينيين عمومًا، عبر وسوم مثل #فلسطين_ليست_قضيتي و#حماس_لا_تمثلني، إضافة إلى شيطنة التظاهرات المؤيدة لغزة واتهامها بتنفيذ أجندات خارجية. وتقف خلف هذه الحملات الممنهجة أجهزة سيبرانية مرتبطة مباشرة بديوان ولي العهد، يقودها سعود القحطاني.
هذا الخطاب وجد صدى لدى الإعلام الإسرائيلي نفسه، حيث أشادت وسائل إعلام إسرائيلية مثل “إسرائيل بالعربية” بمقالات سعودية هاجمت حماس ودافعت عن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، واعتبرتها مؤشراً على “تغيّر جذري في الوعي العربي”. هذا التناغم الإعلامي لم يكن مصادفة، بل تجلٍّ واضح لتكامل الأدوار بين الطرفين في إطار تقارب سياسي مستتر.
في المحصلة، لم يكن هذا الانخراط الإعلامي السعودي حدثًا معزولًا، بل كان غطاءً إعلاميًا لتواطؤ سياسي متكامل. فالرسالة الإعلامية المنسقة أتت في وقت كانت فيه الرياض تواصل خطواتها نحو التطبيع، وتكثف تعاونها الاقتصادي والعسكري مع تل أبيب. وفي الوقت الذي قُصفت فيه البيوت على رؤوس الأطفال في غزة، كانت الشاشات السعودية تبث حفلات موسيقية، وتشيطن أي تضامن شعبي، وتروّج لخطاب تطبيعي ناعم. بهذا الشكل، لم يكن الإعلام مجرد أداة لنقل المعلومة، بل شريكًا مباشرًا في حرف البوصلة، والتلاعب بالوعي.
2- الإمارات
• الدعم الاقتصادي
منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات منصة إقليمية رئيسة لتوسع تجارة كيان الاحتلال، لا سيما بعد اختيار دبي مركزًا لتوسيع نشاط الشركات الإسرائيلية. وقد فتحت نحو 600 شركة إسرائيلية فروعًا لها في الإمارات، وركزت على مجالات استراتيجية مثل الأمن و”الدفاع”، التكنولوجيا المتقدمة، المناخ، والصحة، بهدف تعزيز حضورها في “مركز دبي” والاستفادة من بيئة الإمارات الاقتصادية المفتوحة. كما انطلقت هذه الشركات من الإمارات نحو أسواق أوسع في الخليج، بما في ذلك السعودية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية معها، في إطار خطة إسرائيلية لرفع صادراتها إلى تريليون دولار خلال 15 عامًا، مع تركيز خاص على اختراق أسواق شبه الجزيرة العربية.
مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، ورغم تصاعد المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والدعوات الشعبية لمقاطعة الاحتلال اقتصاديًا، أظهرت البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء المركزي في حكومة الكيان زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين الاحتلال وخمس دول عربية خلال فترة الحرب (من أكتوبر 2023 حتى نهاية مايو 2024). حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نحو 2.84 مليار دولار، بزيادة واضحة عن نفس الفترة في العام السابق. وبلغت الصادرات العربية إلى الاحتلال 2.017 مليار دولار، بزيادة قدرها 77 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الكيان من هذه الدول بمقدار 151 مليون دولار لتصل إلى 825 مليون دولار.
برزت الإمارات كأكبر شريك عربي اقتصادي للاحتلال خلال فترة العدوان، فاستحوذت على أكثر من 81% من إجمالي الصادرات العربية، بقيمة 1.641 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير عن باقي الدول المطبعة أو المقيمة لاتفاقيات “سلام” مع الاحتلال، مثل مصر، الأردن، المغرب، والبحرين. كما كانت أبوظبي أيضًا الأكبر من حيث الواردات من الكيان، ليصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العدوان على عزة إلى 2.014 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة تحليلية للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أن الإمارات تصدرت المشهد التطبيعي عربيًا بين 2020 و2023 في ثمانية مجالات رئيسية: الاقتصادي والتجاري، السياسي، الدبلوماسي، الأمني والعسكري، السياحي، الثقافي والتربوي، الرياضي، والعلمي والتكنولوجي. فقد سجلت الإمارات أعلى عدد من حالات التطبيع في المجال الاقتصادي (56 حالة)، والسياسي (24)، والدبلوماسي (18)، إلى جانب اختراقات في المجالات الثقافية والتربوية (13)، والعلمية والتكنولوجية (12)، والعسكرية (7). وحصلت الإمارات على أعلى مؤشر كلي لنشاط التطبيع بين الدول العربية (9.12 نقطة)، تلتها البحرين (7.30) والمغرب (6.06). أما السعودية، ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، فقد سجلت مؤشرًا هو الأعلى بين الدول التي لم توقع اتفاقيات سلام علنية، ما يشير إلى توسع التطبيع غير الرسمي.
تؤكد هذه البيانات أن الإمارات لم تكتفِ بالتطبيع الرسمي فقط، بل تحولت إلى منصة مركزية لتغلغل الاحتلال في المنطقة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، متجاوزة بذلك حتى الدول التي سبقتها في توقيع اتفاقيات سلام.
فيما كشفت تحقيقات عن استمرار تدفق المنتجات العربية التي تحمل علامة “الكوشر” إلى الكيان، رغم الحرب ودعوات المقاطعة. شملت هذه المنتجات علامات تجارية كبرى في الإمارات مثل “البركة للتمور” و”هانتر فودز”، إلى جانب منتجات من شركات عربية، كشركة “درة” السعودية التي تورد السكر إلى الكيان.
• رفع الحصار
ضمن مسعى لتجاوز الحصار اليمني المفروض على كيان الاحتلال ضمن معركة الإسناد لغزة، قدّمت الإمارات خدمات استراتيجية متقدمة تمثّلت في تفعيل المشروع اللوجستي الأكبر، من خلال تشغيل جسر بري يربط موانئ دبي بميناء حيفا، عابرًا الأراضي السعودية والأردنية، متجاوزًا قناة السويس وملتفًا على الحظر اليمني في البحر الأحمر.
تولّت تشغيل هذا الجسر شركة “PURE Trans FZCO” الإماراتية، بالشراكة مع شركة “تراكنت” الإسرائيلية، ما أسهم في تقليص زمن الشحن من أسبوعين إلى أربعة أيام فقط، وتوفير أكثر من 80% من الوقت مقارنة بالخطوط البحرية التقليدية. وقد دفعت هذه التطورات صحيفة “معاريف” إلى وصف هذا الخط بـ”الرئة الوحيدة التي تنفّس منها الكيان في ظل الحصار البحري الذي فرضته العمليات اليمنية”.
يعود هذا المشروع إلى مبادرة إسرائيلية طُرحت عام 2017 تحت اسم “الطريق من أجل السلام الإقليمي”، لكنه تحوّل إلى واقع عملي بعد توقيع اتفاقيات التطبيع، وبدعم لوجستي مباشر من مؤسسات إماراتية كبرى مثل “موانئ دبي العالمية” و”طاقة أبوظبي”.
اكتسب هذا الجسر البري أهمية بالغة كونه مثّل مسار إمداد بديلًا وفعّالًا لتجاوز الحصار الذي فرضته حكومة صنعاء، حيث سارت الشاحنات من ميناء جبل علي في دبي، مرورًا بالأراضي السعودية والأردنية، وصولًا إلى ميناء حيفا. وقد سلك المشروع مسارين رئيسيين: الأول انطلق من دبي مرورًا بالرياض ثم عمّان وصولًا إلى حيفا، على امتداد 2550 كيلومترًا، استغرق اجتيازه نحو 93 ساعة. أما المسار الثاني، فانطلق من المنامة، ومرّ عبر السعودية والأردن ليصل إلى حيفا، على مسافة 1700 كيلومتر خلال 50 ساعة فقط.
وقد ساهم هذا المشروع في تفادي أزمة اقتصادية حادة كادت أن تضرب كيان الاحتلال، بعدما تسبّبت الهجمات اليمنية في تهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر. إذ إن اضطرار الكيان لتحويل مسارات السفن كان سيُطيل زمن الشحن من سبعة أيام إلى خمسين، ما كان سينعكس على شكل ارتفاع حاد في أسعار المنتجات، واختناقات في سلاسل الإمداد، وتعطيل لقطاعات اقتصادية حيوية.
• صفقات السلاح
تُعتبر دول التطبيع، وعلى رأسها الإمارات، من الركائز الأساسية التي تدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية ماليًا، حيث تسهم استثماراتها بمبالغ ضخمة تمكّن الاحتلال من تعزيز قدراته العسكرية في غزة والقدس والضفة الغربية. وفقًا لتقرير وزارة الحرب الإسرائيلية، فقد استحوذت الدول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع في عام 2022 على نحو 24% من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية، ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، ما يجعلها ثالث أكبر سوق لهذه الأسلحة بعد آسيا والمحيط الهادئ (30%) وأوروبا (29%).
مع تصاعد التوتر في المنطقة، لم يشهد ميزان التسلح تغييرًا جذريًا. يوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن منطقة غرب آسيا استحوذت على 27% من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2020-2024، مع بقاء الولايات المتحدة المزود الرئيس لتلك الأسلحة، خصوصًا لكيان الاحتلال. عربيًا، لن يفسر التوسع في التسلح كاستراتيجية لردع العدوان الإسرائيلي، بل عكس دورًا تكامليًا، حيث ساهمت دول التطبيع بحصة 25% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت الإمارات عن تعزيز شراكاتها العسكرية مع الاحتلال، خاصة في مجال الأسلحة والتقنيات العسكرية المتقدمة. في 2024، كشف موقع Balkan Insight أن شركة Yugoimport-SDPR المرتبطة بالإمارات صدرت أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار إلى الكيان عبر طائرات عسكرية، استخدمت في مجازر الإبادة ضد الفلسطينيين.
ولم يقتصر الدور الإمارات على الاستيراد فقط، بل شمل توريد مكونات متطورة لأنظمة دفاع جوي مثل “باراك”، إلى جانب معدات لطائرات بدون طيار، خوذات طيارين، أنظمة التزود بالوقود جواً، رادارات أرضية ومحمولة، أنظمة عرقلة إطلاق الصواريخ، التصوير الحراري، ومعدات إلكترونية متقدمة، مما يعكس مساعي أبوظبي لترسيخ موقعها كلاعب أساسي في الصناعات العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية.
• التكنولوجيا العسكرية
وإلى جانب صفقات السلاح، شهد التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي تطورًا متسارعًا ومستمرًا قبل اندلاع العدوان على غزة، ولا يزال هذا التعاون يشهد توسعًا متزايدًا في ظل التصعيد الراهن. فقد أظهرت أبوظبي التزامًا واضحًا بدعم وتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي من خلال استثمارات ومشاريع متعددة تخدم المصالح العسكرية والأمنية للجانبين.
في يناير 2025، وعلى الرغم من مجازر الإبادة الصهيونية، أعلنت شركة “إيدج” الإماراتية، الجهة الدفاعية الحكومية، عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في شركة “ثيرد آي سيستمز” الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات الكشف عن الطائرات المسيّرة. وتمتلك “إيدج” حصصًا بارزة في عدد من الشركات العسكرية الإسرائيلية، منها شركة الصناعات الجوية التي تشارك في مشاريع تحويل طائرات “طيران الإمارات” إلى طائرات شحن. كما شهدت أبوظبي، في أغسطس 2024، افتتاح فروع لشركات إسرائيلية رائدة مثل “رافاييل”، التي تعمل على تحويل طائرات الركاب إلى شحن، بالإضافة إلى “البيت سيستمز” المتخصصة في الطائرات المسيّرة وأنظمة الاستطلاع. يأتي هذا فيما تسعى الشركة الإسرائيلية “إيرباص”، الممثلة للإمارات في المنطقة، إلى توسيع نشاطها في السوق الإماراتي، مما يعكس تعميقًا مستمرًا للتعاون في قطاع التكنولوجيا العسكرية.
على صعيد الأمن والاستخبارات، يبرز حجم التغلغل الإسرائيلي في البنى التحتية لدول الخليج، الذي يمتد لسنوات ويستمر حتى اليوم. فقد نفذت شركات إسرائيلية مشاريع ضخمة في الإمارات والسعودية على مدار العقدين الماضيين، مما منحها وصولًا إلى قواعد بيانات حساسة تهدد الأمن القومي لتلك الدول. ومن الأمثلة البارزة مشروع شركة “Logic Industries”، التي يقودها رجل الأعمال الإسرائيلي ماتي كوخافي، والذي نفذته عبر شركته “AGT” السويسرية، حيث تم تركيب آلاف الكاميرات وأجهزة المراقبة المتطورة على طول أكثر من 620 ميلًا من الطرق والحدود الإماراتية.
في مجال الأمن السيبراني، دخلت شركة “XM Cyber” الإسرائيلية، التي أسسها رئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو، سوق الخليج من خلال شراكة مع شركة “Spire Solutions” الإماراتية في دبي. وتعمل XM Cyber بالتعاون مع شركة رافائيل للصناعات العسكرية ضمن ائتلاف يضم عدة شركات إسرائيلية كبرى، مستهدفة قطاعات البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، إلى جانب مجالات الأمن السيبراني. وفي ذات السياق، تبرز شركة “Orpak Systems” الإسرائيلية كمزود رئيس لحلول أتمتة محطات الوقود وإدارة أساطيل المركبات التجارية، حيث نجحت في دخول الأسواق العربية والإفريقية عبر تقنياتها المتقدمة مع إخفاء هويتها الإسرائيلية.
تُعد الإمارات إذًا منصة مركزية للنشاطات العسكرية والتجارية الإسرائيلية، وهو ما تجلى بوضوح في معارض الأسلحة الدولية، لا سيما معرض IDEX2025 الذي أقيم في أبوظبي، حيث شاركت 34 شركة إسرائيلية بارزة، من بينها الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة “هيڤن درونز” المتخصصة في الطائرات المسيّرة، وسط استمرار العدوان على غزة وبحضور بارز من قيادات عسكرية في كيان الاحتلال.
• تمويل الحرب والمرتزقة
شهدت الإمارات دورًا متزايدًا في دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متجاوزة مرحلة الدعم السياسي إلى انخراط عسكري مباشر، وتمويل لوجستي واستخباراتي، فضلاً عن توظيف مرتزقة أجانب ضمن تحالف عسكري معقد بين أبوظبي وتل أبيب.
1. الانخراط العسكري المباشر
منذ بدء العدوان، كشفت منصة إيكاد الاستخباراتية عن رصد أكثر من 20 رحلة جوية سرية متكررة بين أبوظبي وتل أبيب، شملت طائرة خاصة إماراتية من نوع جلوبال 5000 تنقلت بانتظام بين الجانبين، إلى جانب مشاركة طائرات حربية ترفع العلم الإماراتي في غارات على قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية، منها وول ستريت جورنال، بوصول سرب مكون من 12 طائرة هجومية أمريكية من طراز A-10 إلى قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية، الواقعة على بعد 32 كيلومترًا جنوب أبوظبي، بهدف دعم العدوان الإسرائيلي وردع أي هجمات محتملة. كما رجّحت منصة إيكاد استخدام الولايات المتحدة لقاعدة بربرة الإماراتية في إقليم الصومال، جنوب البحر الأحمر، لمواجهة عمليات الإسناد اليمنية ضد الكيان، مما يوسع دائرة التعاون العسكري الإماراتي الإسرائيلي تحت مظلة أمريكية.
2. تجنيد المرتزقة
كشفت مصادر دبلوماسية عن تورط الإمارات في تمويل وإدارة عمليات جلب مئات المرتزقة من دول أفريقية، لا سيما إثيوبيا، بهدف دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حروبه العدوانية على غزة ولبنان. فمنذ أواخر عام 2023، بدأ تدفق ما يقدر بنحو 500 إلى 700 مرتزق إثيوبي، تم تجنيدهم عبر علاقات وثيقة مع الحكومة الإثيوبية.
وتشير المعلومات إلى أن الإمارات مولت شركات أمنية خاصة مثل ريفن وغلوبال سي إس تي التي تخصصت في توظيف المرتزقة، لتكون القوة البشرية الإضافية التي تعزز قوات الاحتلال ضد حركات المقاومة في المنطقة.
في السياق نفسه، تم نشر قوات إسرائيلية في قواعد عسكرية إماراتية في اليمن، منها جزيرتا سقطرى وميون، بحسب ما أكد المقدم الإماراتي أحمد البلوشي عبر منشور رسمي، ضمن تحالف مشترك بإشراف أمريكي، لتأمين مضائق البحر الأحمر وباب المندب. أتت الخطوة استدعاء أبوظبي وزير الدفاع في الحكومة التابعة للتحالف محسن الداعري لتدارس الخطط العسكرية للرد على قوات صنعاء عن طريق تحريك الجبهات الداخلية في مأرب وشبوة والساحل الغربي والضالع.
3. الدعم المالي
بعد عملية “طوفان الأقصى”، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحويلات مالية كبيرة من كبار المسؤولين الإماراتيين، بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد، وأشقاؤه منصور وطحنون وعبد الله بن زايد، إلى حسابات في مستوطنات غلاف غزة تعويضًا عن عملية طوفان الأقصى.
وبحسب مصادر عبرية، بلغت قيمة التحويلات المباشرة إلى المستوطنين عشرات الملايين من الدولارات، رغم غياب الأرقام الرسمية الدقيقة بسبب اعتماد التحويلات على حسابات فردية. كما دعم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، مبالغ مالية مماثلة لمستوطنين إسرائيليين يقيمون في دبي، مما يعكس أوسع صورة تضامن مالي إماراتي مع الاحتلال خلال فترة العدوان.
4. تسهيلات لوجستية واستخباراتية
سهلت قنصلية الكيان في دبي، بالتعاون مع منظمات محلية، عودة حوالي 220 ضابطًا وجنديًا صهيونيًا عبر رحلات شركة “يسرائير”، بالإضافة إلى 300 جندي احتياطي انضموا لاحقًا إلى العمليات العسكرية على غزة. كما سهلت نقل مساعدات وتبرعات كبيرة من “الجالية اليهودية” في دبي إلى جيش الاحتلال، عبر قنوات القنصليات والسفارات.
وقد نظمت حكومة أبوظبي برامج ترفيهية استفاد منها أكثر من 5000 جندي صهيوني خلال شهرين، حيث أتيحت لهم فرصة قضاء إجازات في الإمارات قبل العودة إلى ميادين القتال في غزة. وقد وثّقت وسائل إعلام وصفحات نشطاء على منصة X صورًا لعدد من هؤلاء الجنود، من بينهم الجندي الصهيوني إيال هكشار، المعروض بتورطه في عمليات قتل وتدمير، وذلك خلال تواجده في دبي لقضاء إجازة ترفيهية.
• التصريحات
تُظهر سلسلة التقارير والتصريحات والتحليلات الغربية والعربية أن الدور الإماراتي في حرب غزة لم يكن محايدًا، بل انحاز بشكل ممنهج وواسع لصالح الاحتلال الإسرائيلي، عبر مزيج من الدعم السياسي، والدبلوماسي، والإعلامي.
1. الدعم السياسي والدبلوماسي
لم تنقطع خطوط التواصل بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي طيلة فترة العدوان الوحشي على غزة، بل استمرت بوتيرة ثابتة وعلنية، رغم حجم المجازر التي ارتكبها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين. ففي الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تفتك بالأحياء السكنية، حل رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، ضيفًا على قمة المناخ “كوب28” في دبي، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وقد ظهر التماهي الإماراتي مع الرواية الإسرائيلية منذ اللحظات الأولى لعملية “طوفان الأقصى”، حين وصفت وزارة الخارجية الإماراتية عمليات المقاومة بأنها “تصعيد خطير”، متجاهلة عقود الاحتلال والقمع. أما في جلسة مجلس الأمن، فذهبت المندوبة الإماراتية ريم الهاشمي إلى ما هو أبعد، مستخدمةً خطابًا منحازًا بالكامل للاحتلال، وواصفةً العمليات الفلسطينية بـ”البربرية والشنيعة”، مطالبة بالإفراج الفوري عن “الأسرى الإسرائيليين”، دون أي إشارة لضحايا غزة أو الأسرى الفلسطينيين.
على خطّ الاتصالات، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتصالًا مع ما يسمى “زعيم المعارضة” يائير لابيد، عبّر فيه عن تضامن بلاده مع الكيان. وضمن هذا الخطاب المنظّم، خرج رئيس لجنة الدفاع والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، ليهاجم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الغرب، واصفًا إياها بـ”خطاب كراهية”، ومعتبرًا أن “إسرائيل وجدت لتبقى”.
2. دور إعلامي موجه لتبرير العدوان
شكّل الإعلام الإماراتي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة ذراعًا ناعمة مكمّلة للموقف السياسي الرسمي، عبر تبني سرديات تبريرية، وترويج روايات الاحتلال، وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، مع تسويق موقف الدولة بوصفه “داعمًا للسلام”. هذا التوجه الإعلامي لم يكن وليد اللحظة، بل تكرّس من خلال مقالات وتحليلات موجهة، وتغطيات خبرية منحازة، وظهور مكثّف لوجوه إسرائيلية وغربية على الشاشات الإماراتية، بما ينسجم مع التوجهات التطبيعية للدولة.
بررت التغطية الخبرية جرائم الاحتلال من خلال المساواة بين الجلاد والضحية، كتبرير اجتياح مستشفى الشفاء بمزاعم أن حماس تتخذ من المرضى دروعًا بشرية، وتناول جريمة قصف المستشفى المعمداني وفق السردية الإسرائيلية. كما تم التعامل مع تهجير سكان غزة، لا سيما من رفح، باعتباره “إجراءً أمنيًا”، بحسب تصريحات نتنياهو التي روجتها وسائل الإعلام الإماراتية.
برز أيضًا الحضور الكثيف لأصوات رسمية من الكيان على قنوات إعلامية مثل “سكاي نيوز عربية”، حيث ظهر المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، ليلقي باللوم على حماس في سقوط الضحايا المدنيين، مكرّسة بذلك صورة الحركة كتنظيم “إرهابي”، لا كحركة مقاومة ضد احتلال مستمر منذ عقود.
في السياق ذاته، انشغلت المقالات الإماراتية بالدفاع عن موقف الدولة إزاء الانتقادات الموجهة لسلوكها خلال العدوان، متحدثة عن “حرب تشويش إعلامي” تتعرض لها أبوظبي، معتبرة ذلك “استهدافًا بسبب موقفها الثابت ضد التطرف”، فيما حاولت مقالات أخرى إظهار موقف الإمارات على أنه “متوازن” و”داعٍ للسلام”، عبر الترويج لنشاطات دبلوماسية وإنسانية تتخللها تصريحات تدعو إلى وقف التصعيد، لتبرير عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال. ومن ضمن تبرير العدوان وتبرير التواطؤ العربي ما ظهر في المقالات التي تناولت العمليات الإسنادية لمحور المقاومة في لبنان واليمن والعراق، فقد اتجه الإعلام الإماراتي نحو تصوير هذه العمليات على أنها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي، وليست ردًا على العدوان أو دعمًا لغزة.
3. منع إدانة الكيان عربيًا وتوفير غطاء دولي
في نوفمبر 2023، طلبت الإمارات من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. الموقف الذي يبدو بطابع إنساني يتناقض بشكل واضح مع دورها الفعلي، حيث برزت الإمارات كمعرقل رئيس لأي قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي بشكل صريح أو تفرض عليه عقوبات. ففي القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بالرياض في نوفمبر 2023، أجهضت أبوظبي تمرير بند العقوبات ضد الكيان. وتجلى هذا التناقض أيضًا في تغاضيها عن الجرائم الإسرائيلية أثناء استضافتها مؤتمر المناخ “كوب 28” في دبي، الذي حضره نحو ألف مسؤول صهيوني، ما شكّل استعراضاً علنياً للعلاقات العميقة التي تجاوزت مجرد التطبيع لتصل إلى شراكة استراتيجية واضحة.
4. اللعبة المزدوجة والواجهة الإنسانية
منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة، حرصت الإمارات على الظهور بمظهر “الفاعل الإنساني” في وجه الكارثة، فأطلقت حملة إغاثية شملت تسيير شاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية، وتفعيل المستشفى الإماراتي لاستقبال الجرحى ونقل بعضهم للعلاج، إلى جانب مساهمات مالية عبر الأونروا. غير أن هذا الجهد الإنساني المزعوم لم يكن سوى واجهة إعلامية مضخّمة، صممت بدقة لتخدم أجندة سياسية واضحة: تقليل الضغط الشعبي والعالمي والإيحاء بوقوف الإمارات إلى جانب الفلسطينيين، فيما كانت في الواقع تواصل تعميق علاقاتها الاستراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي.
الإمارات لم تقدّم إغاثة حقيقية بقدر ما صنعت سردية إعلامية تسوّق لصورتها كـ”شريك للسلام” و”داعمة للقضية”، بينما بقيت مساعداتها محصورة ومحدودة الأثر، بل لم تصل في أغلبها إلى مستحقيها، في ظل استمرار الحصار على غزة دون أي جهد إماراتي ملموس لرفعه أو التوسط لوقف العدوان. وتحوّلت الحملة الإغاثية إلى أداة دعاية سياسية، ربطت بين المساعدات الإنسانية ومحاربة “الإرهاب”، لتُسهم في ترسيخ حصار جديد بأدوات ناعمة. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب والفعل، وصفه المؤرخ الفرنسي جان بيير فيلو بـ”اللعبة الثلاثية”، حيث “تدّعي الإمارات دعم الدولة الفلسطينية، بينما تعمّق تعاونها الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، وتدعم شخصيات فلسطينية مثيرة للجدل كمحمد دحلان في مسعى لتقويض القيادة الفلسطينية الحالية”. ويؤكد فيلو أن صمت أبوظبي عن الجرائم الإسرائيلية، مقابل إظهار محدود للعمل الإنساني، لا يُعد حيادًا، بل شكلًا من أشكال التواطؤ السياسي المحسوب.
1. الانخراط في أعمال تجسسية ضد المقاومة الفلسطينية
لم تقتصر المساهمة الإماراتية في العدوان الإسرائيلي على الدعم العسكري والمالي، بل امتدت لتشمل أعمالًا استخبارية ميدانية مباشرة ضد المقاومة الفلسطينية. وقد انتشر على منصات التواصل وسم “غزة تحت تجسس الإمارات”، كاشفًا جانبًا خفيًا من هذا التعاون، وسط تحذيرات جدية من أنشطة تجسسية تمارس تحت غطاء العمل الإنساني. وكان المستشفى الإماراتي الميداني في غزة موضع شكوك واسعة، حيث أشار نشطاء ومصادر محلية إلى استخدامه كمنصة لرصد تحركات فصائل المقاومة ونقل معلومات لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تحديدًا الشاباك.
وقد أظهرت استطلاعات رأي ميدانية، أن 75% من النشطاء العرب يرون المستشفى الإماراتي منشأة استخباراتية تخدم الاحتلال، خاصة بعد ظهور شواهد على تغلغل الشاباك في دوائر القرار الأمني الإماراتي، بما يعزز فرضية التنسيق الاستخباري بين الجانبين. هذا التورط الخطير يعكس تحوّل الإمارات إلى ذراع أمنية تعمل لحساب الاحتلال في خاصرة المقاومة، تحت ستار المساعدات الإنسانية.
2. التضييق على المتضامنين واعتقالهم
لم تكتفِ الإمارات بالمشاركة في العدوان خارجيًا، بل مارست قمعًا داخليًا ضد أي مظاهر تضامن مع غزة، ضمن سياسة ممنهجة لخنق الصوت الفلسطيني والعربي الداعم للمقاومة. فقد تحدثت مصادر إماراتية متطابقة عن حملات اعتقال طالت عشرات الفلسطينيين والعرب المقيمين في الإمارات، على خلفية منشورات تضامنية مع غزة عبر منصة “إكس”، أو بسبب تعبيرهم عن رفض العدوان الإسرائيلي. كما منعت السلطات أي محاولات لتنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات دعم لفلسطين، مبررة ذلك بذرائع قانونية تتعلق بضرورة الحصول على ترخيص مسبق.
ووصل التضييق إلى منع رفع العلم الفلسطيني في الفعاليات الرياضية والمباريات، حيث أشارت مصادر رياضية وإعلامية إلى تعليمات صارمة تمنع إدخال الأعلام الفلسطينية إلى الملاعب، في تناقض صارخ مع مواقف الشعوب الغربية والعربية التي خرجت في مظاهرات مليونية رفضًا للعدوان. هذا السلوك يعكس حالة تنكّر إماراتي ممنهج للقضية الفلسطينية، ومحاولة حجبها عن الوعي العام، بما يتماشى مع أجندة التطبيع العميق والانخراط الكلي في مشروع إخماد القضية.
• سيناريو ما بعد الحرب
من ضمن الدور الذي لعبته الإمارات، انخراطها في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لفترة ما بعد الحرب، حيث كشفت تقارير صحفية أن حكومة الاحتلال تواصلت مع الإمارات للعب “دور حاسم” في إعادة إعمار القطاع. وفي هذا السياق، أشار موقع Axios في يوليو 2024، إلى أن الإمارات تسعى لأن تكون جزءًا من الحل في غزة، لكن بشرط استبعاد حركة حماس وفصائل المقاومة، بينما تظل لديها تحفظات قوية تجاه القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.
ومع حلول يناير 2025، كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الإمارات ناقشت مع الكيان والولايات المتحدة خلف الأبواب المغلقة إمكانية أن تشرف أبوظبي مع واشنطن إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية. وذكرت المصادر أن أبوظبي دعت في المحادثات إلى ما سمته “إصلاح” السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذي يعارضه الاحتلال. في هذا الإطار، أعلنت الإمارات نيتها إرسال قوات لحفظ السلام إلى القطاع، بينما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومسؤولين غربيين أن مسؤولين إماراتيين اقترحوا الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من القطاع الخاص ضمن قوة حفظ السلام. وقد امتد الدور الإماراتي إلى مشروع تهجير سكان القطاع، حيث مارست ضغوطًا قوية من خلال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، على الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأعضاء الكونغرس الأمريكي للضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين قسرًا.
وقد اتخذ هذا المسعى شكلاً دبلوماسيًا منسقًا، استخدمت فيه الإمارات نفوذها السياسي والمالي لإقناع مصر بلعب دور محوري في تنفيذ خارطة طريق جديدة تتماشى مع الأجندة الإسرائيلية. شملت هذه الخارطة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة تحت إشراف إماراتي-إسرائيلي مباشر، إلى جانب خطة إعادة إعمار تُشترط فيها خطوات تطبيعية واضحة مع الاحتلال. وقد استخدمت الإمارات أدوات الضغط الاقتصادي والدعم السياسي لدفع النظام المصري إلى تبني هذه الرؤية، بل وحملها كرسالة سياسية إلى الدول العربية، تحت تهديد مبطن: “ادعموا خطتنا في غزة أو واجهوا العواقب”.
وفي مايو 2025، شهدت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة تصعيدًا ملحوظًا، عقب اعتراض الإمارات على بندين أساسيين ضمن مشروع دعم موازنة السلطة الفلسطينية. وأسفر هذا التحفظ عن تعديل القرارات النهائية بما يتماشى مع الموقف الإماراتي، الأمر الذي أفرغ عمليًا القرارات المتعلقة بالدعم المالي للسلطة من مضمونها. وقد اعتُبر الموقف الإماراتي اصطفافًا ضمنيًا مع الضغوط الدولية الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية ضمن مخطط لإعادة تشكيل المشهد وفق رؤى تتماهى مع المصالح الإسرائيلية والأجندات التطبيعية الإقليمية.
3- قطر
بدأت اللقاءات العلنية بين الدوحة والكيان الإسرائيلي بعد مؤتمر مدريد 1991، وتسارعت عقب توقيع اتفاق أوسلو، حتى افتتح عام 1996 مكتب تمثيل تجاري رسمي للكيان في قطر، على غرار مكتب مماثل في سلطنة عُمان. حافظت قطر على هذه العلاقة، واعتبرتها رصيدًا دبلوماسيًا مهمًا، خصوصًا لدى واشنطن. شكّل المكتب التجاري سفارة غير معلنة، أتاح توقيع اتفاقيات كان أبرزها بيع الغاز القطري للكيان، وإنشاء بورصة غاز مشتركة في تل أبيب، والسماح لمستوطنيه بدخول قطر بجوازات سفرهم، قبل أن يُغلق المكتب في 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية.
ارتبطت قطر بعلاقة نفعية مع تيار الإخوان المسلمين، ما أسّس لشراكة وثيقة مع حركة حماس على حساب الفصائل الفلسطينية الأخرى. ومنذ 2007، تعزز هذا التحالف بتمويل مباشر وعلني، تم بعلم الكيان الإسرائيلي وموافقته. فتحت الدوحة خزانتها لأجنداتها، وكان مبعوثها محمد العمادي يتولى شخصيًا إدخال الأموال من عمّان إلى القدس وغزة.
بعد عدوان 2014، اتخذ الدعم المالي القطري طابعًا مختلفًا، إذ أقرت آلية ثلاثية بمشاركة قطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة لمراقبة وصول الأموال. دعم الكيان لهذه الآلية لم يكن سريًا، بل كان جزءًا من استراتيجيته لضبط الانفجار في غزة. لكن مع انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، وضعت هذه الأموال تحت المجهر، واتهمت لجنة الرقابة في الكونغرس الدوحة بتحويل 30 مليون دولار شهريًا لحكرة المقاومة حماس، أما رد قطر فكان بأن التمويل هدفه إنساني، وتم تحت تنسيق مباشر مع الكيان.
وعليه، رغم التصريحات العلنية التي تروّج لمواقف داعمة لفلسطين، فإن مسار العلاقات القطرية – الإسرائيلية لم يكن طارئًا أو عابرًا، بل امتدّ لسنوات طويلة وشمل تعاونًا متشعبًا، بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي وتطوّر عبر قنوات سياسية واقتصادية وأمنية. هذا التعاون لم يقتصر على وساطات معلنة أو لقاءات دبلوماسية محدودة، بل تجاوز ذلك إلى شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة، والتجارة، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، وحتى التعاون في مشاريع “إعادة إعمار غزة” التي تم توظيفها سياسيًا كأداة نفوذ للدوحة في القطاع، وضمان استقرار أمني يخدم الاحتلال. فعلى مدار أكثر من عقدين، حافظت الدوحة على خيوط اتصال مفتوحة مع تل أبيب، مكّنتها من لعب أدوار مزدوجة: وسيط في العلن، وشريك فعلي في الخفاء.
• دور الوسيط
تُعد قطر من المستفيدين من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث برزت كوسيط رئيس بين الفصائل الفلسطينية والكيان. سبق أن لعبت الدولة الخليجية الصغيرة هذا الدور في 2010، حين استضافت مؤتمرًا دوليًا أثمر عن صفقة تحرير 1024 فلسطينيًا مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شاليط. استثمرت قطر هذه الصفقة إعلاميًا وسياسيًا، واستضافت المكتب السياسي لحماس على أراضيها للحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة مع قيادات الحركة. كما كانت من أولى دول الخليج التي مهّدت للتطبيع الناعم مع الاحتلال عبر علاقات سرية منذ 1996، وكانت إمبراطوريتها الإعلامية “الجزيرة” من أولى القنوات العربية التي منحت مساحة لمسؤولي الاحتلال.
تعتمد قطر على نهج مزدوج تجاه الكيان. فمن جهة، تنتقد بشدة سياسات الاستيطان والعمليات العدوانية في الضفة والقدس، ومن جهة أخرى، تحافظ على قنوات دبلوماسية نشطة تساعدها في لعب دور الوسيط. من خلال هذه الازدواجية، عززت علاقاتها مع الولايات المتحدة التي تتنافس عليها دول خليجية أخرى، ونجحت الدوحة في بناء علاقات وثيقة مع الغرب، لتصبح موردًا رئيسًا للطاقة، وعميلًا كبيرًا للسلاح الأميركي، وموطنًا لأكبر قاعدة جوية أميركية خارج الولايات المتحدة. وفي عام 2022، حصلت على “كعكة الأسد” عندما أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن حليفًا رئيسًا من خارج الناتو.
بالنسبة لقطر، تُعد القضية الفلسطينية أداة لتعزيز نفوذها الإقليمي. رسميًا، ترفض قطر إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان قبل قيام دولة فلسطينية، لكنها تؤكد في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع جميع الأطراف، مع الحرص على الحفاظ على “التوازن” بدعمها كل من حماس والسلطة الفلسطينية.
وفي ظل غياب خطة واضحة لـ”اليوم التالي” لغزة، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هناك جهة عربية أخرى مستعدة لتحمل مسؤولية إعادة إعمار القطاع. وعلى عكس جهات إقليمية أخرى، تبدي قطر استعدادًا لتقديم مساعدات إنسانية سخية إلى غزة دون شروط أو قيود، وهو موقف يلقى ترحيبًا من الإدارة الأمريكية.
هذا الدور الرمادي الذي تلعبه قطر يضعها في مواجهة مع السلطة الفلسطينية التي تعتبر الدعم المالي القطري المباشر لحماس تحديًا يعمق الانقسامات الفلسطينية. وبالفعل فقد تصاعدت هذه التوترات في أوائل 2025، عندما أعلنت السلطة تعليق بث قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية، متهمة إياها بالتحريض ونشر محتوى مضلل يغذي الانقسامات.
• تطبيع سياسي
بعد أقل من شهرين من بدء العدوان على غزة، حدثت مصافحة بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاحتلال إسحق هيرتسوغ على هامش قمة المناخ في دبي – كوب 28، والتي وصفها الإعلام الإسرائيلي بالتاريخية لما تحمله من مدلولات سياسية واضحة. هذه المصافحة كانت إشارة جلية على أن الجانب القطري لا يعتبر الجانب الإسرائيلي “عدواً”، وأنه مستعد لـ “مدّ اليد” والتواصل معه بشكل مباشر. علاوة على ذلك، شهدت الدوحة عدة جولات تفاوضية شارك فيها مسؤولون إسرائيليون من جهازي الشاباك والموساد، وكانت هذه اللقاءات علنية وبشكل رسمي.
وفي يناير 2025، سجّل لقاء آخر على هامش منتدى دافوس جمع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع هيرتسوغ، الذي أعرب عن شكره لدور قطر في الوساطة. أما التطور الأبرز فكان في المقابلة التي أجراها آل ثاني مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، وهي أول مقابلة له في الإعلام العبري، حيث لم يستبعد خلالها زيارة الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على مسار الأحداث في المستقبل، مؤكدًا أنه لا توجد شروط مسبقة، وأن قطر تسعى لحلول سلمية و”ستفعل كل ما يلزم لإحلال السلام في المنطقة”.
في 31 مارس 2025، تم اعتقال اثنين من مستشاري نتنياهو لاستكمال التحقيقات في قضية “قطر غيت”، التي كشفت عن شبكة تمويل وتأثير قطري معقدة تمتد إلى الإعلام والسياسة داخل الكيان عبر شركة الضغط الأمريكية “ThirdCircle”. لم تقتصر جهود هذه الشركة الممولة من الدوحة على ترويج دور قطر كوسيط في أزمة غزة فقط، بل شملت أيضاً حملة لتشويه صورة مصر وتقويض دورها في جهود الوساطة، بهدف تعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في الملف الإقليمي.
• تمويل سري
في ذروة الاتهامات المتبادلة بين المؤسسة الأمنية وحكومة نتنياهو حول الفشل في 7 أكتوبر، برزت أصوات إسرائيلية توجه إصبع الاتهام إلى رئيس وزراء الاحتلال، باعتباره من سهل تقوية حركة حماس عبر السماح بتمويلها قطريًا خارج الأطر الرسمية. التمويل لم يكن مجرد مساعدات إنسانية، بل تم وفق تنسيق مباشر، شخصي، وسري مع نتنياهو، مقابل ما وُصف بأنه “مكافآت مالية” وشبهات رشى.
الوثائق التي سرّبها معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI)، ضمن ما عرف بـ”مشروع رافين”، كشفت عن منحتين مباشرتين من قطر لنتنياهو: الأولى عام 2012 بقيمة 15 مليون دولار، والثانية عام 2018 بقيمة 50 مليون دولار، تم تسليمهما نقدًا، وفق رسالة سرّية للغاية صادرة عن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني. ووفق الدفعة الثانية من التسريبات، نقلت الأموال إلى نتنياهو عبر جهاز أمن الدولة القطري، بينما تلقى وزير مالية الكيان تأكيدًا رسميًا من الجانب القطري بإنجاز العملية.
لكن هذه التسريبات لم تكن الوحيدة التي فضحت أبعاد المال السياسي القطري في تل أبيب. فقد صرّحت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة في حكومة الاحتلال، أن نتنياهو تلقى تمويلًا قطريًا بلغ 3 ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية. كما كشف موقع جيروزاليم بوست عن تبرع قدره 1.5 مليون دولار من حمد بن جاسم لحزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان. ولم تتوقف تمويلات الدوحة عند هذا الحد، إذ أشار الحاخام المتطرف نير بن أرتسي إلى مبالغ ضخمة قُدرت بـ300 مليون دولار مولت بها قطر جمعيات وأحزاب يسارية في الكيان، في إطار محاولات متوازية لاختراق مختلف الأجنحة السياسية.
التقدير الإسرائيلي لهذا التمويل لم يكن خفيًا. فقد وجّه رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، عام 2020، رسالة شكر مباشرة إلى أمير قطر، مشيدًا بالدور “الاستراتيجي” الذي تلعبه الأموال القطرية في ضمان ما سماه “الاستقرار”. كما أرسل عضو مجلس الأمن القومي، رونين ليفي، رسالة يعترف فيها بالدور القطري في إعادة إعمار غزة، وبتسهيلات مالية تمت تحت غطاء إنساني. بل وقبل أربعة أشهر فقط من عملية “طوفان الأقصى”، وجّه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، رسالة إلى السفير القطري محمد العمادي، يطلب فيها الاستمرار في تمويل مشروع “الغاز لغزة”، مؤكدًا موافقة الكيان على المضي قدمًا في المشروع.
لكن المفارقة ظهرت حين خرج مكتب نتنياهو في مارس 2025 لينفي وجود أي وثائق استخباراتية تؤكد أن المنحة القطرية لغزة استُخدمت في دعم “الإرهاب”، موضحًا أن الأموال القطرية كانت مخصصة لشراء الوقود، ولصرف الرواتب، وتقديم الدعم للعائلات المحتاجة، ليتضح أن هذه المساعدات كانت واجهت قطرية للاستثمار السياسي بأدوات ناعمة.
• امبراطورية إعلامية
إمبراطورية قطر الإعلامية، وعلى رأسها قناة الجزيرة، أدّت دورًا محوريًا في تغطية العدوان على غزة، لكنها مارست تغطية مزدوجة عكست انحيازًا سياسيًا مدروسًا يخدم مصالحها الإقليمية. فقد تبنّت النسخة العربية من الجزيرة خطابًا عاطفيًا منحازًا لحماس والمقاومة، مظهرة تعاطفًا واضحًا مع المدنيين في غزة، بينما التزمت النسخة الإنجليزية بمعايير “الحياد”، مستخدمة مصطلحات مخففة مثل “قتيل” بدل “شهيد”، و”جدار أمني” بدل “جدار فصل عنصري”، كما فتحت شاشاتها بشكل مكثف للمحللين الإسرائيليين، ما بدا كمسعى واعٍ لتسويق رواية الاحتلال لجمهور غربي.
هذا الانفصام التحريري جسّد ازدواجية في عرض الروايات، حيث ساوت التغطية بين طرفي صراع غير متكافئين: المحتل والمقاوم، ومنحت منابر واسعة للمتحدثين الإسرائيليين لتبرير الجرائم دون مساءلة، وهو ما مثّل انحيازًا دعائيًا صريحًا. كما تجاهلت عمدًا جبهة الإسناد المقاومة وتأثيرات إقليميًا، متعمدة تغييب أخبار محور المقاومة ضمن سياسة تحريرية انتقائية تعكس أجندة عرض موجهة ومشبوهة.
في تغطيتها اليومية، ركزت القناة على البعد الإنساني للصراع فقط، متجنبة الخوض في البعد النضالي أو السياسي، مما أفرغ القضية من محتواها التحرري، وحوّل الفلسطيني إلى مجرد ضحية بلا سياق. وزادت من هذا الانحياز اعتمادها شبه الكامل على الإعلام الإسرائيلي كمصدر وحيد في تقييم آثار الحرب داخل الأراضي المحتلة، خاضعة بذلك لرقابة الاحتلال وسرديته. أما في الحوارات والبرامج التحليلية، فقد اتبعت القناة سياسة تحريرية منحازة، من خلال اختيار الضيوف وإدارة النقاشات بشكل يوجه الرأي العام نحو مواقف سياسية بعينها، ما كرس تحيزًا بنيويًا في المحتوى، وانعكس مباشرة على شكل الرواية الإعلامية المتداولة حول العدوان.
• تعاون عسكري
في الوقت الذي تواصل فيه قطر ترويج خطابها الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، تتكشف فصول أخرى من علاقتها المتنامية مع الكيان الإسرائيلي، لكن هذه المرة من بوابة التعاون العسكري، وبصورة علنية مموّهة.
فقد كشفت مجلة “إسرائيل ديفنس” عن عقد بين الدوحة وشركة “إلبيت” الإسرائيلية، حصلت بموجبه قطر على خوذ طيارين متطورة مخصصة لطائرات الرافال الفرنسية التي يمتلكها سلاح الجو القطري. وبيّنت التقارير أن الدوحة اعتمدت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على الكيان كمصدر لقطع غيار حيوية لدباباتها وناقلاتها والعربات المدرعة، ضمن صفقات قُدرت بمبالغ ضخمة سُددت على دفعات.
وتجاوز التعاون حدّ الصيانة إلى التحديث، إذ تسلّحت الطائرات القطرية من طراز “إف-15” بتقنيات طوّرتها شركة “إلبيت”، منها نظام توسيع زاوية الرؤية على الرادار، ما يمنح الطيار تفوقًا قتاليًا جوّيًا. هذه التعديلات، تزامنت مع صفقات متسلسلة لتسليم دفعات من هذه المقاتلات المتطورة للدوحة، مقابل مئات ملايين الدولارات.
وإن كانت هذه الصفقات تمت خلال السنوات الماضية، فإن ما كشفته وسائل إعلام عبرية في يونيو 2025 يؤكد أن هذا المسار متواصل بين الطرفين. وفي التفاصيل، أن عقودًا جديدة أبرمتها قطر مع شركات سلاح إسرائيلية كبرى، من بينها “رافائيل” و”صناعات الفضاء الإسرائيلية”، لتوريد أسلحة وذخائر وأنظمة سيبرانية متطورة، مؤكدة أن قيمة العقود تجاوزت 100 مليون دولار، وأن تنفيذها تم بعد الحصول على موافقات رسمية، وعلى رأسها توقيع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وإلى جانب الدعم التسليحي المباشر، تمددت العلاقة إلى شكل أعمق من التعاون شمل الدعم اللوجستي العسكري، الذي تم تفعيله منذ بدء العدوان على غزة. ففي جسر جوي غير مسبوق، نظّمته الولايات المتحدة، نُقلت عشرات الآلاف من القذائف والصواريخ وأنظمة التوجيه الدقيقة إلى الكيان، تحت غطاء “تعزيز الدفاعات”، وعلى رأسها منظومة القبة الحديدية. هذا الجسر، الذي انطلق من مستودعات أمريكية باتجاه الأراضي المحتلة، مرّ عبر دول عربية، بينها السعودية، البحرين، الأردن، وقطر، التي لم تكن مجرّد محطة عبور، بل نقطة تمركز عملياتيّة.
الدوحة، التي تحتضن قاعدة “العديد” الأمريكية، لعبت دورًا مركزيًا في تسهيل الإمدادات العسكرية. القاعدة، التي تعد المقر الإقليمي الأهم للقيادة المركزية الأمريكية، تحوّلت إلى معبر نشط لإرسال الذخائر والمعدات نحو الاحتلال، مع توثيق ما لا يقل عن 18 شحنة نقلتها الطائرات الأمريكية من هناك إلى داخل الكيان الإسرائيلي، وفق تقارير استخباراتية مفتوحة المصدر نشرتها منصات مثل MenchOsint. بعض الشحنات اتخذت مسارات غير مباشرة، عبر قبرص، لإخفاء وجهتها النهائية وتجنّب الرصد.
اللافت أن هذه التحركات لم تأتِ فقط في سياق التعاون الأمني الأمريكي-الإسرائيلي، بل بموافقة ضمنية من الدوحة، التي لم تُظهر اعتراضًا، بل وفّرت التسهيلات والبنية اللازمة لإنجاح هذا الدعم. الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك كيميت كان واضحًا في وصفه للدور القطري، مشيرًا إلى أن وجود القاعدة على أراضي قطر “جزء حيوي من قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستمرار في عملياته”.
وفي أبريل 2025، وفي وقت كان الدم يُسفك في غزة، شاركت قطر إلى جانب الإمارات والبحرين في مناورة عسكرية مشتركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليونان، في خطوة تعكس عمق التعاون العسكري مع الكيان. هذه المناورة كشفت بوضوح زيف الخطابات الرسمية التي تدّعي دعم القضية الفلسطينية، إذ تتجلى حقيقة التنسيق العملي والتعاون المشترك بعيدًا عن الأضواء، مما يؤكد أن العلاقات تتجاوز التصريحات الدبلوماسية لتصل إلى شراكات استراتيجية فعلية على الأرض.
وفي الوقت نفسه، لا تغيب بصمات شركات السلاح الإسرائيلية عن المشهد، فقد استلمت قطر، على سبيل المثال، طائرات “F-15” الأميركية مزودة بتكنولوجيا من إنتاج شركة “إلبيت سيستمز”، وهي ذاتها التي زودت البحرين بطائرات “هيرمز” التكتيكية. وقد ظهرت هذه الطائرات في تدريبات جوية مشتركة ضمّت الكيان الإسرائيلي، الإمارات، وقطر، في مشهد يعكس مدى التداخل الأمني والعسكري الإقليمي مع الكيان، رغم المجازر المتواصلة في غزة.
بهذا المشهد، تتكشّف صورة أكثر وضوحًا لما وراء الخطاب القطري المُعلن. فالدولة التي تقدّم نفسها كوسيط وراعٍ للتهدئة والمصالحة، باتت وفق الوقائع الميدانية، شريكًا لوجستيًا في آلة الحرب الإسرائيلية، توفّر الأرض، والمجال الجوي، والتسهيلات العملياتية، بينما تحافظ في العلن على سردية الحياد والدعم الإنساني.
4- البحرين
• مأزق التطبيع
تجد البحرين نفسها اليوم في مأزقٍ سياسي وأخلاقي متزايد، مع اتّساع رقعة العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد المجازر بحق المدنيين، في وقتٍ لم تنفكّ فيه علاقاتها الرسمية مع الاحتلال تمضي قدمًا منذ توقيع “اتفاقات أبراهام” في سبتمبر 2020. فالدولة التي سارعت للحاق بالإمارات في فتح السفارات وتوقيع الاتفاقات الثنائية وإطلاق الخطوط التجارية المباشرة مع الكيان، تواجه الآن واقعًا مختلفًا كليًا، تُفرض فيه المواقف على المحكّ، وتُختبر فيه جدّية الخطاب الرسمي في ظل مشاهد الدم التي لا تتوقف.
البحرين، التي تحتضن أكبر قاعدة بحرية أمريكية في المنطقة، وجدت نفسها مقيّدة بشبكة من الحسابات الأمنية والعلاقات الدولية، بينما شعبها ينبض بتأييد صريح وعميق للفلسطينيين. مظاهرات متكرّرة انطلقت في شوارع العاصمة وخارجها، بعضها أمام السفارة الإسرائيلية نفسها، للتنديد بالعدوان والدعوة إلى وقف كل أشكال التطبيع.
• بيانات وقرارات متضاربة
وكه تصاعد المجازر في غزة، حاولت الحكومة البحرينية المناورة بين امتصاص غضب الشارع وتجنّب المساس بجوهر العلاقة مع الاحتلال. أصدر البرلمان في نوفمبر 2023 بيانًا أعلن فيه “تجميد العلاقات الاقتصادية” مع الكيان، وأشار إلى مغادرة السفير الإسرائيلي البلاد، لكن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، لم تعبّر عن تغيّر فعلي في موقف الدولة، خصوصًا وأن البرلمان لا يملك صلاحيات في السياسة الخارجية، ولم توضح الحكومة ما إذا كان السفير طُرد أم غادر بمحض إرادته.
في مواقفها الرسمية، أدانت البحرين عملية طوفان الأقصى، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير”، داعيةً لاحقًا إلى هدنة إنسانية ومساعدات لغزة، من دون أي موقف عملي يوازي حجم الكارثة. وعلى مستوى العلاقة مع الاحتلال، لم تقدم المنامة على أي خطوة حقيقية تعكس مراجعة لمسار التطبيع، فبقيت السفارة مفتوحة، والاتفاقات سارية، والتنسيق الأمني والتجاري مستمرًا.
في المقابل، كان الشارع البحريني ينبض بغضب متصاعد، عبّرت عنه تظاهرات شعبية، وبيانات مناهضة للتطبيع أطلقتها قوى سياسية واجتماعية، على رأسها “المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني”، التي تساءلت عن منع الترخيص لأي نشاط تضامني مع غزة. ولأن الاحتجاجات الشعبية لم يُرخّص منها سوى مسيرة يتيمة في مدينة المحرق، فقد قوبلت هذه التحركات بقمع شديد، فاعتُقل العشرات، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن، ولا يزال آخرون قيد المحاكمة.
• تعاون اقتصادي
اقتصاديًا، ورغم تواضع العائدات المباشرة لاتفاقات أبراهام على البحرين مقارنة بالإمارات، فإن المنامة رفعت من وتيرة انخراطها التجاري مع الاحتلال بشكل لافت خلال الحرب على غزة. فبينما لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 20 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022، سجّلت الأشهر العشرة الأولى من الحرب الجارية قفزة غير مسبوقة في الصادرات البحرينية إلى الكيان، بنسبة فاقت 590%، وارتفاعًا عامًا في التبادل التجاري بنسبة قاربت 950%.
ووفقًا لتقرير “المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق”، احتلت البحرين المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر التطبيع خلال الفترة بين 2020 و2023، مسجلة درجة 7.30 من أصل 10، متقدمة على دول عربية طبّعت منذ عقود، كالأردن ومصر، ما يؤكد أن علاقة المنامة مع الاحتلال تتجاوز ما هو رمزي إلى شراكة نشطة، متعددة الأبعاد، تشمل السياسة والتجارة والأمن، في الوقت الذي لا تزال فيه غزة تحت النار، والدم الفلسطيني لم يجف بعد.
ولا يقف التطبيع الاقتصادي عند حدود التجارة المباشرة، بل امتد إلى التسهيلات اللوجستية. فقد تحوّلت موانئ البحرين إلى محطة إعادة شحن للبضائع الإسرائيلية في ظل التهديدات التي تواجهها سفن الاحتلال في البحر الأحمر. وأظهرت التقارير أن سفنًا من الصين والهند تفرغ حمولتها في ميناء خليفة بن سلمان، قبل أن تُنقل برًا بواسطة شاحنات سعودية وأردنية نحو معبر الملك الحسين، ثم تُدخلها شاحنات إسرائيلية إلى الداخل المحتل، ضمن منظومة تعاون إقليمي صامت لكنه فاعل. وتنوّعت البضائع المنقولة بين مواد غذائية ومنسوجات وألمنيوم وإلكترونيات، ما يعكس اتساع نطاق التعاون رغم تصاعد المجازر بحق المدنيين.
اللافت، أن هذا الانخراط الاقتصادي لم يميّز حتى بين المنتجات الإسرائيلية وتلك القادمة من المستوطنات، إذ أعلنت وزارة التجارة البحرينية صراحة أنها لن تمنع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها “منتجات إسرائيلية”.
وتزامنًا مع تعميق البحرين علاقاتها الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، كان التطبيع عبر مجالات الطاقة يتوسع، إذ أعلنت شركة بابكو إنرجيز البحرينية، في 29 مارس 2025، عن صفقة بارزة في قطاع الطاقة، عبر بيع حصة أقلية في خط أنابيب نفطي يربط السعودية بالبحرين لصندوق تديره شركة “بلاك روك” الأميركية. هذا الخط يبلغ طوله 112 كيلومترًا وينقل النفط الخام من أرامكو السعودية إلى مصفاة البحرين، مما يجعل الصفقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية عالية.
لكن ما يثير القلق هو أن “بلاك روك” ليست شركة استثمارية عادية، فهي منخرطة في دعم مشاريع استيطانية في الأراضي المحتلة، وتلعب أدوارًا مالية في تعزيز المستوطنات وفي تمويل مؤسسات ترتبط بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما أن مؤسسيها وقياداتها من الداعمين العلنيين لكيان الاحتلال.
• التعاون الاستخبارتي
في عمق مشهد التطبيع المتسارع، يبرز التعاون الاستخباراتي بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي كواحد من أكثر أوجه العلاقات تطورًا وخطورة. هذا التعاون لا يُعد تفصيلًا جانبيًا، بل يمثل ركيزة أساسية في مشروع الدمج الأمني بين الكيان وبعض دول الخليج، حيث بدأت ملامحه تتضح منذ توقيع أول اتفاق أمني بين الجانبين خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي السابق بيني غانتس للمنامة في فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، تسارعت الخطى. فوفقًا لتسريبات نشرتها “وول ستريت جورنال”، أشرف الموساد والشاباك على تدريب كوادر من جهاز الاستخبارات البحريني، بالتوازي مع وعود إسرائيلية بتزويد البحرين بتقنيات عسكرية متطورة، مثل الطائرات المسيّرة والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار.
لكن الدعم لم يتوقف عند الحدود التقليدية، بل امتد ليشمل مجالات أكثر تعقيدًا كالأمن السيبراني. في هذا الإطار، أبرمت شركة الهلال للتكنولوجيا البحرينية شراكة مع “سايبر أرك” الإسرائيلية، وهي شركة يقودها خبير في وحدة الاستخبارات العسكرية الصهيونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية للبلاد. وبما أن الهلال تعمل في أسواق خليجية أخرى، فإن هذا التعاون يفتح الباب أمام توسّع النفوذ الإسرائيلي في الفضاء السيبراني الإقليمي.
وفي خطوة تؤكد هذا التوجه، كشفت مصادر أميركية عن اجتماع أمني سري جرى في المنامة، ضمّ رئيس أركان جيش الاحتلال وكبار القادة العسكريين من البحرين والإمارات والسعودية والأردن ومصر، تحت رعاية القيادة المركزية الأميركية. كان هدف اللقاء، بحسب التقارير، تنسيق الرد على ما سُمي بالتهديدات الإيرانية ومحاولة تقويض الدعم الذي تتلقاه غزة من أطراف محور المقاومة في العراق واليمن.
أما دور البحرين فلم تكن مجرد مضيف للاجتماع، بل فاعل أساسي فيه، من خلال تبادل الضباط والمناورات المشتركة، ووجود ضابط إسرائيلي دائم في مقر الأسطول الخامس. ناصر بن حمد، نجل الملك، أكد هذا التعاون خلال مقابلة مع معهد “أسبن” الأميركي، مشيرًا إلى أن بلاده ساهمت في ما سمّاه “جهود كبح الرد الإيراني”، من خلال التنسيق الاستخباراتي والاستطلاع، بالتعاون مع الأسطول الخامس الأميركي، المتمركز في البحرين.
وفي تأكيد على حجم الانخراط العسكري، كشفت “القناة 14” الإسرائيلية أن البحرين كانت من ضمن دول عربية شاركت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في منظومة الدفاع الجوي الإقليمي خلال التصدي للهجمات الإيرانية. وأضافت القناة أن مشاركة بعض الدول أصبحت “مفروضة”، حتى وإن لم تُعلن رسميًا.
• تحالف بحري
في سياق انخراطها المتسارع في منظومة الأمن الإقليمي المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب، سجّلت البحرين حضورًا بارزًا ضمن التحالف البحري الذي أُعلن عنه نهاية عام 2023 تحت ذريعة “حماية الملاحة” في البحر الأحمر. لكن هذا التحالف سرعان ما تبيّن أن وجهته الأساسية هي التصعيد ضد اليمن، لا سيما في ظل تصاعد عمليات أنصار الله في الممرات البحرية الاستراتيجية. هذا الانخراط أثار تحذيرات من المعارضة البحرينية التي اعتبرته تهديدًا مباشرًا للأمن القومي ومغامرة محسوبة لصالح أجندات خارجية.
وفي مشهد يعكس التماهي الكامل مع الأولويات الإسرائيلية، قال ناصر بن حمد آل خليفة، نجل الملك، في مقابلة مصوّرة نُشرت في يوليو 2024، إن بلاده كانت “في الخدمة” ليلة 14 أبريل، حين نفّذت إيران عملية “الوعد الصادق”، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، مشيرًا إلى أن البحرين شاركت في المهام الاستخبارية والاستطلاع بالتنسيق مع الأسطول الخامس الأميركي. واعتبر أن هذه المشاركة تأتي ضمن الالتزامات العسكرية في إطار التحالفات الأمنية القائمة، واصفًا اتفاق “أبراهام” بأنه من أهم إنجازات بلاده، ومشددًا على ضرورة بقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الكيان، رغم مجازره المستمرة.
زيارة رئيسة العمليات البحرية الأميركية، الفريق أول بحري ليزا فرانشيتي، إلى البحرين في 4 يونيو 2024، أكدت هذا التوجه، حيث أعلن صراحة أن بلاده ما كانت لتنجح في التصدي لهجمات أنصارالله في البحر الأحمر دون الدعم البحريني المباشر، واصفًا المنامة بالشريك الأساسي في هذه العمليات.
الخلاصة
منذ 7 أكتوبر 2023، دخل التعاون بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي مرحلة جديدة من الانكشاف، حيث انتقل من كونه تعاونًا محصورًا في قنوات خلفية، إلى شراكات واسعة النطاق تغذي آلة القتل الصهيونية، رغم ما يشهده قطاع غزة من عمليات تطهير عرقي. برز التعاون الأمني والعسكري بوصفه أبرز معالم هذه المرحلة، مع تصاعد التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات حول حركات المقاومة، فضلًا عن انخراط مباشر لبعض دول الخليج في تحالفات إقليمية تستهدف قوى المقاومة وتؤمّن غطاءً للعدوان الإسرائيلي.
في الجانب الاقتصادي، استمر التبادل التجاري بلا انقطاع رغم الحرب، بل شهد نموًا ملحوظًا عبر استثمارات مشتركة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى تطوير مشاريع لوجستية تهدف إلى تجاوز تداعيات عمليات الإسناد اليمنية في البحر الأحمر، ما جعل التعاون الاقتصادي جزءًا عضويًا من استراتيجية الحرب والحصار. كما شهد المجال التكنولوجي تكاملًا متسارعًا في الأمن السيبراني وأنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي، ما عكس تغلغلًا إسرائيليًا في البنية التحتية الرقمية الخليجية.
الإعلام الخليجي بدوره لعب دورًا فاعلًا في تبنّي السردية الإسرائيلية بعد سقوط القناع عن وجه القاتل، في مقابل محاولات مستمرة لعزل حركات المقاومة وتشويهها، بالتوازي مع تنسيق سياسي في المحافل الدولية لتقويض أي تحركات داعمة لغزة خارج الأجندات الصهيوأمريكية. حتى في المجال الإنساني والطبي، جرى التنسيق تحت يافطات الإغاثة، ولكن بخطوط تتقاطع مع مصالح الإحتلال، خاصة في ما يتعلق بإدارة المساعدات وتمريرها عبر قنوات خاضعة لرقابته، لتصبح عمليات الإغاثة وسيلة جديدة للقتل والحصار والتجويع، تنخرط فيها دول عربية.
أما في ما يخص مرحلة ما بعد الحرب، فبدأت بعض دول الخليج بالدخول في مشاورات وتخطيط لمشاريع إعادة الإعمار وفق شروط أمريكية وإسرائيلية، تتضمّن محاولات تشكيل قيادة فلسطينية بديلة وإعادة ترتيب القطاع سياسيًا واقتصاديًا بما يخدم مصالح الاحتلال. بهذا المشهد، يتبيّن أن التعاون الخليجي مع الاحتلال بعد 7 أكتوبر لم يعد محصورًا في ملف أو ظرف مؤقت، بل تحول إلى منظومة شاملة تُستخدم كرافعة لتكريس واقع سياسي جديد، يشرعن الاحتلال ويحاصر خيار المقاومة، ويعيد ترتيب أولويات المنطقة على حساب القضية الفلسطينية.
الخاتمة
تُظهر المراجعة أن دول الخليج تعيش واقعًا مركبًا ومتداخلًا في علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، حيث يتصاعد مسار التطبيع ويأخذ أشكالًا متعددة تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والتعاون الأمني والعسكري، رغم تمسك الخطاب الرسمي بشعارات دعم القضية الفلسطينية. الإمارات تصدرت هذا المسار، محوّلة نفسها إلى بوابة النفوذ الإسرائيلي في الجزيرة العربية، فيما تنتهج السعودية نهجًا أكثر هدوءًا وتريثًا، لكنها تسير فعليًا على طريق التطبيع العملي، بانتظار لحظة الإعلان الرسمي المرتبط بحسابات أمريكية وإقليمية.
أما البحرين، فقد انخرطت بوضوح في تحالفات أمنية مع تل أبيب، متجاهلة الغضب الشعبي، بينما تلعب قطر دورًا مركّبًا، تجمع فيه بين الوساطة الإعلامية والعلاقات السرية، متكئة على موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي لتوازن علاقاتها مع الأطراف كافة. وتبقى الكويت وعُمان استثناءً نسبيًا، إذ ترفضان التطبيع رسميًا، لكن دون خطوات عملية تُعزز هذا الرفض أو تعكسه على السياسات الخارجية، ما يجعل موقفهما أقرب إلى التحفّظ الصامت منه إلى الفعل المؤثّر.
ومع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، تتكشف أكثر طبيعة هذه العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، لا كتحالفات عابرة أو محكومة بالضغوط الدولية، بل كمسارات متجذرة تُراكم في تطبيع بنيوي وعميق، لا توقفه المجازر ولا تمنعه دماء الأطفال. المال الخليجي لا يكتفي اليوم بالاستثمار في اقتصاد الاحتلال، بل بات يغذي آلة القتل بشكل مباشر، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والأمنية، والمشاركة الفعلية في عمليات اعتراض الصواريخ، والتنسيق مع التحالفات المعادية لمحور المقاومة. بل إن بعض الدول الخليجية أصبحت بمثابة خط الدفاع الأول عن الكيان، تحمي أجواءه وتدافع عن أمنه وتُشرف على مسارات الإسناد الجوي والبحري.
وفي المقابل، يبدو موقف هذه الدول من الفلسطينيين باهتًا ومذلًا، لا يتجاوز شاحنات قليلة على المعابر، وإن دخلت، فهي لا تصل إلى مستحقيها، أو تُقيَّد بشروط سياسية وأمنية. كما تسخر الجيوش الخليجية نفسها، تحت ذريعة التنسيق مع واشنطن، لمراقبة المساعدات والتحكم بها، لتتحول في نهاية المطاف إلى شريك في الحصار وفي الجوع، وشريك في الدم الذي يخلط بالخذلان.
في الختام، إن ما تقوم به دول الخليج اليوم أقرب إلى التواطؤ مع الاحتلال منه إلى الحياد. إذ باتت مواقفها محصورة في قمم باردة وبيانات فارغة واجتماعات شكلية، هدفها الأول إخماد نيران الحرب قبل أن تطرق أبواب العروش، إدراكًا منها أن بقاءها معلّق على خيط الدعم الغربي، وأن غيابه يعني زوالًا محتمًا لحكامها وخسارة لشرعيتهم الزائفة.