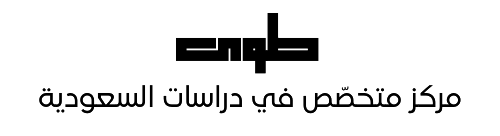السعودية والامارات:حرب باردة… ناعمة

تمهيد
لم يكتب للعلاقات السعودية الإماراتية المؤسّسة في الأصل على متغيّرات خارجية (أي خارج نطاق العلاقات البينية) أو أزمات أملت توافقات واتفاقيات، أن تحافظ على مستوى الوئام الظاهري.
وبمنأى عن الخلافات التاريخية العميقة المتجذّرة بين الرياض وأبو ظبي، والتي تعود الى الأيام الأولى من ولادة الاتحاد الاماراتي، حول قضايا الحدود وتاليًا النفوذ والأدوار والمصالح، فإن رغبة إماراتية في اختراق البيت السعودي كانت واضحة منذ عهد الملك عبد الله. وثائق ويكليكس كشفت في رسالة مؤرخة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ومرسلة من قبل الممثل التجاري للولايات المتّحدة، روبرت زويليك، يقول بن زايد إن “الإمارات وقطر كانت لديهما صراعات مع السعوديين”، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية تحديدًا خاضتا 57 معركة على مدار الـ250 سنة الماضية، ردًّا على المحاولات السعودية لاحتلال الإمارات. ويلخّص بن زايد حديثه قائلًا: “السعوديون ليسوا أصدقائي الأعزاء، لكننا بحاجة إلى التعايش”.
وثيقة بتاريخ 15 يناير 2003 تكشف تفاصيل نقاش جرى في 8 يناير من العام نفسه بين ولي عهد الامارات محمد بن زايد ومدير تخطيط السياسات السفير ريتشارد هاس حول العلاقات بين العراق وإيران والسعودية والولايات المتحدة، من بين أمور أخرى.
قدّم ابن زايد رؤيته حول السعودية وقيادتها وقلل من التوترات بين السعوديين والقطريين مشيرا إلى أن الشعبين يشتركان في الجذور الوهابية. على النقيض من ذلك، كانت العلاقات السعودية الإماراتية أكثر تعقيدًا. ابن زايد أثار مسألة النزاع الحدودي بين أبو ظبي والرياض وتحديدًا حول (حقل الشيبة النفطي). ويعلّق هاس: مع ذلك، أدرك الإماراتيون البراغماتيون دائمًا الحاجة إلى التعامل مع السعوديين، وبالتالي حافظوا على علاقات جيدة مع الرياض.
لحظ هاس أن ابن زايد ينظر إلى بعض كبار آل سعود بنظرة قاتمة – مشيرًا بسخرية إلى أن أسلوب وزير الداخلية الأسبق نايف بن عبد العزيز المتلعثم يشير إلى أن “داروين كان على حق”.
https://wikileaks.org/plusd/cables/03ABUDHABI237_a.html
في وثيقة أخرى سريّة عن علاقات السعودية والامارات تعود الى 15 أكتوبر 2009، تذكر “بينما تعرب الإمارات العربية المتحدة علنًا عن علاقاتها الوثيقة مع الرياض، فإنها تعتبر المملكة بشكل خاص ثاني أكبر تهديد أمني لها بعد إيران (إسرائيل ليست مدرجة في القائمة).
A LONG HOT SUMMER FOR UAE-SAUDI RELATIONS, Wikileaks, October 15, 2009;
https://wikileaks.org/plusd/cables/09ABUDHABI981_a.html
ولكن ما يفرّقه التاريخ يجمعه الجغرافيا أحيانًا، والعكس صحيح أيضًا. فقد كان اندلاع الربيع العربي وصعود الاخوان المسلمين نذير خطر مشترك في كل أرجاء الخليج بنسب متفاوتة. إذ مثل الربيع العربي تهديدًا كيانيًا لكل مشيخات الخليج. كان وصول الاخوان الى الحكم في مصر بعد انتخابات صيف 2012 بمنزلة رافعة لجماعات الاخوان المسلمين في الامارات والسعودية والكويت، وبدا حلم “الدولة الإسلامية” يراود قادة وكوادر الجماعات في هذه الدول، في ظل ارتياب من مواقف إدارة أوباما إزاء صعود الظاهرة الاخوانية، ولا سيما في مصر التي أثارت هلع قادة الخليج، وفي مقدّمهم الملك عبد الله الذي عبّر صراحة عن غضبه من تخلي الولايات المتحدة عن حليفها المصري.
كانت الخطوة الإماراتية متقدّمة على بقية دول الخليج، إزاء ما يلزم فعله لاحتواء تداعيات الربيع العربي على الخليج، وقرّرت شن حملة اعتقالات وسط كوادر الاخوان المسلمين في الامارات، تمهيدًا لظهور ما أطلق عليه “نادي الملوك” وإحباط مفاعيل الثورات الشعبية على منطقة الخليج. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بن زايد: “استثمر الكثير من موارده الهائلة في الثورة المضادة ، وقام بقمع الإخوان المسلمين وأقام دولة شديدة الحداثة قائمة على الأمن، حيث يتم مراقبة الجميع بحثًا عن أدنى حد نفحة من الميول الإسلامية”.
https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html
كان الانقلاب العسكري في مصر بتمويل سعودي اماراتي، مناسبة نموذجية بالنسبة للإمارات من أجل تعزيز العلاقة مع السعودية، والذهاب الى مديات أبعد لناحية بناء شراكة مع الرياض تقوم على تفاهمات مع شخصيات فاعلة في البيت السعودي الحاكم. محاولات أبناء زايد اختراق البيت السعودي بدأت في عهد الملك عبد الله، عبر مستشاره الخاص الشيخ خالد التويجري بهدف تأهيل نجله متعب، رئيس الحرس الوطني السابق ليكون شريكًا مستقبليًا للإمارات. المحاولات تعثّرت بموت عبد الله الذي لم يستكمل إجراءات تصعيد نجله ليكون في خط الوراثة بعد تحويل الحرس الوطني الى وزارة واستحداث منصب ولي ولي العهد.
لم تتوقف محاولات محمد بن زايد، وجرى العمل بشكل مكثّف مع وصول الملك سلمان الى العرش في يناير 2015. كان محمد بن سلمان رهانًا إماراتيًا رابحًا، حيث لوحظ التقارب الاماراتي السعودي في الأيام الأولى، وكانت مبادرة محمد بن زايد لتقديم كأس الماء الى الملك سلمان في إحدى الاستعراضات العسكرية لفتة معبّرة عن رغبة إماراتية في الوصول الى “قلب” الملك. بدأ التوصل مع محمد بن سلمان في مرحلة مبكرة، وكان ابن زايد مصمّمًا على التخلّص من محمد بن نايف وتمهيد السبيل من أجل وصول الحليف الجديد. لتحقيق ذلك، شجع ابن زايد الاميركيين على توفير كل أشكال الدعم لوصول الأمير الشاب الى العرش.
Dexter Filkins, A Saudi Prince’s Quest to Remake the Middle East, The New Yorker, April 2, 2018;
https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/09/a-saudi-princes-quest-to-remake-the-middle-east
كان الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية السابق قد حذّر في العام 2017 من مؤامرة إماراتية. وحمّل ابن زايد مسؤولية الخلافات داخل العائلة المالكة، وهو ما كشف عنه في رسالة بعث بها محمد بن نايف الى الملك سلمان في يوليو 2017 حذّره فيها من الخدعة الإماراتية، بأن تكون السعودية “العوبة بيد الامارات”.
رسالة من بن نايف للملك سلمان حول “مؤامرة” بن زايد، سبوتنيك، 24 يوليو 2017
shorturl.at/osAHY
كان الخطر المشترك دافعًا مباشرًا لتحالف سعودي اماراتي وتاليًا لتحالف رباعي، وما لبث أن تظافرت المصالح بالأخطار لتفضي الى تحالف بدا متينًا، إذ وجد الطرفان حاجة للدخول في شراكة ما وإيداع الخلافات العميقة في مستودع الزمن.
كان خطر الاخوان المسلمين نصب عين السعوديين والاماراتيين، والموّجه لمواقف البلدين والأساس الذي قام عليه التحالف الرباعي (السعودية والامارات ومصر والبحرين). وقد سلكت الشراكة أحيانًا طرقًا وعرة، بالانخراط أولًا في الحرب على اليمن في مارس 2015، إذ شكّلت السعودية والامارات قطبي الرحى والعمود الفقري في التحالف العربي أولًا والتحالف العسكري الإسلامي تاليًا، ثم الضلوع في المحاولة الانقلابية في تركيا في صيف 2016، وثالثًا في الأزمة مع قطر في يونيو 2017.
بدأ الجانبان السعودي الاماراتي شراكة استراتيجية حقيقية، عبر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مايو 2016 يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين. وقد عقد أول اجتماع له في يونيو 2018 تحت مسمى “استراتيجية العزم”، في إشارة الى وسم عهد الملك سلمان، وتمّ الإعلان عن 44 مشروعًا استراتيجيًّا مشتركًا في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية. وبخلاف أهداف المجلس التنسيقي السعودي الكويتي، فإن هذا المجلس بدا طموحا للغاية. وكان من أهدافه: “تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري”. وأيضًا “إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري”.
كان التنسيق السعودي الاماراتي عاليًا في غالبية الملفات، باستثناء أخرى يمكن ادراجها في ما يمكن تسميته بـ “منطقة الفراغ” السياسي حيث يترك فيها لتقدير كل طرف والموقف الذي يبنى عليه، أو ملفات تمس السيادة المباشرة للدولة مثل الملفات الداخلية، وإن ظهر مشاركة الامارات على الأقل انخراطها في ملف صراع الاجنحة في السعودية. ملف العلاقات العربية والاقليمية، ولاسيما مع ايران والعراق وسوريا لم تعكس خلافًا ثنائيًا ظاهريًا، ولكن كان لكل منهما مقاربته الخاصة. فقد حافظت الامارات على مستوى ثابت من العلاقات التجارية مع ايران حتى في ذروة الخلاف السعودي الإيراني. لحظنا بعد وصول رئيسي الى رئاسة ايران، أوفدت أبو ظبي ممثلا عنها الى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد، كما رفعت الامارات من مستوى التبادل التجاري، وقدّمت تسهيلات غير مسبوقة للتجار الإيرانيين. السعودية التي دخلت في حوارات مباشرة مع ايران في العاصمة العراقية لا تزال متردّدة في تطبيع العلاقات، وإعادة فتح السفارة، تمهيدًا لتفاهمات سياسية واقتصادية وامنية. يبدو ان الارتياب المتوارث لا يزال يحكم سلوك الساسة السعوديين، وهو ما يكسب الاماراتيين نقاطًا في حراكهم الدبلوماسي.
صحيح، أن الرياض تضبط في الغالب خطواتها الدبلوماسية على الساعة الأميركية خصوصًا فيما يرتبط بالعلاقة مع ايران، والصحيح أيضًا أن الرياض لا تزال محكومة بهواجس قديمة، حول النفوذ الإيراني. للإشارة، السعودية تتطلع في حواراتها مع ايران الى أن تلعب الأخيرة دورًا فاعلًا يعينها على الخروج من حرب اليمن بأقل الخسائر. أكثر من ذلك، هي ترغب في مساعدة إيرانية للتخلّص من الضغط الأميركي في إنهاء الحرب على اليمن، التي تجد نفسها متورّطة فيها ماليًّا. وهنا تبدو المفارقة ضرورية بين الدور الأميركي في أفغانستان والدور الأميركي في اليمن. في أفغانستان كانت الولايات المتحدة تشارك بجنودها وأموالها وكانت الخسارة أميركية صافية، فيما الحرب في اليمن تقع تكاليف الحرب على عاتق السعودية والامارات، وان الولايات المتحدة ودولًا أوروبية تجني أرباحًا صافية من استمرار الحرب عبر صفقات السلاح، والخدمات الأرضية، والتعاون الاستخباري..
لناحية العراق، كان الساسة العراقيين من كل الطوائف يجدون في الامارات ملاذًا آمنًا، لنقل أموالهم، وعوائلهم، والاستمتاع بسياحة ورفاهية يفتقدونها في العراق الثري ولكن المدمّر. ولذلك نسج ساسة العراق علاقات وثيقة مع الامارات، وكانت ولا تزال الوجهّة المفضّلة لهم. علاقة السعودية مع العراق تأخرت كثيرًا، وعادت بعد تردد طويل استمر من 2003 ـ 2015. وحتى العودة السعودية الى العراق لم تكن سلسة، ويتذكر العراقيون الخراب الذي أحدثه أول سفير سعودي الى العراق ثامر السبهان، واصطدامه مع الحشد الشعبي الذي انتهى الى المطالبة بطرده من العراق وعودته الى بلاده.
عمل ولي العهد محمد بن سلمان على ترميم الخراب الذي أحدثه السبهان، وقرر فتح صفحة جديدة مع قيادات شيعية عراقية (مقتدى الصدر وعمار الحكيم، وحيدر العبادي على وجه الخصوص)، بنيّة اختراق المكوّن الشيعي. وعلى ما يبدو، لم تستطع السعودية تحقيق اختراق كبير بفعل الدور الإيراني المؤثّر.
لم تستقر العلاقات السعودية العراقية نسبيًا الا في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي نجح في كسر الجمود وفتح آفاقًا جديدة، كان آخرها المؤتمر الإقليمي لدول الجوار في بغداد في 28 أغسطس الماضي، والذي جمع قيادات مصر والأردن وقطر ونائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء الاماراتي محمد بن راشد ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح ووزراء خارجية السعودية وإيران وتركيا والكويت إضافة الى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.
في المؤتمر، عبّر كل ضيف عن هواجسه وتطلعاته، وكان السعودي حريصًا على تظهير التعاون في مجال الامن ومكافحة الإرهاب (معلوماته أن عددًا من الصواريخ التي سقطت على منشآته النفطية والحيوية بما في ذلك قصر اليمامة كان مصدرها العراق وليس اليمن وهذا ما أُبلغ به العراقيون في الزيارة القصيرة التي قام بها وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف الى بغداد في 4 سبتمبر الجاري).
في المقابل الامارات، التي حضرت بوفد رفيع المستوى يقوده حاكم دبي الذي تربطه علاقات وثيقة بالساسة العراقيين وجدتها فرصة لتعزيز علاقاتها مع بغداد، ومع الوفود الأخرى: التركية والإيرانية والقطرية والكويتية.
على نحو الاجمال، كانت خسارة ترامب في الانتخابات بداية تفكك التحالف الرباعي، (الامارات والسعودية ومصر والبحرين)، وتحوّلت القضايا الجامعة لتحالف الرياض وأبو ظبي ذاتها الى قضايا خلافية، على النحو الآتي: قطر، تركيا، اليمن، الاخوان المسلمين، إسرائيل، فيما بقيت قضايا أخرى في خانة المسكوت عنها مثل (العراق، سوريا، إيران، لبنان، فلسطين المحتلة).
أزمة قطر
كانت أولى الملفات التي أريد معالجتها بعد وصول بايدن الى البيت الأبيض هي الأزمة مع قطر. في حقيقة الأمر، أن هذا الملف كان مطلبًا أميركيًا بدرجة أولى، ببساطة من أجل طي ملفات مليئة بالفساد المالي يديرها صهر الرئيس، جاريد كوشنر. كان اتفاق العلا بين الرياض والدوحة بداية اغلاق الأزمة، ولكنّ في مكان آخر، أبقى أبوابًا أخرى للأزمة مشرعة. كانت أبو ظبي والمنامة والقاهرة تنظر الى الطريقة التي تمّت بها معالجة الأزمة على أنها لا تعبّر عن رغبة جماعية، أي التحالف الرباعي، وإنما هي مقاربة سعودية محض. ولذلك، تردّدت هذه العواصم في الأيام الأولى في الترحيب بما أطلق عليه بيان العلا وتاليا انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا في 5 يناير 2021 من أجل إسدال الستار على أزمة دامت أكثر من عامين ونصف العام.
صحيح أن العلاقات بين دول التحالف الرباعي مع قطر لم تستعد كامل طاقتها، ولكن بدت الرياض على عجلة من أمرها من أجل طي الصفحة مع الدوحة، فيما بقيت الأطراف الأخرى (الامارات ومصر والبحرين) حائرة، أو غير مبالية، وكأنها غير معنيّة بكل الترتيبات وأن للسعودية مصلحة خاصة في الاتفاق.
على اية حال، من الجليّ أن أزمة قطر التي جمعت السعودية والامارات تحوّلت الى عنصر فراق. بمرور الأيام، ظهر أن كل طرف اختار لنفسه طريقته الخاصة في مقاربة العلاقة مع قطر. بل بدا وكأن تنافسًا سعوديًا إماراتيًا على من يكسب الدوحة الى صفه.
التنافس الاقتصادي
على أفق واسع، دخلت الرياض وأبو ظبي في ماراثون اقتصادي كوني. صحيح ان “نموذج دبي” كان حلمًا ورديًا راود ابن سلمان لسنوات، وحاول نسخه وتطبيقه في مناطق متفرّقة من المملكة ضمن رؤية 2030، الا أنه كمن اشتد ساعده، وقرّر التحليق منفردًا. وهذا ما تنبئ عنه كل الإجراءات البيروقراطية التي تبناها في سياق تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة الدولية، وليس الامارات التي حصدت النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية على مدى عقود، بل كانت الوجهّة المفضّلة للمستثمرين العرب، وحتى السعوديين. نتذكر هنا ما قاله التجّار السعوديون للملك عبد الله عن التعقيدات التشريعية في المملكة في مقابل التسهيلات القانونية التي يحظى بها المستثمرون من كل أرجاء العالم. يبدو أن ابن سلمان تعلّم من أخطاء أسلافه، وقرر مجاراة حكام الامارات في طريقة التعاطي مع المستثمرين العرب والأجانب بتقديم تسهيلات قانونية وائتمانية ومالية. يبقى أن الرسوم الباهظة التي تفرضها بلاده تنطوي على عنصر طارد للاستثمار.
لا ريب أن ضخامة حجم السوق ومتانة الوضع المالي يؤهّل السعودية لأن تلعب دورًا رياديًا في اقتصاديات السوق الإقليمية والدولية، فهي اليوم تحتل الموقع الرابع عالميا من حيث حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بواقع 434.7 مليار دولار (بحسب احصائيات يونيو 2020)، وتليها الإمارات بـ 110 مليار دولار. في المقابل، لا تزال الامارات متقدّمة على السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية. وبحسب احصائيات مايو 2021 بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في الإمارات 19.88 مليار دولار في العام 2020، أي بنمو يبلغ حوالي 44.2٪ عن العام 2019، وهذا يجعلها الأولى عربيا وإقليميا والـ 14 عالميًا من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020، متقدّمة بذلك على بريطانيا التي جاءت في المركز الـ 16 وفرنسا في المركز 18 واليابان التي جاءت في المركز 20. وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أن الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل ارتفع لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها. وبحسب التقرير جذبت الامارات ما قيمته قرابة 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي بما يعادل 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. وشملت الاستثمارات الأجنبية قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا المتوسطة والصغيرة. ويرجع الاماراتيون هذا الإنجاز الى “مناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو”.
في المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في السعودية الى 20 في المائة، فإنها لم تتجاوز 5.5 مليار دولار، أي الربع مقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية في الامارات.
يسعى ولي العهد السعودي الى التخلّص من التبعات الاقتصادية لجريمة قتل خاشقجي والتي أدّت الى انكفاء عدد من المستثمرين الأجانب، وكذلك اعتقالات الامراء والتجّار والتي انعكست سلبيًا على ثقة المستثمرين في طريقة تعاطي السلطات السعودية مع المتّهمين بالفساد، وغياب محاكمات واضحة ومعلومات موثوقة عن مصير الأموال التي سحبت منهم، وصعوبة الفصل بين المال الخاص والمال العام، كما نبّه الى ذلك سوفت بنك الياباني.
فيما يحاول النظام ترميم صورته عالميًا، فإن تدابير متوالية يقوم بها من اجل نقل الثقل الاقتصادي الإقليمي من الامارات الى السعودية. ويأتي قرار ابن سلمان بإلزام الشركات فتح مقارّ إقليمية في السعودية كشرط للعمل في أسواقها، واغلاق أي مكاتب أخرى لها في الامارات أو دول خليجية أخرى في إطار حصر النشاط الاستثماري في المنطقة في السوق السعودية وإبقاء الأسواق الأخرى ثانوية. حتى الآن، لا تبدو ان الخطوة نجحت ولكن هناك إصرار سعودي على المضي فيها حتى النهاية، وقد ينعكس ذلك على شركات أميركية كبرى. في سباق مع الإجراءات السعودية، هناك تسهيلات إماراتية غير مسبوقة من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية (الأميركية على وجه الخصوص) على إبقاء مراكزها في الامارات سواء بتعديل قانون التملّك، أو الإقامة والجنسية الى جانب التسهيلات المالية.
على نحو الاجمال، ثمة حرب باردة سعودية إماراتية تعكس نفسها في التجاذب الاقتصادي المحتدم منذ شهور، يذكّر بخلافات سابقة حول “البنك الخليجي” و”العملية الخليجية الموحّدة” والتجارة البينية الخليجية و”الهوية الخليجية الموحّدة”، وما رافقه من جدل حول الخارطة المرسومة على البطاقة الإماراتية، والمشتملة منطقة حدودية متنازعًا عليها، وما أعقب ذلك من إجراءات عقابية، بخنق الإمارات برّياً عبر منْع شاحناتها من دخول الأسواق السعودية في أيار 2009.
أشعل الاجراء السعودي من طرف واحد، أي ارغام الشركات الأجنبية على نقل مراكزها الإقليمية الى الرياض حربًا اقتصادية باردة، برز منها على السطح السجال حول آلية الإنتاج النفطي في “أوبك+”، وهو في صميمه خلاف حول الحصص، التي بها يتحدّد العرض والطلب، وتالياً السعر.
في حقيقة الأمر، أحيت الرياض في سجالها الاقتصادي/التجاري مع أبو ظبي احلامها القديمة نسبيًا بوضع اليد على مجمل مؤسسات وأنشطة مجلس التعاون الخليجي، ويشمل نقل مقرّات معظم مؤسّسات “مجلس التعاون” العشرين الى اراضيها. وكانت الامارات أوّل دولة تقدّمت بطلب إلى المجلس لاستضافة مقرّ “البنك الخليجي” على أراضيها في عام 2004، بينما السعودية تقدّمت بطلبها في العام 2008..
وترصد وثيقة سريّة بتاريخ 15 أكتوبر 2009، مجريات التوتر المتصاعد بين الامارات والسعودية، بدءًا بقرار الإمارات في مايو من العام نفسه بالانسحاب من الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي (بعد نقل المقر الرئيسي إلى الرياض). بعد ذلك بوقت قصير، أغلق السعوديون فعليًا معبرًا حدوديًا رئيسيًا، ورفضوا لاحقًا السماح للمواطنين الإماراتيين بالدخول ببطاقات الهوية (وهي إحدى قواعد التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب التقسيم الوحدوي للحدود الإماراتية على ظهر البطاقة. في حين يفسر الإماراتيون بشكل شبه عالمي هذه الإجراءات على أنها دليل على موقف المملكة المتعجرف تجاه دول الخليج الأصغر، كانت قيادة الإمارات العربية المتحدة حريصة على عدم تصعيد الصراع وعملت على معالجة القضايا بهدوء خلف الكواليس.
A LONG HOT SUMMER FOR UAE-SAUDI RELATIONS, Wikileaks, October 15, 2009;
https://wikileaks.org/plusd/cables/09ABUDHABI981_a.html
اعادة صياغة الخريطة الخليجية
دخول الإمارات في حلبة الخلاف مع السعودية، من البوّابة الاقتصادية (والنفطية على نحو التمويه)، مع تبريد مؤقّت لجبهات الخلاف السعودي – العماني، والسعودي – القطري، والسعودي – الكويتي، يشي بجولة خلافات من نوع آخر، وتالياً تبدّلات في شبكة التحالفات الخليجية. ولْنتذكّر دائماً أن السعودية لم تعتَدْ على العزف المنفرد، ودائماً ما كانت تُراهن على العمل الجبهوي/ المشترك. لم يكن لقاء ابن سلمان بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ في 11 حزيران الماضي روتينياً، في ظلّ عمل مصري دؤوب لبناء تحالفات عربية (العراق والأردن)، وتزخيم العلاقة مع كلّ من سوريا وفلسطين ولبنان، والانفتاح الحذر على تركيا وباكستان، وصولاً إلى الصين. اجتراح مصر لمسار مستقلّ في علاقاتها العربية والإقليمية، يُغذّي على الفور مخاوف راكدة في المخيّلة السعودية. وهو ما تَعزّز مع التطوّر المفاجئ بعد معركة “سيف القدس”، حيث شكّل ذوبان الجليد بين القاهرة وواشنطن حافزاً للرياض لتجديد التقارب مع القاهرة، المستهدَفة في مشاريع السعودية الاقتصادية/ السياحية.
خسارة مصر، في المنظور السعودي، فادحة، بل كارثية، لأن ذلك يجعلها محوراً قائماً بذاته، فيما تسعى المملكة إلى إطالة عمر “الحقبة السعودية”، وإلى ما لا نهاية.
اللعب على التناقضات باتت عادة في الخليج، وفي كل مكان آخر في العالم تكون فيها المصالح متضاربة بين الدول. فالسعودية التي لديها خلافات حدودية مع كل دول مجلس التعاون الخليجي تدرك طبيعة وعمق الخلافات بين قطر والبحرين من جهة وبين الامارات وعمان من جهة ثانية، وهي أقدر من غيرها على استغلال الخلافات في البيت الخليجي.
في ديسمبر 2016، قام الملك سلمان بجولة خليجية بدأها بالإمارات، ثمّ قطر والبحرين، وأخيراً الكويت، حيث انعقدت قمّة “مجلس التعاون الخليجي”، وتجاهَل سلطنة عمان. حينذاك، تُوّجت المفاوضات الإيرانية – الأميركية برعاية عمانية باتفاق نووي برعاية أممية، ما أثار غضب الرياض، التي شعرت بـ”الخديعة”، لإخفاء خبر المداولات عنها. بقي الخلاف على حاله مع السلطنة، حتى وفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد. وحتى بعد اعتلاء سلطان آخر، هيثم البوسعيدي (تولّى الحُكم في 11 يناير 2020)، لم تشهد العلاقات السعودية – العمانية تطوّراً إيجابياً لافتاً، إلى حين نشوب الخلاف الإماراتي – السعودي، حيث بادرت الرياض إلى لعبتها المفضّلة في تثمير التناقضات على غرار تلك (باكستان/ الهند، تركيا/ اليونان).
المنفذ الحدودي بين البلدين، والمُغلَق بقرار سعودي منذ سنوات طويلة، أصبح فجأة جاهزاً للاستعمال، ومعه زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي، و”أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعّال مع الملفّ النووي والصاروخي الإيراني… ومواصلة الجهود لإيجاد حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية… والتعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية”، بحسب البيان المشترك بين الجانبين في ختام زيارة قام بها سلطان عمان إلى السعودية في 11 يوليو الماضي. بطبيعة الحال، ليس كلّ مضمون البيان المشترك يعبّر عن الموقف العماني، ولاسيما في ما يرتبط بالمبادرات المتعلّقة بوقف الحرب على اليمن، أو حتى صواريخ إيران البالستية. وفي نهاية المطاف، هو بيان سعودي بامتياز، وقد اعتادت دول الخليج على مثل هذه البيانات الفارغة.
وبحسب المؤشرات المتوافرة، فإن ثمة تنافسًا ملتهبًا سوف تخوضه الرياض وأبو ظبي في المرحلة المقبلة، من أجل تثبيت معادلات جديدة. فالضد النوعي يحرّض الطرفين على تدابير قد تكون من صالح المستثمرين والراغبين في جني أرباح التنافس غير الشريف بين البلدين.
الخسائر ليست خافية هي الأخرى، لأن العمل يجري على مشاريع غير استراتيجية وغير تنموية، وهي في الغالب تتخذ من نموذج دبي كمدينة ترفيهية وسياحية مثالًا للتجاذب الاقتصادي والتجاري. ويمكن القول، أن هذا النموذج يغري عددًا من دول الخليج ودول أخرى عربية وإقليمية من أجل تعميمه على قاعدة أنه يمثل نجاحًا باهرًا، على الأقل في حدّه الاستثماري والسياحي.
يبقى أن ما يشغل بال ابن سلمان في المرحلة الراهنة هي حرب اليمن، التي يريد نهاية مريحة منها، وبما يخرجه من مستنقعها بأقلّ الخسائر، كونها تستنزف من خزينة الدولة، كما من صورتها كوجهة استثمارية وسياحية.
اختلاط الاوراق
وتبقى الأبواب مشرعة على توترات قادمة بين الرياض وأبو ظبي، على خلفية الطموحات المتصادمة للعب أدوار فاعلة في الساحتين الإقليمية والدولية. ويمكن فهم الهرولة الإماراتية نحو إسرائيل، وبوتيرة غير منضبطة أحيانًا، من أجل بناء تحالف استراتيجي يعوّض عن انهدام جزئي أو كلي لتحالف رباعي بات في مهب التحوّلات الإقليمية والدولية (والأميركية على وجه الخصوص).
من جهة ثانية، تشق أبو ظبي طريقها في تعزيز علاقات قائمة أو نسج أخرى جديدة أو ترميم ما تخرّب مع خصوم سابقين (قطر وتركيا)، وهذا من شأنه أن يدفع الرياض نحو مضاعفة جهودها لمواكبة الحركة الدبلوماسية الامارتية. محاولة تظهير الامارات كطرف داعم للكيان الإسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني لم تنجح، بعد أن تراجعت السعودية عن مسار التطبيع وأوقفت كل أشكال التعاون مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك السماح لطائرته بالمرور في الأجواء السعودية، فقد كانت التطورات اللاحقة (المتغير التونسي بسيطرة الرئيس قيس بن سعيد على مقاليد السلطة بدعم اماراتي سعودي)، والانسحاب الأميركي من أفغانستان والدور الاماراتي في عملية انتقال السلطة باستضافة الرئيس الفار أشرف أغني وأعضاء حكومته وتسهيل انتقال الجنود الاميركيين وأنصارهم الأفغان من أفغانستان، خلط الأوراق الى القدر الذي أصبحت الخطوط الفاصلة بين الحلفاء والخصوم غير واضحة.
في الحاصل النهائي، ثمة مرحلة جديدة من العلاقة المضطربة بين الرياض وأبو ظبي مفتوحة على احتمالات التصعيد وإن لم يصل الأمر الى الصدام المسلّح، اللهم الا عبر الحلفاء، كما هو حاصل في اليمن، حيث يشتبك حلفاء السعودية والامارات في الجنوب، في سبيل زيادة النفوذ أو منع تغيير المعادلة.
الكويت والسعودية.. التحالف المستحيل
لا أحد يفهم السعوديين أكثر من شركائهم في مجلس التعاون الخليجي. وكل ما يقال في الاعلام يجري نقيضه في الواقع. وقد اعتاد الخليجيون على المساكنة حتى في ذروة خلافاتهم. وقد يتخاصموا في السر ويتعانقون في العلن، ولا ضير في ذلك، فذلك من ضرورات العيش المشترك. يدرك العمانيون قبل غيرهم أن انفتاح السعوديين عليهم ليس بريئًا، بل هي ضمن لعبة التجاذب والمناكفات مع الامارات. ويدرك الكويتيون أن تقارب السعودية معهم ليس هو الآخر بريئًا، وقد تكون له غايات منها، للحؤول دون دخولها في شراكة مع جارها العراقي أو حتى الإيراني.
لعبت الكويت دور الوساطة لسنوات لحل ملف أزمة قطر، وكان صباح الأحمد، أمير الكويت السابق، قد كشف في مؤتمر صحافي مع الرئيس ترمب، أنه نجح في منع اجتياح عسكري لقطر، وقد أغضب ذلك السعودية والامارات. من جهة أخرى، حاول ابن سلمان في زيارة خاطفة الى الكويت في 5 نوفمبر 2018 بهدف حل مشكلة حقلي الخفجي والوفرة. الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية نزار العدساني قال “إن زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة للكويت لم تكن جيدة”. وقد جاء ابن سلمان من أجل اقناع الكويتيين باستثنائف انتاج النفط في المنطقة، قبل حل المشكلة الفنية، التي تطوّرت الى قضية سياسية. كان مقرّرا بقاء ابن سلمان يومين في الكويت يلتقي فيها مع التجار والشخصيات، ولكنه قرّر قطع الزيارة بعد ساعات قليلة، وقالت مصادر كويتية لرويترز “إن المحادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق مع مقاومة الكويت ضغوط الرياض لتعزيز السيطرة على الحقلين”. وقال المصادر أن السعودية تمتنع عن الالتزام بالقوانين الكويتية المطبّقة على شركة النفط الأمريكية شيفرون والتي تعمل في حقل الوفرة نيابة عن السعودية، كما تريد الرياض أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة. في العام 2009 عبّرت الكويت عن استيائها الشديد من قرار الرياض تمديد امتياز شيفرون بحقل الوفرة حتى 2039 دون حتى طلب المشورة من الكويت. وقررت الكويت عدم اصدار أو تجديد تأشيرات دخول موظفي شيفرون إلى الأراضي الكويتية. فقامت شيفرون باغلاق حقل الوفرة بدعوى صعوبات استخرج تصاريح العمل وتدبير المواد. وبهذا توقف انتاج حقلي الخفجي والوفرة البالغ 500 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 0.5 في المئة من امدادات النفط العالمية.
هذه الحادثة جاءت بعد توقيع البلدين في 18 يوليو 2018 على محضر إنشاء المجلس التنسيق السعودي الكويتي، والذي يندرج تحته، نظريًا على الأقل، جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين. تجدر الإشارة الى أن العمل بالمجلس تعطّل بسبب الخلاف الطارئ حول حقلي الخفجي والوفرة. وفي 6 يونيو 2021 عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي، وأثمر عن توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات “تشجيع الاستثمار المباشر، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة”، كما تمّ التوقيع على “برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة بين الهيئة العامة للصناعة الكويتية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.
وكما يظهر، فإن الاتفاقيات بقيت في حدودها الدنيا، بما يعكس التوقعات المنخفضة لدى الجانبين. وعلى الرغم من الأحاديث المتكررة عن ميول أمير الكويت الجديد نواف الأحمد نحو توثيق العلاقة مع الرياض، فإن هواجس وتعقيدات العلاقة وتضارب المصالح تفرض على الجانب الكويتي حساب كل خطوة بدقة، لأن ما يربطه بالشقيقة الكبرى أبعد من مجرد متغيّر آني أو مصلحة مباشرة، بل هناك مخاوف ومشاكل لم تحسم وبؤر توتر لم تغلق بعد.
لناحية الامارات، لا ملفات ساخنة عالقة بينها وبين الكويت، حدودية وعسكرية وأمنية، وأن ما قيل عن لوبي إماراتي ضد الكويت في بروكسل للتحريض على الكويت في مجال حقوق الانسان، جرى احتواؤها على نحو عاجل. في نهاية المطاف، فإن ما يؤثر في العلاقات الإماراتية الكويتية هو ما يمس مصادر الدخل (النفط والغاز بدرجة أساسية)، وهذا يعتمد على الموقف الذي تعتنقه الكويت في خلاف السعودية والامارات..
التطبيع..هرولة إماراتية وتريّث سعودي
في ملف التطبيع، السعودية توقفّت عن السير فيه ليس لأنها لا تريده ولكن لا ترغب المضي فيه طالما ليس هناك مصلحة تقتضي ذلك، مع غياب ضغوطات أميركية في هذا الصدد. واذا ما واصلت الامارات تعزيز روابطها مع الكيان الإسرائيلي قد تصل في مرحلة ما إما الى تصادم إذا ما شعرت الرياض بوجوده ما يهدد أمنها القومي أو تضطر الى الدخول على الخط وقطع الطريق على الامارات لكسب الإسرائيلي كشريك لها، تجاري على الأٌقل. وعلى ما يبدو، لا ترغب الامارات ولا السعودية في تحويل إسرائيل الى عنصر توتير في العلاقة مع ايران، وأن تقتصر العلاقة على البعد الاقتصادي.
سوريا ولبنان..ترقّب ثنائي
مقاربة الامارات والسعودية الى الملفين السوري واللبناني تكاد تكون متقاربة، وليست متطابقة، كون الملفين في عهدة الأميركي وهما يخضعان تحت تأثير المتغيّرات الدولية. ولذلك، لحظنا بعد الاندفاعة الأولى نحو فتح السفارة (من جانب الامارات على الأقل) ورغبة في تطبيع تدريجي في العلاقات بين البلدين، أن توقفًا مفاجئا طرأ على الخطوط الدبلوماسية بين سوريا ودول الخليج. والحال نفسه ينسحب على لبنان الذي بات في العهدة الأميركية (والفرنسية بالواسطة والنيابة)، فيما يترقّب الاماراتي والسعودي (الحاضران بكثافة في سنوات ما قبل الازمة الأخيرة) الإشارة الأميركية لنرى حينئذ هل يعود الثنائي الاماراتي السعودي كما كان، أم يختار كل طرف حلفاء جدد له، كما سوف يظهر في خارطة التحالفات ما قبل انتخابات منتصف العام 2022.
في الأخير، ما يجمع الامارات والسعودية أقلّ اليوم مما يفرّق بينهما، وأن محاولات تخفيف الاحتكاك في القضايا الساخنة، التي لم يستطع الطرفان منعه كما حصل في الملف النفطي، قد يمتد إلى ملفات أخرى، فما يملكه آل زايد وآل سعود من طموحات تجعل الاحتكاك أمرًا بل وأحيانًا حتميًا.