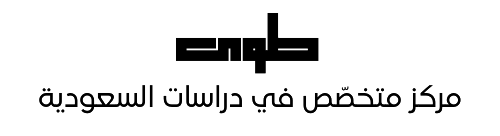العلاقات السعودية_الايرانية…الى اين؟

السعودية ورهاناتها بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي…وإيران
في اختبارين فارقين لحظت السعودية، على نحو مخيّب للآمال، كيف تصرّف الحليف الاستراتيجي الأميركي بعد تعرّض منشآتها النفطية الحيوية في “بقيق” و”خريص”، في 14 سبتمبر 2019 لسلسلة من الهجمات، أصابت 19 موقعًا في الأقل لضربات مباشرة وعالية الدقة باستخدام صواريخ كروز متوسطة المدى وطائرات من دون طيار، بحسب معلومات كشف عنها مسؤولون أميركيون صباح اليوم التالي من الهجوم. الهجمات ألحقت أضرارًا فادحة بالدورة الإنتاجية للنفط السعودي ومبيعاته في السوق العالمية، وهذا ما عبّر عنه بافتجاع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك، في برنامج (حكاية وعد) على قناة إم بي سي السعودية في 25 مارس 2023 حيث قال بأنه شعر وقتها “بأكبر انكسار في حياته لأن المملكة كانت تتباهي بأنها المصدر الآمن الموثوق به في الطاقة بالعالم، لكن بسبب الإنفجار تم فقد نصف الطاقة الإنتاجية فظهرت مخاوف في عدم قدرة أرامكو على توفير صادرات النفط” واعترف بأنه رأى وقتها “أن الوضع مخيف” فقد أصيب إنتاج النفط في السعودية بالشلل لبعض الوقت، وتوقّف امداد النفط الى الاسواق العالمية بنسبة 5%.
كانت السعودية قد اعتمدت لعقود من الزمن على الحماية الأميركية، وتشمل المنشآت النفطية ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة إلى دولة تعتمد في دخلها الرئيس على مبيعات النفط.
ألقت واشنطن والرياض باللوم على إيران بأنها تقف وراء الهجمات على المنشآت النفطية، وليست حركة أنصار الله في اليمن، على الرغم من إعلانها المسؤولية عن الهجمات. تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالاستعداد لمواجهة الأخطار التي تتهدد حلفاء الولايات المتحدة لم تسفر عن أي ردود فعل على الأرض، وكان ترمب يخشى من اشتعال حريق واسع وغير قابل للضبط في الشرق الأوسط. وتسبّب ذلك في خيبة أمل كبيرة لدى حكّام الرياض، وأثبتت الولايات المتحدة، من منظور السعودية وبقية الحلفاء، مرة تلو أخرى بأن حدود القوة التي تصل إليها تقف عند نقطة ما دون الاشتباك العسكري المباشر.
كان هجوم بقيق ـ خريص هو أكبر تهديد يواجه السعودية بعد حرب الخليج الثانية، والذي فرض تحديات كبيرة على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها، ودفعها إلى إرسال نصف مليون جندي إلى الجزيرة العربية من أجل مواجهة القوات العراقية التي أرسلها الرئيس السابق صدام حسين لغزو الكويت في الثاني من أغسطس 1990.
حينذاك، شعر حكّام الخليج أن الولايات المتحدة حليف استراتيجي يمكن الرهان عليه في “الملمّات” الكبرى والمصيرية، وربما هذا ما دفع الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إلى استثمار الحفاوة التي حظي بها في الخليج لمصالحه الشخصية عبر مشاريع تجارية خاصة مع شركة كارلايل التي تعمل في مجالات عدّة تجارية وعقارية وأمنية وعسكرية وتضم في مجلس إدارتها سياسيون وعسكريون وأمنيون كبار في الإدارات الاميركية والأوروبية..
لم يعد الأمر كذلك منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث بدأت الادارة الأميركية استراتيجيتها ولم تعد في وارد الانخراط في حروب نيابة عن حلفائها، ولذلك شعر حكام الخليج بالقلق إزاء التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها في المنطقة. وحاول هؤلاء انتزاع تعهد من واشنطن بحماية عروش الخليج ضمن اتفاقية أمنية دفاعية في اجتماع في المقر الصيفي في كامب ديفيد في مايو 2016 مع الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن الاجتماع لم يسفر سوى عن “طمأنة” و”تهدئة مخاوف” إزاء التهديدات الإيرانية.
بات الوضع أشد تعقيدًا وصعوبة بعد هجمات بقيق ـ خريص، إذ شعرت السعودية بأن الولايات المتحدة ليست على استعداد للدفاع عنها وحماية مصيرها وأن الالتزام الأمني الروتيني لا يعدو كونه رمزيًا.
في النتائج المباشرة لهذه الهجمات، أن ثمة توازنًا جديدًا للقوى الاقليمية جرى تظهيره وفرض معادلات جيوسياسية ليس من السهولة بمكان تبديلها. ومن جهة أخرى، فإن الهجمات كشفت عن حدود التدخل الأميركي في شؤون المنطقة المرشّحة على الدوام لمتغيرات جيوسياسية واستراتيجية.
ما كشف عنه الهجوم الصادم على المنشآت النفطية في بقيق ـ خريص أيضًا أن حجم الانفاق العسكري السعودي بدا كما لو أنه لغايات أخرى غير التي من أجلها خصّصت. إذ بدت الصواريخ والطائرات الحربية المتطوّرة وأجهزة التجسس والمراقبة كما لو أنها في حالة شلل شبه تام، وأنها أصبحت عاجزة عن منع هجمات بطائرات دراون وصواريخ بأثمان زهيدة. كان ثمة استعراضًا للقوة خسرت فيه السعودية من الجولة الأولى، وأن أنظمة الدفاع المتطوّرة أخفقت في اعتراض صواريخ وطائرات من دون طيار من الأجيال البدائية في عالم الصناعة العسكرية.
إن التهديدات التي أطلقها محمد بن سلمان بنقل المعركة الى طهران انقلبت الى معركة في صميم الشريان الحيوي لاقتصاد بلاده، وأن خطاب التهويل المتهوّر توارى على نحو مفاجىء بعد أن تعرّف على قدرة خصمه في المناورة العسكرية القاتلة. وإن التعويل على الحماية الأميركية في مثل هذه الحالة لم يكن مجديًا بعد الآن، وأن استراتيجية الولايات المتحدة تتمحور حاليًا على مواجهة الخطر الصيني بدلًا من الانشغال بتجاذبات الحلفاء والخصوم في الإقليم الملتهب. كان على مشيخات الخليج أن تلتقط الرسالة الاميركية مبكّرًا حين قرر الرئيس باراك أوباما إلغاء قرار الحرب على سوريا في سبتمبر 2013 على خلفية مزاعم استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في حي سكني في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية، دمشق. وكان ذلك إشارة بليغة بأن الولايات المتحدة ليست جيشًا للإيجار لخوض حروب الحلفاء.
لاشك أن الهجوم على بقيق ـ خريص فاجأ السعودي والأميركي على السواء، وكشف للمرة الأولى المدى الذي يمكن أن تصل إليه الولايات المتحدة في المواجهة مع ايران على مسرح الاقليم، وأن ايران التي دائمًا ينظر إليها على أنها تعمل من خلال “وكلاء” بحسب المنطق الأميركي السعودي هي على استعداد لأن تخوض المعارك المباشرة في حال تعرّض أمنها القومي لتهديد جدّي. وهذا ما أثبتته إيران في معركة الناقلات النفطية وإيضًا في اسقاط طائرة أميركية من دون طيار آر كيو ـ4 في 20 يونيو 2019 بعد محاولتها اختراق مجالها الجوي. كما قدّمت ايران الدليل في تدمير ناقلات نفط في الخليج في مايو 2019 وإبريل 2022 ويوليو 2023، بأن ايران لن تلتزم الصمت حيال ما تتعرض له من عقوبات أو تهديدات لمصالحها النفطية والاستراتيجية في المياه الدولية. يفهم الشريك الخليجي العزوف الأميركي عن الرد على أنه “تقاعس” أو “تنصّل” على أساس أن ثمة شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة على الضفة الغربية من الخليج تقتضي الدفاع عنها في حال تعرّضها لهجوم خارجي ـ ايراني، والحال أن ما لا يريد الشريك الخليجي فهمه، أن أمن هذه المنطقة ليس قابلة للقسمة، ولا يمكن لدولة أو عدّة دول أن تعيش أمانًا وتحرم أخرى منه، وأن الأميركي ليس جنديًا للإيجار، وعليه فإن كلام ترمب عن وجوب دفاع دول الخليج عن نفسها هو ما يدور في الكواليس الأميركية وليس مجرد فورة غضب لحظية.
كان التبرير الشائع ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن في وارد التصعيد العسكري مع ايران رغبة منه في إعادة انتخابه، بل وأنه أبعد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بسبب خطابه الاستفزازي والتحريضي خشية توتير الأجواء في المنطقة قد يدفع إيران إلى عمليات انتقامية أو ردعية، والتي قد تترك تأثيرات مباشرة على تدفق النفط من الخليج إلى الاسواق العالمية. بل كان ترامب واضحًا في موقفه من الحروب في المنطقة، وقد كتب تغريدة على حسابه في تويتر (X) في 31 أغسطس 2014:
“يجب على المملكة السعودية أن تخوض حروبها الخاصة، وهو ما لن تفعله، أو أن تدفع لنا ثروة مطلقة لحمايتها وحماية ثرواتها العظيمة – تريليون دولار!
بدا واضحًا أن ترامب الذي أظهر اهتمامًا خاصًا بالعلاقة مع الرياض ليس مستعدًا لأن يقدم خدمات دفاعية مجانية، وأن الشراكة الاستراتيجية ليست مبنية على أبعاد أخلاقية بل على السعودية أن تدفع بسخاء مقابل كل خدمة تحصل عليها من واشنطن لقاء حماية عرش حكامها ومنشآتها الحيوية.
إن الاستفزازات والعقوبات المفروضة على إيران وحرمانها من تصدير نفطها إلى الاسواق العالمية لابد أن تصل إلى نقطة تفجّر، وكان على إدارة ترمب وكل الادارات الأميركية المتورّطة في حصار إيران أن تعي بأن “الصبر الاستراتيجي” لا يعني الاستقالة والانسحاب من ميدان المعركة، وإنما يعني الترقّب والتقاط اللحظة التاريخية المناسبة لتوجيه الضربات القاتلة، وهذا ما كان على اميركا وحلفائها في المنطقة إدراكه بصورة مبكرة، إذ لا يمكن أن ينعم شعب بخيرات بلاده ويحرم آخر منها بمنعه من بيع نفطه وممارسة التجارة الحرة مع الدول الأخرى وفرض عقوبات على استيراد الدواء والتكنولوجيا المتطوّرة.
إن فشل الاتفاق النووي، وتراجع واشنطن عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق بقدر ما حرّرها من اشتراطات الاتفاق، فإنه وهب ايران فرصة لاعادة تقييم أي اتفاقيات في المستقبل، وأن رهان القوة يرجح على ما سواه. ولذلك، كان رفع معدلات التخصيب الى مستويات غير مسبوقة إجراء متوقّع، بعد تنصّل الطرف الرئيس في الاتفاق، أي أمريكا، من موجبات الاتفاق النووي، وتحديدًا تخفيف العقوبات الاقتصادية ورفع نسبي للقيود المفروضة على الانشطة العسكرية.
إن خيبة الأمل التي أصابت بعض الأصوات العالية في الخليج نتيجة إحجام ترمب الجمهوري، وقبله أوباما الديمقراطي، عن خوض حرب مع ايران في المنطقة لا بد أن تكون نبّهت إلى أن ثمة موازين قوى جديدة وحسابات جيوسياسية واستراتيجية مختلفة تفرض نفسها على صانعي القرار في منطقة غرب آسيا والغرب عمومًا.
إن الذهاب بعيدًا في الخصومة مع ايران بات مكلفًا، وليس بالإمكان الإفلات من العقاب في حال بات الأمن القومي الإيراني تحت تهديد الدول المجاورة. حينئذ تتلاشى خطوط التمايز داخل ايران بين متشدّد ومعتدل، إذ يصبح الجميع في جبهة واحدة ضد العقوبات الأميركية والأوروبية والاستعداد لتنفيذ هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة من أجل إرغامها على الاستجابة لمطالب ايران الاقتصادية والسياسية. ولن ينفع الوجود الكثيف للسفن والبوارج الحربية وحاملات الطائرات أو القواعد العسكرية الكبيرة في ردع إيران عن القيام بهجمات للدفاع عن مصالحها القومية. وقد فهم الأميركيون بأن إيران لديها العزم والقدرة على القيام بكل من شأنه منع التجاوز الأميركي على السيادة الايرانية في البحر والجو بدرجة أساسية.
كان على وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، ولي العهد الحالي، منذ تعيينه في هذا المنصب في عام 2015 أن يخفف من لهجة التعالي ضد ايران، الجار الأكبر والأقوى على المستوى الاقليمي. في مقابلة مع مجلة (التايم) الأميركي في الخامس من أبريل 2018 أعلنها صراحة بأن “الإيرانيين هم سبب المشاكل في الشرق الأوسط..إنهم السبب الرئيسي للمشاكل، لكنهم لا يشكلون تهديدًا للسعودية”[1].
إن رسوخ النظرة إلى ايران من زاوية الخصومة الدائمة يزيد في تعقيد المشهد ويمنع إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين تحول دون تفجّر الصراع في المنطقة. وفيما حاولت إيران مد اليد الى دول الخليج طيلة العقود الماضية من أجل الاتفاق على صوغ نظام أمن إقليمي يحفظ مصالح الجميع على قاعدة (رابح ـ رابح)، كانت السعودية ودول خليجية أخرى (البحرين والإمارات بدرجة أساسية) تتمسك بخيار القطيعة مع ايران. لقد استقبلت الرياض نصيحة أوباما لمجلة (ذي اتلانتيك) الأميركية في أبريل 2016 بضرورة تقاسم النفوذ مع ايران بلهجة تنطوي على عناد وإنكار ومنابذة، على أساس أن مجرد التفكير في تقاسم النفوذ مع ايران يعني إلحاق الضرر بالمصالح السعودية والتفريط في الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية[2].
لم يدرك حكّام الرياض حينذاك بأن ثمة موعدًا لتحوّل جوهري في الوجهة السعودية على وقع “رسائل بالنار” أوصلتها طهران وحلفائها في المنطقة من أجل الكف عن اللعب بشروط الماضي، فلا الولايات المتحدة بالقوة التي كانت عليها أو حتى الاستعداد للذهاب بعيدًا في دفاعها عن حلفائها، ولا ايران ومحور المقاومة بالضعف الذي تتخيله السعودية. محمد بن سلمان في مقابلة (التايم) بدا متعاليًا في تقييمه لقوة ايران الاقتصادية والعسكرية، حين صنّف جيش ايران بكونه “ليس من بين الخمسة الأوائل في الشرق الأوسط”، فيما وصف جيش بلاده على نحو مبالغ فيه:
“لن تجد سوى جيش واحد لديه تكنولوجيا أفضل منا، لكننا أكبر بكثير من حيث الحجم، بخمس مرات. لذا، بالنظر إلى الجودة والحجم، تمتلك المملكة العربية السعودية أفضل جيش..”، وذهب في تصعيده عبر مقابلة مع قناة (الأخبارية) في الاول من مايو سنة 2017 إلى أن نفي إمكانية إقامة علاقة مع ايران “ليس هناك نقاط للتفاهم مع النظام الإيراني، إذ تم تجربة هذا النظام في أكثر من مرحلة في وقت رفسنجاني واتضح أنها تمثيليات..” وذهب إلى حدود التهدديد “لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية بل نعمل على أن تكون المعركة لديهم في إيران وليس في السعودية”
ومع ذلك، كان الضرر الذي لحق بالمنشآت النفطية في بقيق ـ خريص درسًا مؤلمًا في التكاليف المحتملة لصراع أوسع نطاقًا، في وقت لا تزال فيه القوات السعودية غارقة في أوحال اليمن، فيما كان محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في البلاد، يضغط من أجل البيع العام لشركة النفط السعودية الحكومية، أرامكو. من شأن هذه الهجمات أن تحيط مستقبل الشركة بشكوك جدية وبالقيمة الإجمالية للبقرة المقدّسة، التي تمثل مصدر الدخل الأكبر لخزينة الدولة.
كانت الهجمات بمنزلة المنبّه المزعج لحقيقة غير قابلة للتجاوز وفق حسابات عسكرية، وإن نقل المعركة كما أرادها محمد بن سلمان أصبح في ميدان التحقيق الدولي وليس طهران، وبات على الأمير المتحمّس تخفيض سقف توقعاته من واشنطن وتقديراته لقوته العسكرية، إذ أراد أن يجنّب بلاده عواقب المغامرات غير المحسوبة، كما هي عادته سواء في الحرب مع اليمن، أو الأزمة مع قطر، أو حتى اغتيال الصحافي الحجازي جمال خاشقجي..
في كل الأحوال، فاقت القيادة السعودية على حقائق جمّة وصادمة في اختبارين فارقين لشراكة الولايات المتحدة في معادلة الحماية. فهذا الشريك بدا عاجزًا في عام 2019 عن حماية المنشآت النفطية في بقيق، وأيضًا في حماية الكيان الاسرائيلي من ضربة عسكرية إيرانية بالمسيرات والصواريخ الباليستية في 14 ابريل 2024 في رد على قصف القنصلية الايرانية في دمشق في الاول من ابريل من العام نفسه.
علاوة على ذلك، فإن السعودية التي كانت تأمل في استدماج الكيان الاسرائيلي في نظام أمن إقليمي برعاية أميركية لحظت كيف أن هذا الكيان منذ طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر 2023 بات مكشوفًا، ويواجه أزمة وجودية، وأن الرهان عليه في تحقيق توازن ردع في مواجهة ايران ومحور المقاومة خاسر من دون ريب.
وفي النتائج، تبيّن أن الحسابات السعودية المبنية على تقديرات لقوة الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لم تكن واقعية، وربما هذا ما يدفع بها إلى مراجعة خياراتها، والبحث بصورة جديّة في توسيع مروحة رهاناتها، بما يشمل المساكنة مع خصومها..
وفي مقالة في مجلة (نيوزويك) الأميركية في 4 يونيو 2024 بعنوان (السياسة العاجزة تجاه إسرائيل تدفع حلفاء الولايات المتحدة نحو إيران)، توقف الكاتب عند قبول محمد بن سلمان دعوة الجانب الايراني في 26 مايو الماضي لزيارة طهران التي فكّر ذات يوم في نقل المعركة إليها. هذه الزيارة في حال تمّت ستكون الأولى من نوعها من قبل أحد أفراد العائلة المالكة السعودية منذ أكثر من عقدين.
في ديسمبر 1991، التقى الرئيس الإيراني آنذاك الشيخ هاشمي رفسنجاني وولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في داكار، السنغال. وخلال ثلاث ليال من المفاوضات المكثفة، ناقشا الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية، مما أدى إلى اتفاق أدّى إلى تحسين العلاقات بين البلدين على مدى العقد المقبل. وفي عام 1997، زار ولي العهد الأمير عبد الله طهران، والتقى بالامام علي الخامنئي، مما أدى إلى تعزيز العلاقات. ومع ذلك، فإن الجغرافيا السياسية وتضارب المصالح جعلت العودة إلى الدبلوماسية بين إيران والمملكة السعودية غير مرجحة. وإن فترة الاستراحة التي شهدتها العلاقات السعودية الايرانية خلال عهدي رفسنجاني وخاتمي أسفرت عن معارك بالنيابة في أكثر من ساحة إقليمية (العراق ولبنان وسوريا واليمن). لم تكن الرياض في وارد مراجعة سياستها ولكن التجارب المؤلمة التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة فرضت عليها التأمل مليًا في رهانات سوف تكون كارثية.
زيارة ابن سلمان الى ايران سوف تأتي في أعقاب أول رحلة يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ايران في 22 مايو الماضي وتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، التقى خلالها بالرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر ووزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني والتي تأتي في سياق تقارب مصري ايراني بوتيرة متسارعة. في سياق متقارب، تأتي تصريحات ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله لقناة (العربية) في 26 مايو كشف فيها عن حوار أردني ـ ايراني بعد أقل من اسبوعين عن إعلان الأردن عن إحباط ما أسماها “مؤامرة” ايرانية لدعم معارضي الحكم في الأردن.
في الواقع، تلك “المؤامرة” المزعومة ليست سوى محاولة إيصال السلاح في أوائل شهر مايو الماضي الى داخل فلسطين المحتلة عبر الأراضي الأردنية، ولا صلة لها بدعم المعارضة الأردنية. ولي العهد الأردني قال بأن “هناك حوارًا أردنيًا- إيرانيًا في كافة القضايا”، وأن أولوية بلاده هي “عدم تحويل الأردن لساحة حرب إقليمية”. وأيضًا في السياق نفسه، تأتي تصريحات ملك البحرين حمد بن خليفة في 24 مايو الماضي خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بأنه “لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران”. وأن بلاده “تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع طهران”.
على نحو إجمالي، ثمة أجواء جديدة تشهدها المنطقة، وثمة رغبة لدى حلفاء واشنطن في الانفتاح على ايران، وأن القاسم المشترك فيما بينهم هي أنهم شعروا بأن من غير الممكن التعويل على تحالف محفوف بالشكوك مع الولايات المتحدة في وقت تنساق الأخيرة بصورة عمياء نحو الكيان الاسرائيلي ولكن حتى هذا الانسياق لم يوفر حماية كاملة له حين تعرّض لهجوم واسع من ايران.
إذًا، إن التقارب بين حلفاء واشنطن وايران مدفوع بمخاوف وشكوك، فهؤلاء ليسوا فقط خائفين من ايران، بل ما هو أبعد من ذلك هو عدم الثقة في دعم الولايات المتحدة لهم في حال تعرّضها لتهديدات من الخارج، متخيّلة أو حقيقية. في واقع الأمر، أن هؤلاء الحلفاء لمسوا باليد عزوف الادارة الأميركية عن سابق تصميم عن الدخول في مواجهة مباشرة مع ايران، حتى للدفاع عن أقرب حليف إقليمي لها، إسرائيل.
وفي 27 مايو، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة بايدن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط لتوبيخ إيران على التقدم الذي أحرزته في برنامجها النووي، حتى مع قيامها بتوسيع مخزونها من المواد الانشطارية القريبة من درجة صنع الأسلحة إلى مستوى قياسي، وفقًا لدبلوماسيين شاركوا في المناقشات. ونقلت عن دبلوماسيين إن الولايات المتحدة تعارض الجهود التي تبذلها بريطانيا وفرنسا لإلقاء اللوم على إيران في مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو. وقالوا إن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بحجب الثقة، قائلة إن هذا ما ستفعله واشنطن[1].