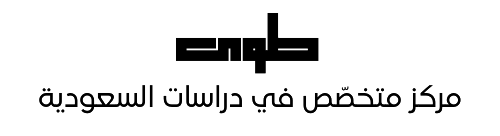بعد محاولات دامت ثلاثة أشهر على أمل فتح الأبواب أمام الضيف السعودي، حلّ الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع والمسؤول عن الملف السياسي في المملكة السعودية ضيفًا على طهران في السابع عشر من أبريل 2025 لإيصال رسالة الى قمة الهرم السياسي في الجمهورية الاسلامية في إيران.
لم تكن زيارة عادية، لا على مستوى التمثيل، ولا لناحية التوقيت أو الموضوعات التي حملها معه خالد بن سلمان في رسالة ممهورة بختم الملك سلمان.
استعجال الزيارة من الجانب السعودي كان واضحًا للجانب الإيراني، فثمة مرحلة جديدة تشهدها المنطقة نتيجة جملة تطوّرات:
ـ تداعيات طوفان الأقصى ونتائج العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان
ـ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، والايحاء للمعسكر الآخر بانفراط عقد محور المقاومة..
ـ وصول ترمب الى البيت الأبيض وبداية عهد جديد من المواجهة متعدّدة الجبهات، وإعادة طرح الملف النووي الايراني وبدء المفاوضات المصحوبة بجولة من العقوبات القصوى على إيران.
فرضت هذه المتغيّرات نفسها على المسرح الاقليمي، وباتت المنطقة أمام استحقاقات فاصلة، بعضها يرتبط بما يعتقده المعسكر الأميركي أرباحًا في اعقاب المواجهة المباشرة بينه وبين محور المقاومة، خصوصًا في غزة ولبنان، والترتيبات المقترحة لمرحلة ما بعد العدوان، والتي بدأت فصولها في لبنان بتعيين رئيس للجمهورية مقرّب من الولايات المتحدة ورئيس حكومة مقرّب من السعودية.
في القراءة الأولية، لم يكن تحرّك رأس الدبلوماسية السعودية مبنيًا على فكرة إعادة تموضع، ولا خروج من حلبة العداء الهيكلي مع ايران بصفتها رمزًا لمحور مناهض لمحور مقابل، وإنما هو، في حقيقته، شعور بنشوة الانتصار الذي يدفع بالرياض إلى التصرّف بصفتها “القطب” الأجدر بتمثيل المعسكر الصهيوأميركي، في غياب أطراف وازنة في المنطقة العربية وكذلك ترهّل النظام الرسمي العربي بحمولته القطرية المتشظية.
تعزّز الانتقال السعودي الى مرحلة الهجوم الدبلوماسي الإيجابي، بالمتغيّر السوري المفاجىء بالسقوط الدراماتيكي لنظام بشار الأسد والاستعجال السعودي نحو احتجاز حصّة للمملكة في سوريا الجديدة، إلى جانب التركي والاسرائيلي. السعودية المتردّدة في بداية سقوط بشار وصعود هيئة تحرير الشام بخلفيتها القاعدية بزعامة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، حسمت أمرها لاحقًا بعد مرحلة استكشاف بدت كما لو أنها تمّت على عجل بعد رسائل الطمأنة التي بعث بها الجولاني الى حكومات الخليج وبتشجيع من الحليف التركي الذي رفع شارة النصر الحمراء في سوريا قبل أن يخفّض من لهجته المثيرة والمقلقة بالنسبة الى أطراف خليجية وعربية تتوجّس خيفة من التطلعات التركية في المنطقة العربية. ومع أن التركي بات هو الحاكم الفعلي في إدارة سورية الجديدة، عبر ممثلين أتراك في كل الدوائر الرسمية، وهو أمر بات معروفًا لدى كل المتابعين والمتدخّلين في الشأن السوري. ارتضى الجانب السعودي القسمة مع التركي بل ومع الاسرائيلي، وقبل أن يكون شريكًا مع آخرين في الكعكة السورية. على أية حال، فإن سورية الجديدة التي يتصارع الآخرون عليها ليست سورية التي عرفها العالم، فالقوى المحلية والاجنبية التي عملت على إسقاط النظام أسقطت سورية معه، ولذلك فإن هذا البلد اليوم في حالة تشظ وموزّع على أطراف عدّة، وإن البحث اليوم لا يدور حول مجرد فكرة السيطرة على سورية القديمة، وإنما على حصة من بين حصص متعدّدة في سورية الجديدة..
وعلى خلاف الأداء السعودي في لبنان الذي يصدر عن خلفية تقوم على التعامل مع المقاومة بأنّها في موقع الخاسر، وإن السعودي الغائب عن لبنان لنحو خمس عشرة سنة يأتي لينوب عن الإسرائيلي في قطف الثمار. في تقديري، إن السعودية لم تستكمل القراءة الدقيقة للديناميات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية في لبنان وموازين القوى الداخلية ما قبل الحرب الاسرائيلية على لبنان وما بعدها، لأن السعودية تنطلق من فكرة أن المقاومة خاسرة وأن المعسكر الآخر هو من يملي الشروط ويفرض المعادلات. في الواقع، ساهمت شخصيات وقوى لبنان في تعزيز هذا الانطباع لدى السعودية ولدى الأميركي أيضًا، فيما بدا أن رؤية سعد الحريري الثابتة والتي عبّر عنها للسعودية قبل احتجازه في الرياض في 2 أكتوبر 2017 كانت صائبة بأنه ليس مستعدًا لأن يتصادم مع حزب الله ولا مع المكوّن الشيعي لأنه يعرّض أمن لبنان الى الخطر ويتسبب في تخريب السلم الأهلي وتصديع أسس الاستقرار الداخلي، فيما كانت السعودية تبحث عن أي طرف لبناني يلبي رغبة المصادمة مع المقاومة والتحريض عليها، وهذه الرغبة رافقت السعودية طيلة السنوات الماضية، وإن العدوان الاسرائيلي على لبنان رفع من سقف توقعاتها وأن الوقت حان لأن يحقق حلفاؤ الرياض في لبنان ما نأى الحريري عنه. كان طلب واشنطن والرياض موحّدًا من الحلفاء وخصوصًا القوات اللبنانية والكتائب واليمين السنّي (أشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، وفؤاد السنيورة، ونواف سلام..) بالدخول في المواجهة مع المقاومة وطرح قضايا مفصلية منها: إبعاد حزب الله عن الحكومة، ونزع سلاح المقاومة، ومحاصرة المقاومة ماليًا، ومنع إعادة الإعمار..وكلها قضايا موضع تداول وسط المعسكر الأميركي السعودي الاسرائيلي.
في المحصلة اللبنانية، عملت الرياض على احتكار المنجز الاسرائيلي بناء على تفويض أميركي. وتصرّفت الرياض ممثلة بمبعوثها الوقح الى لبنان الأمير يزيد بن فرحان الذي بات مبعوثًا اسرائيليًا أكثر منه سعودي، وهذا ما عكسه في زيارته الى لبنان في 16 إبريل 2025 أي قبل يوم من سفر خالد بن سلمان إلى طهران، حيث التقى إبن فرحان عددًا من المسؤولين اللبنانيين ونقل لهم رسالة اسرائيلية بضرورة تقويض الوجود الايراني في لبنان لاسيما في مجال دعم المقاومة في الاطار العسكري والمالي، ونقل المبعوث السعودي الى المسؤولين اللبنانيين ما وصفت بمعلومات تؤكد أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ينوي إعادة تفجير الجبهة مع لبنان، بناء على تصوّر خاص حول مستقبل لبنان وسوريا، وعليه لا بد من نزع الذريعة وهي “سلاح المقاومة” في جميع المناطق اللبنانية وليس في جنوب لبنان وبقاعه فحسب.
من الواضح، أن السعودي لا يخجل بأن يضطلع بمهمة “صندوق البريد” الاسرائيلي الى اللبنانيين، وأن يتحدث عن “معلومات” وكأن التطبيع بين الرياض وتل أبيب بات أمرًا واقعًا وغير قابل للنقاش.
في السياق ذاته، يأتي التفويض الأميركي للسعودية برعاية المفاوضات الروسية الاوكرانية وما تلاها من مفاوضات حول الشأن السوداني والسوري وجدول الاعمال المطلوبة من الادارة الجديدة وكذلك المصالحة السورية اللبنانية، في سياق “تعويم” إبن سلمان إقليميًا ودوليًا فيما يشبه إعادة تأهيل مكثّفة لتحويل الرياض إلى مركز مصالحات إقليمية ودولية.
في الشأن الإيراني يتصدّر:
ـ الملف النووي.
ـ الملفات الإقليمية.
في تجربة المفاوضات النووية في عهد الرئيس باراك أوباما في سلطنة عمان في الفترة ما بين 2013 ـ 2015، شعرت السعودية بالخداع لأن من تفترض أنه شريك استراتيجي، أي الولايات المتحدة، أبقى سر المفاوضات بعيدًا عن عيون وآذان أقرب الحلفاء إليه، من أجل ضمان نجاح المفاوضات، وحين جرى توقيع الاتفاق النووي كان في طليعة الغاضين هم السعوديون والاسرائيليون.
وحتى بعد إلغاء الاتفاق النووي من جانب دونالد ترامب سنة 2017، كلما جرى تداول فكرة مفاوضات نووية جديدة بين ايران والولايات المتحدة كانت السعودية ومعها الامارات والبحرين تطالب بالمشاركة في المفاوضات أو أن تكون حاضرة فيها، كرسالة طمأنة من الشريك الأميركي، وحتى لا يقع الحلفاء الاقليميون تحت وطأة خداع جديد بناء على أنهم أدرى بشؤونهم وأن التفاوض عليها يكون بينهم وبين الجانب الايراني.
بعد وصول ترمب الى البيت الأبيض في 20 يناير 2025 أعيد طرح فكرة المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وايران، وأبدى الطرفان استعدادًا للدخول في مفاوضات تفضي إلى اتفاق نووي جديد. كان الجانب الايراني متوجسّا، وحقّ له ذلك، من انقلاب ترمب على الاتفاق وهو الذي مزّق اتفاق سابق في بداية ولايته الأولى في 20 يناير سنة 2017، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري النقاش في الهواء الطلق وعلى مرمى ومسمع حلفاء الطرفين الاميركي والايراني في المجالين الاقليمي والدولي، وتكاد تكون الموضوعات معروفة سلفًا، والمدى الزمني الذي سوف تستغرقه كل جولة والاهداف المرسومة.
ثمة عنصر جديد طرأ على المشهد التفاوضي الأميركي الايراني، وهو التطلع السعودي المحمول على أولًا: استضافة مفاوضات (ومصالحات) إقليمية ودولية، وثانيًا: تهميش الدور العماني، حيث تبيّت السعودية انتقامًا قديمًا لحجب عمان خبر المفاوضات الاميركية الايرانية السابقة عنها، وأيضًا التموضع السياسي العماني غير المريح بالنسبة إلى السعودية، سواء فيما يخص الملف اليمني (وتعمل السعودية على قطع التواصل الجغرافي بين السلطنة واليمن. وهناك عمل جدّي لإضعاف عمان اقتصاديًا، بهدف إرغامها على القبول بالدور المحوري للسعودية في النظام الاقليمي.
لناحية الملفات الإقليمية، لطالما كانت السعودية تعمل على تفويض أميركي يمكّنها من التفاوض مع الأطراف المنافسة على قاعدة أنها تملك كلمة الفصل والحسم في القضايا الخلافية. على سبيل المثال، كانت زيارة الامير بندر بن سلمان، مستشار مجلس الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العامة سابقًا، الى موسكو في أغسطس 2013 حيث قدّم نفسه بصفته ممثلًا عن المعسكر الغربي برمته وليس موفدًا سعوديًا فحسب، كما ظهر أيضًا من العرض الذي قدّمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل التخلي عن بشار الأسد وايران.
وماذا عن زيارة خالد بن سلمان إلى طهران؟
الضيف السعودي لم يأت في السياق الدبلوماسي الكلاسيكي في العلاقات الثنائية بين البلدين، بل إن التمثيل عالي المستوى، أي الرجل الثالث في النظام السعودي في الوقت الراهن، كان على قدر أهمية القضية التي حملها معه الى طهران.
في الشكل، جاءت الزيارة في سياق متغيّرات إقليمية ودولية يعتقد السعودي، ومن خلفه الأميركي والاسرائيلي، بأنها مواتية لترجيح كفته التفاوضية، ويمكن تسييلها في هيئة إملاءات أو عروض تكون فيها السعودية في موقع الرابح. يأتي في مقدمة اهتمامات الرياض في الوقت الحالي استضافة حفل التتويج في المفاوضات النووية الأميركية الايرانية، وأن تكون “الرياض” وليس “مسقط” المكان الذي يجري فيه توقيع الاتفاق النووي، مقابل تسهيلات لايران في ملفات أخرى سواء في لبنان أو سورية. وبحسب تعليق دبلوماسي عربي: “يبدو أن السعودية استعذبت طعم “الوساطة” في ملفات إقليمية ودولية، وتتطلع لأن تنال حظوة دولية بعد أن عانت من عزلة طويلة نسبيًا” على خلفية تورّط محمد بن سلمان في جريمة العصر، باغتياله الصحافي الحجازي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله وحرقها في فرن صنّع مخصصًا لهذه المهمة داخل القنصلية السعودية في استانبول في نوفمبر 2018.
في هذا الصدد على نحو التحديد، أي لناحية إقامة مراسيم توقيع الاتفاق النووي بين امريكا وايران في الرياض، وهو لا ريب مكسب كبير تتطلع الأخيرة الى الحصول عليه، وإن قبول ايران بمنح السعودية “مكافأة” بهذا الحجم لا بد أن يكون المقابل كبيرًا أيضًا ومغريًا. إما إذا كانت الدبلوماسية السعودية بنيت على أساس انتصار وهزيمة، وإنها في موقع من يملي الشروط فإن أقل ما يقال هو
أن الدبلوماسي السعودي لم يتعلم الدرس من تجارب الفشل السابقة، وإن الإصرار على تكرار التجربة ذاتها على أمل الحصول على نتائج مختلفة يؤكد أن التعلّم يتطلب مراجعة جدّية وتواضعًا. لا ريب أن خالد بن سلمان عاد بحصيلة غير التي توقّعها، وإن حلم “الراعي الدولي” دونه أثمان كبيرة. لا ريب أن الجانب الايراني يسعى الى علاقات وطيدة ومستقرة ومتينة مع السعودية، ويتطلع إلى تطويرها لتشمل المجالات التجارية والاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية، وفي الوقت نفسه لن تفرّط في حلفاء بادلوها الثقة بالثقة، مثل سلطنة عمان التي سوف تبقى ايران وفيّة لها لرعايتها لمفاوضات سابقة توجّت بتوقيع اتفاق ناجح سنة 2015، وكذلك في مناسبات أخرى بما في ذلك ملف اليمن الذي كان لسلطنة عمان شرف الرعاية والوساطة والاحتضان إلى جانب العلاقات المتميزة بين البلدين ومستويات التعاون والتنسيق في مجالات متعدّدة إقتصادية وسياسية وأمنية.
تقديم السعودية عرض الوساطة بين طهران وواشنطن ليس معزولًا، ولا مفصولًا عن تطوّرات أخرى تشهدها المنطقة ولا استحقاقات يتوقع حصولها في الأسابيع والشهور القليلة المقبلة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والمتغيّرين السوري واللبناني، وزيارة ترمب الى الرياض، والموضوعات الحسّاسة المدرجة على جدول أعمال الضيف الأميركي ثقيل الظل.
اصطحب خالد بن سلمان الى طهران سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر، في رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها أن الرياض على استعداد لمناقشة الملف اليمني، ولكن الايراني تعمّد عدم التطرّق لأي موضوع خارج الاهتمام المشترك والثنائي. ولذلك جرى التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ربطًا بالهدف الأساس للزيارة، وهي لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن في الملف النووي. من جهة أخرى، السعودية التي كانت لديها حساسية من أي طرح لملفات إقليمية على طاولة المفاوضات الاميركية الايرانية ترغب في سحب الملفات الاقليمية من الجانب الاميركي وأن تكون الرياض وليس واشنطن من يدير هذه الملفات مع طهران، بطبيعة الحال لن يكون ذلك ممكنًا من دون الموافقة الاميركية. ويبدو أن إدارة ترمب ليست لديها مشكلة في منح السعودية هذا الامتياز، على أن يتم تنسيق المواقف مع الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو، ولا غرابة في اضطلاع المسؤولين السعوديين بمهمة نقل الرسائل الاسرائيلية الى بيروت وطهران وبغداد. بكلمات أخرى، السعودية أدخلت ملفات إقليمية ولا سيما سوريا ولبنان في “العرض”، المقدّم إلى ايران للقبول بها راعيًا للاتفاق النووي الاميركي الايراني. ولكن، لا يقف الأمر عند هذا الحد، وحتى إن قبلت طهران بمنطق المقايضة: (اعطونا هنا نعطيكم هناك)، فإن الجانب السعودي يتأهب لما هو أبعد من ذلك وأخطر، وهوالصفقة الكبرى، أي التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، الذي جرى تعطيل مساره في السابع من أكتوبر سنة 2023، أي على إثر واقعة طوفان الأقصى، بعد أن كاد يبلغ خواتيمه النهائية في سبتمبر من العام نفسه، عقب سلسلة لقاءات وترتيبات قام بها السعودي والاسرائيلي والاميركي.
وإذا كان الايرانيون قد أكّدوا على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ايران والسعودية، فإنهم لن يذهبوا الى حد التفريط في الوساطة العمانية “المحايدة” على خلاف السعودية التي لن تكون طرفًا محايدًا في أي مفاوضات أميركية ايرانية، وهذا ما تدركه طهران تمامًا.
على أية حال، فإن التفاوض مع ايران يقوم على أساس احتكار الجانب الاميركي للملف النووي على أن يتولى الجانب السعودي مهمة التفاوض في الملفات الإقليمية، في عملية تقاسم أدوار منضبطة بين واشنطن والرياض، على أن يكون التتويج بتوقيع الاتفاق النووي في الرياض الذي يراد له أن يمهّد لمرحلة جديدة يعاد فيها انتاج الدور الاقليمي للسعودية ويجعلها الدولة الوظيفية الأولى للولايات المتحدة في المجال العربي والاسلامي.