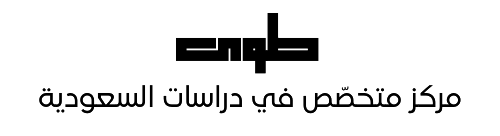خضعت السعودية لاختبارات الولاء للإدارة الأميركية الجديدة منذ ظهور مؤشرات على فوز دونالد ترمب بولاية ثانية والعودة إلى البيت الأبيض بحماسة أكبر وبصرامة أشد. فمن بين الاختبارات، كام مصير عضوية السعودية في مجموعة بريكس التي قررت الانضمام اليها قبل أكثر من عام، ولكن في القمة الموسعة للمجموعة التي احتضنتها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، في أكتوبر 2024، غاب عنها ولي العهد محمد بن سلمان، فكانت السعودية البلد العضو الجديد الوحيد في بريكس الذي لم يحضر ممثله في القمه، فيما حضرت الامارات ومصر وهما حليفان للسعودية وللولايات المتحدة.
انسحاب المملكة السعودية من مجموعة البريكس يشي بإعادة ضبط سياستها الخارجية، بدافع الرغبة في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وضمان الدعم المستمر من الإدارة الجديدة في البيت الأبيض. في حين أن مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) قد تقدم منصة لتنويع السعودية شركائها والانخراط مع القوى غير الغربية، ولكن تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني والشريك التجاري الأساسي للمملكة في منطقة غرب آسيا.
يبدو أن التحول الاستراتيجي للمملكة السعودية نحو تعاون أوثق مع الولايات المتحدة في عهد ترامب هو استجابة لعدم اليقين المتصوّر بشأن المنظمات المتعدّدة الأطراف والاعتراف بالدور الحاسم للولايات المتحدة في مستقبلها الأمني والاقتصادي. إن النهج الأكثر أحادية الجانب والمعاملاتية لترامب في السياسة الخارجية، بدلاً من التركيز على المؤسسات الدولية، قد يتردد صداه لدى القيادة السعودية، التي تقدّر، في الشكل على الأقل، العلاقات الثنائية القوية على المشاركات المتعددة الأطراف.
ومع نهاية سنة 2024، كشفت المعلومات عن تعليق السعودية لعملية الانضمام الى المجموعة بحجة “عدم إكمال الإجراءت الداخلية اللازمة”، بحسب معاون الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف. واللافت أن إعلان السعودية تعليق عضويتها جاء بعد أسابيع من تلويح ترمب بفرض رسوم جمركية تصل الى 100% ضد دول المجموعة في حال قرّرت إطلاق عملة بديلة للدولار. السعودية التي تربطها بالولايات المتحدة شراكات تجارية ضخمة تتطلع للحصول على معاملة استثنائية مثل المعاهدة الدفاعية والحصول على التكنولوجيا المتطوّرة المدنية والعسكرية وتخطط للاستثمار في مشاريع التقنية العالية والتسلية وصناعة السيارات والمعدات الثقيلة وهي مزايا تفوق من وجهة نظرها العضوية في بريكس. ولكن هذه المكاسب ليست بلا ثمن، وكان من تباشيره طلب ترمب من السعودية شراء سلع بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، فقابله محمد بن سلمان بعرض أسخى بقيمة 600 مليار دولار، فرفع ترمب المبلغ إلى تريليون دولار. وهذا المزاد العلني والسريع ينبىء عن نوع العلاقة التي يراد تشكيلها في ولاية ترامب الثانية، أي علاقة قائمة على المعاملاتية أو فن الصفقة.
في الإطار العام، يمكن وصف آفاق العلاقات السعودية الأمريكية خلال ولاية ترامب الثانية المحتملة بالتركيز المستمر على الطاقة والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب التعاون الجيوسياسي في الشرق الأوسط. هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تشكل هذه العلاقة، وخاصة في ضوء انسحاب المملكة السعودية من البريكس وعرض ولي العهد السعودي باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. في حين أنه من المستحيل التنبؤ بالحوادث المستقبلية على وجه اليقين، فهناك بعض الديناميكيات الواضحة التي من شأنها أن تؤثر على العلاقة خلال ولاية ترامب الثانية.
- التعاون في مجال الطاقة والاستثمار الاقتصادي:
كانت الطاقة دائمًا أحد “الركائز الأساسية” للعلاقات السعودية الأمريكية. فقد حافظت المملكة السعودية، بوصفها واحدة من أكبر “منتجي النفط” في العالم، على علاقات قوية مع الولايات المتحدة من خلال “قطاع الطاقة”. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، أصبحت “الولايات المتحدة مصدرًا صافيًا للطاقة” (في المقام الأول من خلال النفط والغاز الصخري)، مما قلل من الاعتماد الأمريكي على النفط الأجنبي ولكنه لم يقلل من الأهمية الإجمالية للنفط السعودي للسوق العالمية.
إن عرض الاستثمار الذي قدمه ولي العهد بقيمة 600 مليار دولار يشير إلى رغبة المملكة السعودية في تعميق “العلاقات الاقتصادية” مع الولايات المتحدة والحفاظ على توافقها الاستراتيجي مع واشنطن. وقد تشمل هذه الاستثمارات حصصًا كبيرة في الصناعات الأمريكية مثل “التكنولوجيا والدفاع والطاقة والبنية التحتية”، والتي تتوافق مع مبادرة “رؤية 2030” للمملكة السعودية (التي تهدف إلى تنويع اقتصادها) والهدف الأمريكي المتمثل في تعزيز المزيد من رأس المال الأجنبي في اقتصادها.
من المرجح أن يكون موقف ترامب المؤيّد للأعمال التجارية وسياساته الاقتصادية “أمريكا أولاً” مواتية لهذه العروض الاستثمارية، حيث دافع باستمرار عن فكرة جلب الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة والحفاظ على علاقات قوية مع الدول الغنية بالطاقة مثل المملكة السعودية.
- التعاون الدفاعي والعسكري:
كان الجانب الرئيسي الآخر من العلاقات السعودية الأمريكية في عهد ترامب هو “العلاقة الدفاعية”، حيث تعد المملكة السعودية واحدة من “أكبر المشترين للمعدات العسكرية الأمريكية”. سعت إدارة ترامب إلى مبيعات الأسلحة والشراكات العسكرية مع السعوديين، مستشهدة بالفوائد الاقتصادية للشركات الأمريكية وتعزيز الاستقرار في غرب آسيا من خلال تعزيز القدرات العسكرية السعودية.
من المرجح أن تستمر هذه الصفقات الدفاعية، حيث ستحتاج المملكة السعودية إلى “دعم عسكري” مستمر لمواجهة الأخطار الناجمة عن التحولات التي شهدتها المنطقة، لا سيما بعد سقوط النظام السوري وصعود منظمات السلفية المسلحة التي تشكّل قلقًا لدى السعودية ودول خليجية وعربية أخرى، إلى جانب بطبيعة الحال مواجهة النفوذ التركي والنفوذ الإيراني في المنطقة وحماية حدودها والحفاظ على أمنها. إن موقف ترامب من إيران – والذي كان موقف مواجهة ومؤيدًا لأقصى قدر من الضغط – يتماشى مع مصالح السعودية في احتواء القوة والنفوذ الإيرانيين. ومن شأن هذا الهدف المشترك أن يعزز علاقاتهما الدفاعية.
- التوافق الجيوسياسي في غرب آسيا :
تشترك المملكة السعودية والولايات المتحدة في مصلحة مشتركة في “مواجهة إيران” في منطقة غرب آسيا، ومن المرجح أن يستمر هذا في أن يكون سمة مميزة لعلاقتهما في ولاية ترامب الثانية مع إضافة الخطر التركي الجديد بعد سقوط النظام السوري وتعاظم النفوذ التركي في سوريا وبلاد الشام عامة. من المرجح أن يستمر الدعم السعودي للمبادرات الأمريكية في المنطقة في ولاية ترامب الثانية، خاصة إذا ظل ما تعتقده تهديدًا نوويًا إيرانيًا على رأس جدول الأعمال إضافة إلى ما يمكن أن يشكّله الدور التركي في المنطقة من تحدّيات لمصالح السعودية وحلفائها في المنطقة. وعليه، من المرجح أن تستمر المملكة السعودية في العمل مع الولايات المتحدة في ملفات “الأمن الإقليمي” من خلال التحالفات مع الكيان الاسرائيلي سعيًا لاحتواء النفوذ الإيراني والتركي في دول مثل سوريا والعراق ولبنان.
- التعاون الإقليمي مع إسرائيل:
كان نهج ترامب تجاه الكيان الاسرائيلي إيجابيًا للغاية، كما يتضح من “اتفاقيات إبراهيم”، التي أدّت إلى اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والعديد من “الدول العربية”، بما في ذلك الإمارات والبحرين، وكذلك اعترافها بالقدس عاصمة أبدية للكيان الاسرائيلي والجولان السوري المحتل كجزء من الكيان.. وفي حين لم تقم المملكة السعودية بعد بتطبيع العلاقات بشكل كامل مع “إسرائيل”، فقد كانت الرياض “تتقبل بهدوء فكرة” إقامة علاقات أوثق، خاصة في مواجهة التهديدات المشتركة من إيران.
في فترة ولايته الثانية، سوف يواصل ترامب الدفع نحو “التعاون السعودي الإسرائيلي”، والذي من شأنه أن يتماشى مع المصالح السعودية في مواجهة “إيران” وتوفير أجواء مواتية تسمح بإعلان التطبيع بعد أن هدأت أصوات الصواريخ العدوانية على قطاع غزة، وكان ذلك شرط ابن سلمان من أجل الدخول في صفقة التطبيع. ومع ذلك، تظل “القضية الفلسطينية” عقبة كبيرة في أي تطبيع رسمي، مع رفض نتنياهو وفريقه الليكودي الحاكم خيار حل الدولتين، ولذلك قد تستمر المملكة السعودية في التعامل مع الكيان الاسرائيلي خلف الكواليس بدلاً من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية. وقد سبقت السعودية لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن في 3 شباط/فبراير 2025 والذي من المقرر أن يناقش قضية الفلسطينيين ومستقبل الصراع مع العرب، بإصدارها موقف مشترك مع دول عربية أخرى اجتمعت في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية في الأول من فبراير شملت مصر والاردن والامارات وقطر وأومين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبّروا عن “التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي ‘دونالد ترامب’ لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات”.
- حقوق الإنسان والصورة الدولية:
كان التحدي الرئيسي للعلاقات السعودية الأمريكية، وخاصة في ظل إدارة بايدن، هو المخاوف بشأن “حقوق الإنسان”، وخاصة فيما يتعلق بـ “الحرب في اليمن”، و”مقتل جمال خاشقجي”، والانتقادات العامة بشأن “السياسات الداخلية للمملكة السعودية”. وفي حين كان ترامب أكثر تسامحًا مع “الأفعال السعودية”، وخاصة كجزء من “استراتيجيته الأوسع في غرب آسيا”، فمن غير المرجح أن تختفي هذه المخاوف تمامًا في ولايته الثانية.
قد يكون دعم ترامب للمملكة السعودية أكثر “صفقوية” من كونه قائمًا على القيم المشتركة، حيث ركزت إدارته في المقام الأول على التعاون الاستراتيجي والاقتصادي. ومع ذلك، فإن أي “انتقادات دولية” أو “فضائح حقوق الإنسان” قد تفرض ضغوطًا على العلاقات الأمريكية السعودية، وخاصة إذا ازدادت الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة (على سبيل المثال، من الكونجرس أو الرأي العام).
موازنة المنافسة الإقليمية: دور السعودية في أوبك وأسواق الطاقة.
بالإضافة إلى العلاقات العسكرية والاقتصادية، ستظل “سياسة النفط” و”تسعير الطاقة” جزءًا رئيسيًا من العلاقات السعودية الأمريكية. وفي حين جعل إنتاج النفط الصخري الأمريكي الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على النفط السعودي، فإن دور السعودية في “أوبك” وقدرتها على التأثير على “أسعار النفط العالمية” لا يزال أمرًا بالغ الأهمية. وقد لحظنا أهمية ذلك من خلال دعوة ترمب السعودية بتخفيض سعر البترول كأحد الأوراق التي تضغط بها من أجل إيقاف الحرب في أوكرانيا، مع أن التخفيض ينطوي على إضرار كبير بالاقتصادين السعودي والروسي معًا لاعتمادهما على مبيعات النفط لتمويل الموازنة والمشاريع الاستثمارية المتعثرة.
ومع ذلك، من المرجّح أن تدفع سياسات الطاقة التي يتبناها ترامب والتي تحمل شعار أميركا أولًا إلى التعاون السعودي في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية بما يخدم المصالح الاقتصادية الأميركية. وفي الوقت نفسه، فإن أي تلاعب بأسعار النفط أو خفض الإنتاج من جانب المملكة السعودية قد يحرّك قضية التدقيق من جانب المشرّعين الأميركيين، وخاصة إذا أدّى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين. ومن المرجح أن تستمر هذه الديناميكية في تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتهما الاقتصادية واعتباراتهما الجيوسياسية.
- فرص تعزيز العلاقات الثنائية:
يمكن استخدام تعهّد ولي العهد السعودي باستثمار 600 مليار دولارفي الاقتصاد الأميركي كأداة لتعميق العلاقات الاقتصادية. وسوف ترحب إدارة ترامب، التي تركّز على تطوير البنية التحتية، بهذا الأمر، وربما تنظر إليه بكونه دفعة لأجندته المحلية. قد يؤدي هذا الاستثمار إلى خلق المزيد من “الشراكات التجارية السعودية الأمريكية” في “التكنولوجيا والطاقة” وغيرها من القطاعات، بما يعزز الجانب الاقتصادي لعلاقتهما.
ـ التكنولوجيا والابتكار: تسعى السعودية، بموجب “رؤية 2030″، إلى تحديث اقتصادها و”تنويعه” بعيدًا عن النفط. وكان إبن سلمان قد تعهّد في مقابلة تلفزيونية في 2018 بالتخلي تمامًا عن النفط في عام 2020، ولكن حقيقة الأمر أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على النفط في توفير نصف العائدات المالية. ومع ذلك، يمكن أن يلعب التعاون مع الولايات المتحدة في “الابتكار التكنولوجي” – وخاصة في مجالات مثل “الذكاء الاصطناعي”، و”الأمن السيبراني”، و”تقنيات الطاقة المتجددة” – دورًا مهمًا في العلاقات السعودية الأمريكية في المستقبل.
خلاصة الأمر، أن السعودية في عهد ابن سلمان وفي ولاية ترمب الثانية تميل إلى مزيد من التماهي مع الولايات المتحدة، وسوف تكون أكثر طاعة وأقل تمرّدًا. ومن المرجح أن تتميّز آفاق العلاقات السعودية الأمريكية خلال ولاية ترامب الثانية بالانضباط من الجانب السعودي وفق الاجندة الأميركية، مع استمرار التعاون في في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد، خاصة مع بقاء “الاستثمار السعودي في البنية التحتية الأمريكية” و”الروابط العسكرية” قوية. ومع ذلك، فإن قضايا مثل “حقوق الإنسان”، و”المنافسة الجيوسياسية” في غرب آسيا (وخاصة مع إيران وتركيا ولا عبين آخرين في المنطقة)، والقضية الفلسطينية قد تستمر في توفير نقاط توتر.
في حين من المرجح أن يتزايد اعتماد السعودية على “الشراكة الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة لتأمين استقرار سلطتها في وقت تبدو على موعد مع انتقال سياسي في أي لحظة مع تدهور الحال الصحية للملك سلمان، وكذلك لضمان دورها في الملفات الإقليمية، وتحقيق مبدأ التنويع الاقتصادي الذي لا يزال غير مضمون النتائج، فإنها ستظل أيضًا مدركة لدورها في المشهد الجيوسياسي الأوسع وقد تستمر في موازنة علاقاتها مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا بطرق تتماشى مع مصالحها الوطنية. في نهاية المطاف، في ظل ولاية ترامب الثانية، من المرجح أن تكون العلاقة “معاملاتية”، تركز على “المكاسب الاقتصادية” المتبادلة والاستقرار الإقليمي، مع وضع المصالح الاستراتيجية طويلة الأجل للمملكة السعودية في الحسبان.